(المفسِّر) هو خصوص الرسول وأوصياؤه، وكذا (المؤول) وليس كل شخص مهما بلغ من العلم، نعم يبقى أن ما أبقاه المعصومون سلام الله عليهم على ظاهره، فإنه حجة، ولذا نقول بحجية ظواهر الكتاب، لكن بعد الرجوع إلى أحاديث الرسول والأئمة فإن وجدنا مخصصاً أو مقيداً أو قرينة...
إن (الوحي الإلهي) و(القرآن الكريم) و(نصوص الرسل والأوصياء) تختلف اختلافاً جذرياً عن سائر النصوص، فلا يمكن أن تتسرب إليها (النسبية) أبداً.
أ: للقرآن ظاهر وباطن
فإن للقرآن (ظاهراً) و(باطناً)، ولباطنه باطن إلى سبعين بطناً ـ والسبعين كناية عن الكثرة، وليست حداً ـ، وبذلك فهو قادر على الاحاطة وعلى كشف الظواهر والبواطن و(الأشياء في حد نفسها) وبذلك يتطابق عالم الإثبات وعالم الثبوت ظاهراً وباطناً، ولعل ذلك مما يُفسَّر به (الباطن)، وأما الأحاديث الشريفة، فقد اقتفت أثر القرآن الكريم في ذلك (فإن لكلامنا حقيقة وعليه نوراً)(1).
ب: قوانين إلهية تحكم الظاهر والباطن
إن الله تعالى وضع سلسلة من (القوانين) التي تحكم ظاهر القرآن، والذي يحيد عنها يكون ممن (مَن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)، كما وضع جل اسمه سلسة قوانين أخرى تحكم (باطنه)، ثم إن من خرج عليها يكون من الذين (يحرفون الكلم عن مواضعه)(2) و: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) (3).
وتسمى الأولى بضوابط التفسير، ويعد تفسيرا: (مجمع البيان)(4) و: (الصافي)(5) من كتب التفسير، كما كان ابن عباس من (علماء التفسير).
وتسمى الثانية بضوابط التأويل، ويعد (البرهان في تفسير القرآن)(6) من كتب التأويل، وكان ميثم التمار من (علماء التأويل).
إذن فلا مجال للفهم الفوضوي غير المنضبط للقرآن الكريم، ثم إن هذه القوانين هي التي تضمن (الإصابة) للواقع، مائة بالمائة، كما أن معرفتها تنتج المعرفة القطعية اليقينية لا الظنية فحسب.(7)
ج: المرجعية محددة
إن (المرجعية) في اكتشاف كلتا المجموعتين من الضوابط هي للقرآن الكريم نفسه، وللرسول وأهل بيته عليهم صلوات الله.
قال تعالى: (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(8)، (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(9).
كما أن (العرف) الذي لم يردع عنه الشارع أو لم يغيره، أي الذي أمضاه، هو المرجع في (التفسير) فقط، أيضاً؛ لقوله تعالى: (بلسان قومه)(10)، وبذلك يكون (النص)، كاشفاً عن مرادات الشارع.
كما أن بذلك يتضح وجود (منهج) علمي محدد للوصول إلى حقيقة النصوص، ومن تلك المرجعيات: بعض (المعايير الموضوعية) التي جعلها الله تعالى في كتابه الكريم، لتمييز الحق من الباطل، ومنها: (المحكمات من آياته) قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ)(11)، كما أن منها: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(12)، و: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(13)، و: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ).(14)
د: الاندماج الشامل بين القرآن وحَمَلَته
إن القرآن الكريم لعله الكتاب الوحيد الذي شاءت الإرادة الربانية أن يتداخل بشكل جوهري وعضوي مع (حَمَلَتِهِ) أي مع (الذين نزل القرآن في بيوتهم)، ولذلك كان من غير الكافي بل من غير الصحيح فهم القرآن بالقرآن فقط، وبمعزل عن الأحاديث والروايات الشريفة، بل إن هذا الفهم سيكون ناقصاً أو مشوّهاً أو مغلوطاً ويدل عليه قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(15).
ومما يقرب هذا المعنى (أي التداخل الجوهري العضوي بين القرآن الكريم وأهل البيت الأطهار سلام الله عليهم) إلى الذهن، المثال التالي: فإن المتكلم لو اعتمد في تفهيم مقاصده على مجموع الكلمات والإشارات معاً، فإنه لا يصح الاكتفاء بكلماته للوصول إلى مقاصده، وذلك كما لو قال (إذهب إلى المنزل) وأشار بيده إلى منزل معين، وكانت له منازل عديدة؛ فإنه لا يصح قطع النظر عن إشارته والإكتفاء بجملة (إذهب إلى المنزل) والاستناد بعدها إلى القواعد في "أل" وأن المراد بها الجنس مثلاً، فيكفي الذهاب إلى أي منزل كان!
وكذا لو اعتمد على الكلمات بقرائنها الحالية الأخرى، ففي المثال قد تكون "أل" للعهد الذهني، أو العهد الحضوري، فيختلف "المراد من المنزل" نتيجة لذلك، وذلك هو العلم الذي لم يؤته إلا الرسول وأهل بيته سلام الله عليهم، وهذا هو ما يدل عليه حديث (الثقلين) بوضوح حيث حصر الرسول صلى الله عليه وآله عدم ضلال الأمة بالتمسك بكلا الثقلين.
ومن الأمثلة القرآنية، قوله تعالى: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)(16)، فإن (الَّذِينَ آمَنُوا) يحدده الرسول صلى الله عليه وآله، وشأن النزول، في متواتر الروايات، حيث أنه الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وبذلك يظهر بوضوح أن الجمود على ظاهر اللفظ في الآية الشريفة وأن الولاية هي لكل من تحلى بتلك الصفات، لهو من أكبر الأخطاء، بل هو افتراء على الله ورسوله؛ إذ كيف التعميم والرسول صلى الله عليه وآله يصرح بأنها نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليهما، في متواتر الروايات، ومقبولها لدى السنة والشيعة وقد قال تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه)(17) وقال سبحانه: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (18)؟
وهذا الترابط والتداخل، على كلا مستويي الفهم والتطبيق معاً.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي) في نصوص صريحة ثابتة عن الشيعة والسنة.(19)
وقال تعالى: (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(20)، وقال جل اسمه: (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(21) وقال سبحانه: (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ).(22)
والناتج من ذلك: أن فهم القرآن الكريم من دون الرجوع إلى تفسير الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار وتأويلهم، هو فهم ناقص بل هو فهم باطل، كما أنه لا يوصل لمقاصد القرآن أبداً، فهو كمن يريد أن يحلق بجناح واحد، فإن مصيره السقوط والتحطم، أو هو كمن يريد أن يفهم الجمل ـ كـ(لا إله إلا الله) بأنصافها حيث يفيد (لا إله) معنى مناقضاً، إذا لوحظ وحده.
وبذلك يظهر أن هذه النظرية ـ وهي نظرية الاخباريين ومعتدلي الأصوليين ـ تقترب منها في بعض أبعادها بعض المدارس الهِرمينوطيقية، مثل مدرسة (دلثاي 1883 ـ 1911) و(هيرش) بل ومدرسة (شلاير ماخر 1768 ـ 1834) وغيرهما والتي تؤكد على أهمية أو محورية قصد المؤلف ـ وقد أشرنا لها في موطن آخر، ولكن مع فوارق:
منها: إن (المفسِّر) هو خصوص الرسول وأوصياؤه، وكذا (المؤول) وليس كل شخص مهما بلغ من العلم، نعم يبقى أن ما أبقاه المعصومون سلام الله عليهم على ظاهره، فإنه حجة، ولذا نقول بحجية ظواهر الكتاب، لكن بعد الرجوع إلى أحاديث الرسول والأئمة سلام الله عليهم فإن وجدنا مخصصاً أو مقيداً أو قرينة في كلامهم على إرادة خلاف الظاهر، فهو، وإلا صحّ الأخذ بالظواهر القرآنية، وهي حجة دون أن تؤثر فيها بما هي هي، القبليات الفكرية والخلفيات النفسية للمفسر لو فتح صدره للقرآن، وحاول التزود منه كتلميذ متعلم، دون ما إذا كان ممن: (يحرفون الكلم عن مواضعه)(23).
ومن الفوارق: إن الله تعالى هو الذي ألهم الرسول صلى الله عليه وآله ومنحه علم مراداته من وحيه ثم منح الرسول ذلك لأوصيائه، ولذا فإن ذلك مما لا تشوبه أدنى شائبة شبهة أو شك أو خطأ أو زيغ، عكس المحقق الذي يحاول أن يكتشف (قصد المؤلف) وما بين السطور، من دراسة خلفياته النفسية ومسبقاته الفكرية.
ومن الفوارق: أن تلك المدارس ترى تعميم نظريتها إلى كل (نص)، والمدرسة الإسلامية المعتدلة ترى صحة ذلك في خصوص القرآن الكريم، وأما غيره ففيه تفصيل يظهر من مطاوي الكتاب.
ومن الفوارق: أنهم يرون ضرورة التعرف على قصد المؤلف عن طريق دراسة نفسيته مثلاً، وهذا محال في الله تعالى، بل الممكن هو التعرف على مراداته عن طريق الاستيضاح من حملة كتابه.
هـ: كيف يختزن القرآن المعرفة المطلقة؟
إن القرآن الكريم يختزن (المعرفة المطلقة)، بمعنى الشاملة العامة والتامة الكاملة، لظواهر الأشياء وبواطنها ولـ(الشيء كما هو في نفسه) وهي قطعية أكيدة لا ظنية محتملة، فلا مجال للنسبية فيه بوجهٍ من الوجوه(24)، وفيه علم كل شيء في نصوصه وعباراته ـ بظهرها وبطنها ـ.
وللتقريب للذهن نقول: كما أمكن لـ(28) حرفاً أن تتكون منها كلمات ثم جمل ثم صفحات وكتب، لا محدودة، وأمكن أن تحتضن ملايين الكتب في شتى العلوم، كذلك يمكن لكيفية (هندسة) موقع بعض هذه الكلمات بالنسبة لسائر الكلمات، ثم لسائر الجمل ثم للكتاب كله، أن تحتضن الأكثر من ذلك بما لا يتناهى؛ وذلك لأن تلك هي 28 حرفاً وأما هذه فإن (أنواع) ترتيب ونسبة وتركيب كل حرف وكل كلمة مع سائر الحروف والكلمات في كل القرآن الكريم، ومع سائر الجمل، وسائر الفقرات، وسائر المقاطع، وسائر السور؛ هي في حد ذاتها بالملايين(25) ـ وليس 28 فقط ـ فكم سيكون الناتج المعرفي منها؟
هذا كله إضافة إلى أن تركيب كل ذلك مع الكثير من العلامات النحوية(26)، ثم مع كثير من قواعد التجويد(27) سينتج ما لا يحصى من المعاني، إضافة إلى (الترتيب) وغيره.(28)
هذا كله مع قطع النظر عن إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الاشتراك اللفظي على سبيل البدل كالنكرة، وفي المجموع، أو الاستعمال في الجامع للمعاني المتعددة، أي في المشترك المعنوي بين أنواع أو أصناف، بل واستعماله في أكثر من معنى كأن اللفظ لم يستعمل إلا فيه وكما المشهور جوازه، وإن منعه (القوانين) محاورةً، والنائيني والآخوند: عقلاً.(29)
وبذلك كان (القرآن الكريم) بياناً وتبياناً لكل شيء.(30)
وبذلك يتضح أنه لا وجه لإنكار مثل الرواية التالية، بل أنها على القاعدة، فقد روي في الكافي الشريف عن المعلى بن خنيس: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ما من أمرٍ يختلف فيه إثنان، إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال). (31)
و: القرآن حاكم على الزمان والظروف
إنه (الحاكم) على الزمان والمكان والظروف والحالات، وليس (محكوماً) بأي واحد من تلك العوامل ونظائرها.
فهو فوق الزمان والمكان، إلا أنه في الوقت نفسه، يضع المناهج والقواعد لكل زماني ومكاني، وهذا هو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.
ألا ترى أن قِيم القرآن الكريم ليست زمانية ـ مكانية؟ إذ من الواضح أن: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(32) حاكم على الزمان والمكان، فلا زمان ينسخه، ولا مكان يحدده؟ وكذلك: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)(33) و: (فلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).(34)


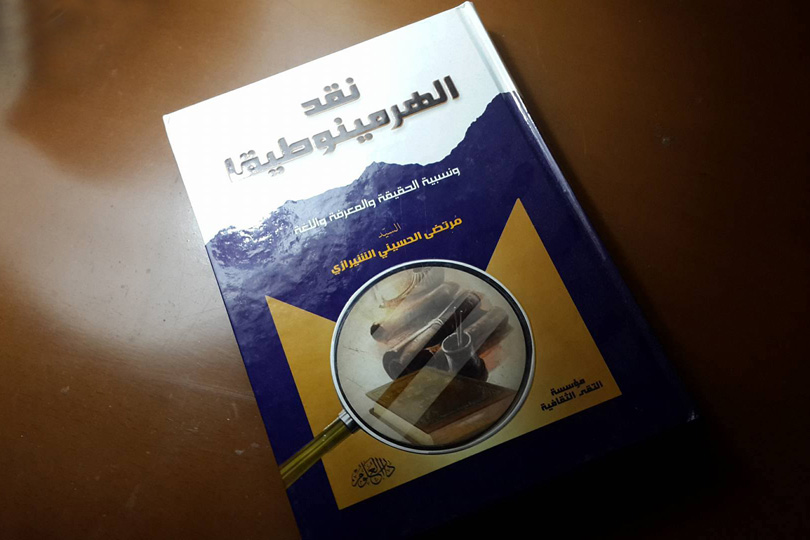

اضف تعليق