هل العراق بلد اشتراكي أم رأسمالي؟ هل العراق دولة مستقلة ذات سيادة أم جزء من محاور أقليمية أو دولية تتحكم بتلك السيادة؟ هل العراق دولة دينية أم علمانية؟ هل الدولة العراقية دولة أبوية راعية ومسيطرة على كل الأنشطة، أم هي دولة تقوم بتنظيم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...
على الرغم من لعنة الجغرافيا التي تم أيضاح تأثيرها السلبي على نشوء وتطور الدولة العراقية لغاية 2003، وعلى الرغم من الفشل الهيكلي والوظيفي لتلك الدولة (بمختلف أنظمتها الملكية والجمهورية) والذي أدى للفشل في أشراك العراقيين في أدارة شؤونهم المحلية والوطنية، الا أن الدولة العراقية عبر مختلف عصورها (عدا في بدياتها التأسيسية) كانت قادرة على تطوير قدرتها في أمتلاك العنصر الخامس المشار له سابقاً، من عناصر الدولة (أحتكار السلطة والعنف) بخاصة بعد الحكم الملكي.
واذا كانت العشائر في المناطق البعيدة عن المدن قادرة على منافسة الدولة في أحتكارها لسلطة السلاح بخاصة خلال بدايات الحكم الملكي الا أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد تطوراً واضحاً في قدرة الدولة العراقية على بسط سلطتها على معظم الأقليم الجغرافي للعراق.
وظلت هذه القدرة تنمو أكثر فأكثر لحين مغامرة غزو الكويت التي قسمت العراق فعلياً الى ثلاث أقاليم، كما أسلفت في المقال السابق، خرج أحدها (كوردستان) عن سيطرة الدولة بالكامل بعد حرب الخليج الثانية، في حين خرج الثاني (جنوب خط 32)عن سيادة العراق الجوية.
رؤية معارضاتية
ثم جاء الغزو الأمريكي للعراق في 2003 لا ليطيح بالنظام، بل بالدولة العراقية بالكامل ويعيد تشكيلها على وفق رؤية أمريكية-معارضاتية مشتركة. لقد أرتكزت الرؤية الجديدة لبناء الدولة العراقية على خليط من تصورات أمريكية خاطئة وواهمة لمرحلة ما بعد الاحتلال ممزوجة بنصائح مغلوطة، أوغير ناضجة في أحسن الاحوال من قبل ما سُمي بالمعارضة العراقية!
هنا ليست مهمتي تحليل الدوافع وراء تلك المقاربة التي أثبتت فشلها الذريع فيما بعد، وبأعتراف الأميركان و(المعارضة)، ولا أثبات أو دحض المؤامرة التي قد تكمن وراءها، لكن الأهم بحسب أهداف هذه الدراسة، هو تحديد ركائز تلك المقاربة (الأميركية-المعارضاتية) لبناء الدولة العراقية الجديدة وأنعكاساتها على قوة مؤسساتها وتأثيرها في المجتمع.
تمثلت الركيزة الأساس لبناء الدولة العراقية الجديدة، وكما عكسها الدستور من جهة، والممارسات السياسية الفعلية (والتي هي أقوى من الدستور) من جهة أخرى على: (أن ضمان امتلاك السلطة مقدّم على ضمان بناء الدولة). لذا يجب توزيع السلطة على المكونات (المحاصصاتية) بدل من حصرها بيد الدولة. وبالتالي فأن خلق دولة مركزية ضعيفة سيكون هو الحل، لأن وجود دولة قوية سيهدد المكونات العرقية والطائفية من جهة، والدول الأقليمية والدولية من جهة أخرى معيداً للأذهان دولة صدام وما سببته داخل وخارج العراق.
لقد كان واضحاً أن التاريخ لا المستقبل، والآيدلوجيا (الدينية والعرقية) لا المنطق السياسي السليم هي من تحكمت بتلك المقاربة للدولة العراقية الجديدة. لقد أدى ذلك من الناحية الفعلية الى حصول ما يلي:
1- خلق دولة ضعيفة تتشارك في قوتها السياسية وأحتكارها للعنف مع ممثلي المكونات العرقية والطائفية، بحيث باتت هي الحلقة الأضعف في مواجهة القابضين على السلطة.
2- أقاليم فيدرالية يمكن أن تنافس في قوتها الدولة، بل وتتفوق عليها أحياناً. وقد خلق ذلك أغراءً مضاعفاً لكل من يريد أن يمسك بالسلطة بعيداً عن بغداد للمطالبة بحقه الدستوري في الأقلمة.
3- أولوية الامتياز العرقي والطائفي على المواطنة العراقية. بذلك تم توزيع المناصب من قمة الهرم الى أسفله على أساس الأنتماء للمكون و(المبالغة) في أظهار الولاء له، بدلاً من أن تكون الجدارة والكفاءة والولاء للدولة هي معايير الأختيار.
دولة مكونات
4- عُلوية الآيدلوجيا العقائدية (دينية أو قومية). فالعراق بناءً على هذا الفهم دولة مكونات (كما مثبت دستورياً) وليس دولة مواطنة. لذا فأن منطق الأغلبية والأقليات هو المنطق السائد بدلاً عن منطق المواطنة والمساواة.
5- عدم وضوح الهوية السياسية والاقتصادية للدولة. فهل العراق بلد أشتراكي أم رأسمالي؟ هل العراق دولة مستقلة ذات سيادة أم جزء من محاور أقليمية أو دولية تتحكم بتلك السيادة؟ هل العراق دولة دينية أم علمانية؟ هل الدولة العراقية دولة أبوية راعية ومسيطرة على كل الأنشطة، أم هي دولة تقوم بتنظيم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتراقبها وتقف منها موقف واحد غير منحاز؟
لقد أدت هذه المقاربة الفكرية والعملية المبنية على التجربة اللبنانية للمشاركة في السلطة، وليس الأندماج في الدولة، الى خلق دولة عراقية هجينة وغير واضحة المعالم مهددة داخلياً بقوة اللاعبين السياسيين (المكوناتيين)، ومهددة خارجياً بنفوذ وقوة الدول الكبرى من جهة والقوى الأقليمية الفاعلة من جهة أخرى.
لذا لم تستطع الدولة العراقية بالطريقة التي بُنيت بها من مواجهة تحديات الارهاب والفساد والتخلف الاقتصادي والخدماتي، وظلت تعاني من مشاكل كثيرة مع (المكونات) السياسية، ومع الشعب ومع العالم الخارجي بحيث بدت (البلقنة) للبعض هي الحل التالي لـ (اللبننة) وهو تهديد جدي ينبغي التعامل معه من منطلق (عراقي) لا من منطلق (مكوناتي).


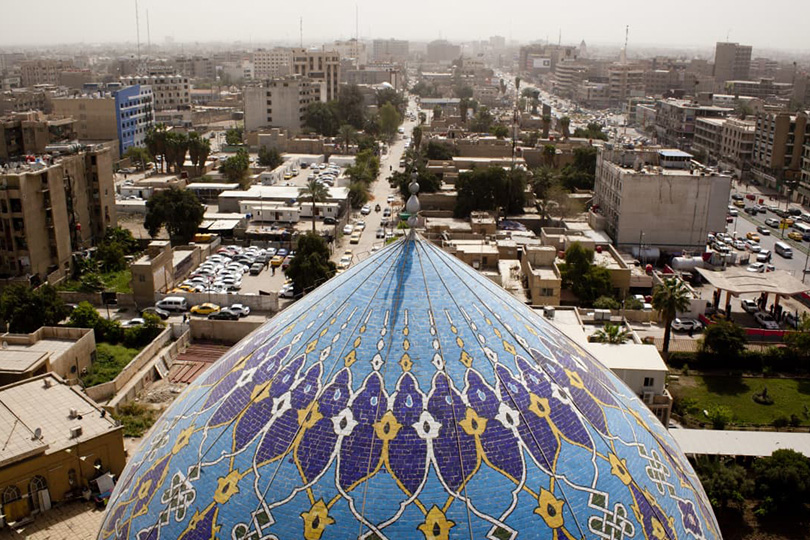

اضف تعليق