نشأ الاقتصاد، باعتباره نظاماً لفهم العالم المادي والسيطرة عليه وتخفيف المخاطر، وتطور في مختلف أنحاء العالم على نحو متدرج، مع ازدياد ثراء المجتمعات وتعقيد التجارة، لجأت النظرية الاقتصادية إلى الرياضيات والإحصاء والنمذجة الحاسوبية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه صانعي السياسات. وتُعد دورات الأعمال، وفترات الازدهار والكساد، وتدابير مكافحة التضخم، وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، نتاجًا للاقتصاد.
بقلم: أندرو بيتي
الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية إنتاج المجتمعات للسلع والخدمات وكيفية استهلاكها لها. وقد أثّرت النظرية الاقتصادية على المالية العالمية في مراحل تاريخية مهمة عديدة، وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومع ذلك، فقد تغيرت الافتراضات التي تُوجّه دراسة الاقتصاد بشكل كبير على مر التاريخ. إليكم لمحة موجزة عن تاريخ الفكر الاقتصادي.
النقاط الرئيسية
- لقد استخدمت الحضارات في الشرق الأوسط والصين وأماكن أخرى مفاهيم مالية متطورة وأنتجت أدلة مكتوبة لأفضل الممارسات والمعايير الاقتصادية في الألفية الأولى قبل الميلاد.
- كان الفيلسوف التونسي ابن خلدون، الذي كتب في القرن الرابع عشر، من أوائل المنظرين الذين بحثوا في تقسيم العمل، ودافع الربح، والتجارة الدولية.
- في القرن الثامن عشر، استخدم الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث أفكار كُتّاب عصر التنوير الفرنسيين لصياغة أطروحة حول كيفية عمل الاقتصادات. وفي القرن التاسع عشر، توسّع كارل ماركس وتوماس مالتوس في أعمالهما.
- استخدم الاقتصاديان ليون والراس وألفريد مارشال في أواخر القرن التاسع عشر الإحصاءات والرياضيات للتعبير عن المفاهيم الاقتصادية، مثل اقتصاديات الحجم.
- قام جون ماينارد كينز بتطوير نظريات في أوائل القرن العشرين والتي لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يستخدمها لإدارة السياسة النقدية اليوم.
- وتستند معظم النظريات الاقتصادية الحديثة على أعمال كينز ونظريات السوق الحرة لميلتون فريدمان، والتي تشير إلى أن المزيد من رأس المال في النظام يقلل من الحاجة إلى تدخل الحكومة.
- وتؤكد النظريات الأحدث، مثل تلك التي طرحها الخبير الاقتصادي أمارتيا سين من جامعة هارفارد، على ضرورة إدخال الأخلاق في حسابات الرفاهة الاجتماعية للكفاءة الاقتصادية.
الاقتصاد في العالم القديم
بدأ علم الاقتصاد بمفهومه الأساسي خلال العصر البرونزي (4000-2500 قبل الميلاد) بوثائق مكتوبة في أربع مناطق من العالم: سومر وبابل (3500-2500 قبل الميلاد)؛ وحضارة وادي نهر السند (3300-1030 قبل الميلاد)، فيما يُعرف اليوم بأفغانستان وباكستان والهند؛ وعلى طول نهر اليانغتسي في الصين؛ ووادي النيل في مصر، بدءًا من حوالي عام 3500 قبل الميلاد. طورت المجتمعات في هذه المناطق أنظمة ترميز باستخدام علامات على ألواح الطين والبردي ومواد أخرى لبيان المحاصيل والثروة الحيوانية والأراضي.
وقد تضمنت هذه الأنظمة المحاسبية، التي نشأت بالتزامن مع اللغة المكتوبة، في نهاية المطاف أساليب لتتبع عمليات نقل الملكية، وتسجيل الديون ومدفوعات الفائدة، وحساب الفائدة المركبة، وأدوات اقتصادية أخرى لا تزال مستخدمة حتى اليوم.
منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد فصاعدًا، دوّن الكتبة المصريون جمع الأراضي والسلع وإعادة توزيعها. وطوّر التجار السومريون أساليب لحساب الفائدة المركبة. وتُعدّ شريعة حمورابي (حوالي ١٨١٠-١٧٥٠ قبل الميلاد)، وهي أقدم عمل في مجال التوليف الاقتصادي، معايير النشاط الاقتصادي، وتُقدّم إطارًا مُفصّلًا للتجارة، بما في ذلك أخلاقيات العمل للتجار وأصحاب الحرف.
شهدت الألفية الأولى قبل الميلاد ظهور أطروحات مكتوبة أكثر تفصيلاً حول الفكر والممارسة الاقتصادية. وضع الفيلسوف والشاعر اليوناني هسيود، الذي كتب في القرن الثامن قبل الميلاد، مبادئ إدارة المزرعة في كتابه "الأعمال والأيام".
بنى القائد العسكري والفيلسوف والمؤرخ الأثيني زينوفون على هذا المبدأ في كتابه "أويكونوميكون"، وهو أطروحة حول الإدارة الاقتصادية للعقارات. وفي كتابه "السياسة"، توسع أرسطو (حوالي 350 قبل الميلاد) في هذه الأفكار، مستنتجًا أنه في حين أن الملكية الخاصة مفضلة، فإن تراكم الثروة لذاتها "أمرٌ مشين".
طرحت مقالات غوانزي من الصين (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) أحد أوائل التفسيرات لتسعير العرض والطلب، والدور الحاسم لمعروض نقدي مُدار جيدًا وعملة مستقرة. ومن بين الأفكار الرئيسية التي خلصت إليها هذه المقالات فكرة أن المال، وليس الجيوش، هو الذي ينتصر في الحروب في النهاية.
في أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى، كانت النظرية الاقتصادية غالباً ما تختلط بالأخلاق، كما يتبين من أعمال توما الأكويني (1225-1274) وغيره.
لم يتطرق سوى القليل من هؤلاء الكُتّاب إلى التفاصيل التي تناولها ابن خلدون (1332-1406)، المؤرخ والفيلسوف التونسي. ففي "المقدمة"، يُحلل ابن خلدون قضايا اقتصادية مثل مخاطر الاحتكارات، وفوائد تقسيم العمل، ودافع الربح، وصعود الإمبراطوريات الاقتصادية وسقوطها. وقد أدرك مكيافيلي وهيجل أهمية أعماله، وقد سبقت العديد من أفكاره أفكار آدم سميث ومن تبعه بعد قرون.
أبو الاقتصاد الحديث
يُنسب اليوم إلى المفكر الاسكتلندي آدم سميث الفضل على نطاق واسع في تأسيس علم الاقتصاد الحديث. إلا أن سميث استلهم أفكاره من الكُتّاب الفرنسيين الذين نشروا أعمالهم في منتصف القرن الثامن عشر، والذين شاركوه كراهيته للمذهب التجاري.
في الواقع، قام الفيزيوقراطيون الفرنسيون، ولا سيما كيناي وميرابو، بأول دراسة منهجية لكيفية عمل الاقتصاد. وقد أخذ سميث العديد من أفكارهم ووسّعها ليُشكّل أطروحة حول كيفية عمل الاقتصادات، وليس كيفية عملها بالفعل.
ملحوظة
كان سميث يعتقد أن المنافسة تنظم نفسها بنفسها، ولا ينبغي للحكومات أن تشارك في الأعمال التجارية من خلال التعريفات الجمركية أو الضرائب أو غيرها من الوسائل ما لم يكن ذلك لحماية المنافسة في السوق الحرة.
تُعدّ العديد من النظريات الاقتصادية اليوم، جزئيًا على الأقل، رد فعل على عمل سميث المحوري في هذا المجال، وتحديدًا تحفته الفنية " ثروة الأمم " الصادرة عام ١٧٧٦. في هذه الرسالة، عرض سميث آليات الإنتاج الرأسمالي، والأسواق الحرة، والقيمة. وأظهر سميث أن الأفراد، الذين يعملون لمصلحتهم الشخصية، قادرون، كما لو كانوا مُوجّهين بـ" يد خفية"، على خلق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والازدهار للجميع.
حتى أتباع أفكار سميث المخلصون يدركون أن بعض نظرياته إما كانت معيبة أو لم تصمد أمام الزمن. يُميز سميث بين "العمل المُنتج"، كتصنيع منتجات قابلة للتراكم، و"العمل غير المُنتج"، كالمهام التي يؤديها "خادمٌ بسيط"، والتي "تتلاشى قيمتها فور إنجازها".
يمكن القول إنه في اقتصاد اليوم الذي يهيمن عليه قطاع الخدمات، يُنتج الأداء المتميز للخدمات قيمةً من خلال تعزيز العلامة التجارية من خلال حسن النية وبطرق أخرى عديدة. إن تأكيده على أن "كميات متساوية من العمل، في جميع الأوقات والأماكن، يمكن اعتبارها متساوية القيمة بالنسبة للعامل" يتجاهل التكلفة النفسية للعمل في بيئات معادية أو استغلالية.
وكامتداد لهذا، تم التخلي إلى حد كبير عن نظرية سميث في قيمة العمل ــ والتي تقول إن قيمة السلعة يمكن قياسها بساعات العمل اللازمة لإنتاجها.
العلم الكئيب: ماركس ومالثوس
كانت ردود فعل توماس مالتوس وكارل ماركس تجاه أطروحة سميث سلبية للغاية. كان مالتوس واحدًا من مجموعة من المفكرين الاقتصاديين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الذين كانوا يتصارعون مع تحديات الرأسمالية الناشئة في أعقاب الثورة الفرنسية وتزايد مطالب الطبقة المتوسطة الناشئة. وكان من بين نظرائه ثلاثة من أعظم المفكرين الاقتصاديين في ذلك العصر، وهم جان باتيست ساي، وديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل.
توقع مالتوس أن النمو السكاني سيفوق وفرة الغذاء. إلا أنه ثبت خطأه، إذ لم يتوقع ابتكارات تكنولوجية تُمكّن الإنتاج من مواكبة النمو السكاني. مع ذلك، حوّل عمله تركيز الاقتصاد إلى ندرة السلع بدلاً من الطلب عليها.
دفع هذا التركيز المتزايد على الندرة ماركس إلى إعلان أن وسائل الإنتاج هي أهم مكونات أي اقتصاد. وطوّر ماركس أفكاره إلى أبعد من ذلك، وأصبح مقتنعًا بأن عدم الاستقرار المتأصل في الرأسمالية سيشعل فتيل حرب طبقية.
مع ذلك، قلّل ماركس من شأن مرونة الرأسمالية. فبدلاً من خلق فصل واضح بين طبقتين - الملاك والعمال - خلق اقتصاد السوق طبقة مختلطة، حيث تمسك الملاك والعمال بمصالح كلا الطرفين. ورغم صرامة نظريته، تنبأ ماركس بدقة باتجاه واحد: تنمو الشركات وتزداد قوتها بالقدر الذي تسمح به رأسمالية السوق الحرة.
الثورة الهامشية
مع تطور مفاهيم الثروة والندرة في الاقتصاد، وجّه الاقتصاديون اهتمامهم إلى أسئلة أكثر تحديدًا حول كيفية عمل الأسواق وكيفية تحديد الأسعار. طوّر كلٌّ من الاقتصادي الإنجليزي ويليام ستانلي جيفونز (1835-1882)، والاقتصادي النمساوي كارل مينجر (1840-1921)، والاقتصادي الفرنسي ليون والراس (1834-1910)، بشكل مستقل، منظورًا جديدًا في الاقتصاد يُعرف باسم " الحديّة".
تمثلت رؤيتهم الرئيسية في أن الناس، عمليًا، لا يواجهون قرارات شاملة تتعلق بفئات عامة كاملة من السلع الاقتصادية. بل يتخذون قرارات حول وحدات محددة من سلعة اقتصادية معينة عند اختيارهم شراء أو بيع أو إنتاج كل وحدة إضافية (أو هامشية). وبذلك، يوازن الناس بين ندرة كل سلعة وقيمة استخدامها على الهامش.
تُفسر هذه القرارات، على سبيل المثال، سبب ارتفاع سعر الماسة الواحدة نسبيًا عن سعر وحدة الماء. فرغم أن الماء حاجة أساسية للحياة، إلا أنه غالبًا ما يكون وفيرًا، ورغم أن الماس غالبًا ما يكون لأغراض زخرفية بحتة، إلا أنه نادر. وسرعان ما أصبحت الهامشية، ولا تزال، مفهومًا محوريًا في الاقتصاد.
التحدث بالأرقام
واصل والراس تطبيق نظريته في التحليل الهامشي رياضيًا، ووضع نماذج ونظريات تعكس ما توصل إليه. ونشأت من عمله نظرية التوازن العام، وكذلك ممارسة التعبير عن المفاهيم الاقتصادية إحصائيًا ورياضيًا بدلًا من مجرد الكتابة. أما ألفريد مارشال، فقد ارتقى بالنمذجة الرياضية للاقتصادات إلى آفاق جديدة، مقدمًا العديد من المفاهيم التي لا تزال غير مفهومة على نطاق واسع، مثل اقتصاديات الحجم، والمنفعة الحدية، ونموذج التكلفة الحقيقية.
حقيقة سريعة
يكاد يكون من المستحيل إخضاع أي اقتصاد للدقة التجريبية؛ لذا، يُعتبر علم الاقتصاد على حافة العلم. مع ذلك، أصبحت بعض النظريات الاقتصادية قابلة للاختبار من خلال النمذجة الرياضية.
تطورت النظريات التي وضعها والراس ومارشال وخلفاؤهما في القرن العشرين إلى المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة، التي اتسمت بالنمذجة الرياضية وافتراضات الجهات الفاعلة العقلانية وكفاءة الأسواق. لاحقًا، طُبقت الأساليب الإحصائية على البيانات الاقتصادية في شكل الاقتصاد القياسي، مما سمح للاقتصاديين باقتراح واختبار الفرضيات تجريبيًا وبمنهجية دقيقة.
كينز والاقتصاد الكلي
طوّر جون ماينارد كينز فرعًا جديدًا من الاقتصاد يُعرف بالاقتصاد الكينزي أو الاقتصاد الكلي. صنّف كينز الاقتصاديين الذين سبقوه بالاقتصاديين "الكلاسيكيين". كان يعتقد أنه على الرغم من أن نظرياتهم قد تنطبق على الخيارات الفردية وأسواق السلع، إلا أنها لم تصف بدقة آلية الاقتصاد ككل.
بدلاً من الوحدات الهامشية أو حتى أسواق وأسعار السلع المحددة، يُصوّر الاقتصاد الكلي الكينزي الاقتصاد من خلال مجاميع واسعة النطاق تُمثّل معدل البطالة، أو الطلب الكلي، أو متوسط تضخم مستوى الأسعار لجميع السلع. علاوة على ذلك، تنص نظرية كينز على أن الحكومات يُمكن أن تكون جهات فاعلة مؤثرة في الاقتصاد، فتنقذه من الركود من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية توسعية لزيادة الناتج الاقتصادي واستقراره.
التوليف الكلاسيكي الجديد
وبحلول منتصف القرن العشرين، ارتقى هذان التياران الفكريان ــ الاقتصاد الجزئي الرياضي الهامشي، والاقتصاد الكلي الكينزي ــ إلى هيمنة شبه كاملة في مجال الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم الغربي.
عُرف هذا باسم التوليف الكلاسيكي الجديد، الذي مثّل منذ ذلك الحين الفكر الاقتصادي السائد. يُدرّس هذا التوليف في الجامعات ويمارسه الباحثون وصانعو السياسات، بينما تُصنّف وجهات نظر أخرى على أنها اقتصاد غير تقليدي.
في إطار التوليف الكلاسيكي الجديد، نشأت تيارات فكرية اقتصادية متنوعة، متعارضة أحيانًا. وقد أدى التوتر المتأصل بين الاقتصاد الجزئي الكلاسيكي الجديد (الذي يصور الأسواق الحرة على أنها فعّالة ومفيدة) والاقتصاد الكلي الكينزي - الذي يرى الأسواق عرضة بطبيعتها للفشل الكارثي - إلى خلافات أكاديمية وسياسية مستمرة، مع ظهور نظريات مختلفة في أوقات مختلفة.
ملحوظة
وقد سعى العديد من الاقتصاديين والمدارس الفكرية إلى تحسين وإعادة تفسير وتحرير وإعادة تعريف الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد والاقتصاد الكلي الكينزي.
أبرزها المدرسة النقدية ومدرسة شيكاغو، التي طورها ميلتون فريدمان، والتي تُبقي على الاقتصاد الجزئي الكلاسيكي الجديد وإطار الاقتصاد الكلي الكينزي، لكنها تُحوّل تركيز الاقتصاد الكلي من السياسة المالية (التي يُفضّلها كينز) إلى السياسة النقدية. حظيت المدرسة النقدية بتأييد واسع النطاق خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية.
طُرحت عدة اتجاهات مختلفة من النظرية والبحوث الاقتصادية لحل الخلاف بين علماء الاقتصاد الجزئي والكلي. وتُدمج هذه المحاولة جوانب أو افتراضات من الاقتصاد الجزئي (مثل التوقعات العقلانية) في الاقتصاد الكلي، أو تُطوّر الاقتصاد الجزئي لتوفير أسس جزئية (مثل ثبات الأسعار أو العوامل النفسية) للاقتصاد الكلي الكينزي.
وفي العقود الأخيرة، أدى هذا إلى ظهور نظريات جديدة، مثل الاقتصاد السلوكي، وإلى تجدد الاهتمام بالنظريات غير التقليدية، مثل اقتصاد المدرسة النمساوية، التي كانت في السابق منعزلة عن بقية الاقتصادات.
الاقتصاد السلوكي
لقد استندت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ونظرية الأسواق، من سميث إلى فريدمان، بشكل أساسي على افتراض أن المستهلكين هم ممثلون عقلانيون يتصرفون بما يخدم مصالحهم.
ومع ذلك، فقد أظهر خبراء الاقتصاد الحاليون مثل ريتشارد ثالر ودانيال كانيمان، والمرحوم غاري بيكر، وأموس تفيرسكي، أن الناس في كثير من الأحيان لا يتصرفون وفقاً لمصالحهم المادية الخاصة، بل يسمحون لأنفسهم بالتأثر بعوامل نفسية غير مادية وتحيزات.
ساهم الاقتصاد السلوكي في ترويج العديد من المفاهيم الجديدة التي تُصعّب النمذجة والتنبؤ الاقتصاديين أكثر من أي وقت مضى. تشمل هذه المفاهيم:
مغالطة التكلفة الغارقة: الاستمرار في الاستثمار في مشروع فاشل بسبب ما تم استثماره حتى الآن.
الاستدلال بالتوافر: إن التفكير في نتيجة محددة لفعل ما يكون أكثر احتمالا لأنه يأتي إلى الذهن بسهولة أكبر من النتائج الأخرى.
العقلانية المحدودة: الأشخاص الذين يتصرفون دون الحصول على معلومات كاملة عندما يعرفون أن المزيد من المعلومات متاحة.
مراعاة المنافع الاجتماعية
شدّدت مجموعة متزايدة من الاقتصاديين على أهمية مراعاة التفاوت في توزيع الدخل والرفاه الاجتماعي عند قياس نجاح أي سياسة اقتصادية. ومن أبرزهم أنتوني أتكينسون (1944-2017)، الذي ركّز على إعادة توزيع الدخل داخل أي بلد.
ومن بين الشخصيات المرموقة الجديرة بالذكر أيضاً أمارتيا سين، أستاذ الاقتصاد والفلسفة في جامعة هارفارد، والذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 1998 عن عمله في مجال التفاوت العالمي.
يتميز عمل سين أيضًا بإعادة إدراج السلوك الأخلاقي في تحليله. يربط هذا الاهتمام تفكير سين بكتابات أوائل المفكرين الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن الإفراط في تراكم الثروة من قبل الأفراد أو الجماعات يضر بالمجتمع في نهاية المطاف.
ما هو علم الاقتصاد وتاريخه؟
الاقتصاد هو علم دراسة قدرة المجتمع على إنتاج السلع والخدمات، وشرائها وبيعها، واستهلاكها. وتعود الوثائق والنظريات والنقاشات المتعلقة به إلى آلاف السنين.
من هو أول من اخترع علم الاقتصاد؟
لم يُخترع علم الاقتصاد شخص واحد، بل ساهم فيه العديد من المفكرين والمجتمعات المرموقة عبر التاريخ.
متى بدأ التاريخ الاقتصادي؟
يُنسب علم الاقتصاد الحديث إلى آدم سميث، الذي نشر كتاب " ثروة الأمم " عام ١٧٧٦. إلا أن الممارسات والأفكار التي أدت إلى نشر سميث لورقته البحثية تطورت على مدى قرون من النقاشات والأفكار حول العالم.
خلاصة القول
نشأت النظرية الاقتصادية نتيجةً لحاجة المجتمعات إلى حساب الموارد، والتخطيط للمستقبل، وتبادل السلع وتوزيعها. ومع مرور الوقت، تطورت هذه الأدوات المحاسبية الأساسية إلى نماذج مالية متزايدة التعقيد، تمزج الرياضيات اللازمة لحساب الفائدة المركبة بالأخلاق والفلسفة الأخلاقية.
لقد نشأ الاقتصاد، باعتباره نظاماً لفهم العالم المادي والسيطرة عليه وتخفيف المخاطر، وتطور في مختلف أنحاء العالم على نحو متدرج ــ في الهلال الخصيب ومصر، والصين والهند، واليونان القديمة، والعالم العربي.
مع ازدياد ثراء المجتمعات وتعقيد التجارة، لجأت النظرية الاقتصادية إلى الرياضيات والإحصاء والنمذجة الحاسوبية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه صانعي السياسات. وتُعد دورات الأعمال، وفترات الازدهار والكساد، وتدابير مكافحة التضخم، وأسعار الفائدة على الرهن العقاري، نتاجًا للاقتصاد.
فهم هذه العوامل يُساعد السوق والحكومة على التكيف مع هذه المتغيرات. وموازنةً لمنهج النمذجة الرياضية، تُجرى دراسة عوامل يصعب قياسها كميًا، ولكنها بالغة الأهمية لفهمها، وأبرزها نقاط ضعف النفس البشرية وعدم القدرة على التنبؤ بها.


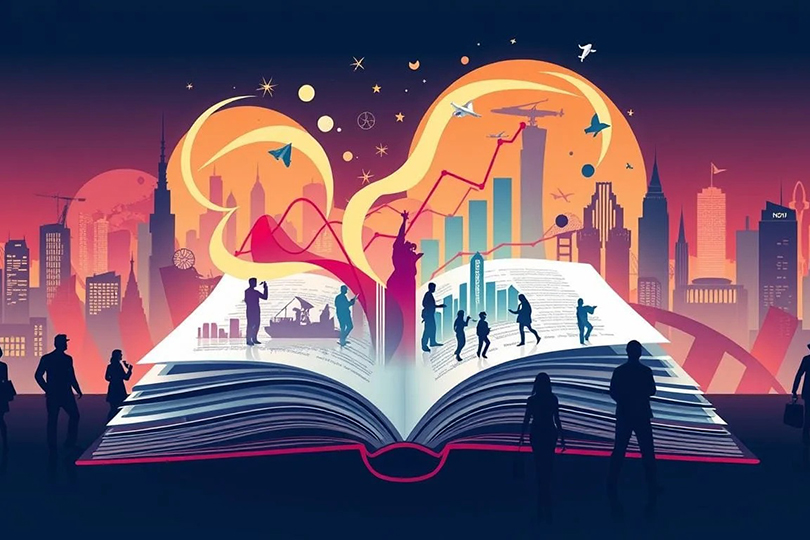

اضف تعليق