يتناول كتاب "ملامح العلاقة بين الدولة والشعب" موضوعاً ذا أهمية قصوى، كونه يرتبط بالحقوق المشروعة للشعب، ومبادئ المواطنة والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والأطر السيادية للدولة والحكم الرشيد. وتكتسب هذه الموضوعات حيوية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة في المنطقة العربية والإقليم، بهدف إرساء العلاقة الحقوقية بين الأنظمة وشرعية حكمها...
يقدم كتاب "ملامح العلاقة بين الدولة والشعب"، وهو تقرير يستند إلى سلسلة محاضرات ألقاها آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي في الحوزة العلمية الزينبية، إطارًا فقهيًا وأصوليًا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. ويركز العمل على مبدأ الأمانة في الحكم، معتبرًا إياها المقياس الذي تسقط بفقدانه شرعية الحاكم، كما يناقش الكتاب الأطر القانونية الستة لشرعية الحكم، بما في ذلك الوكالة والإجارة والولاية. ويسلط الضوء بشكل خاص على العدل كقيمة أساسية، وضرورة انتخاب قائد الجيش ودمجه في المجتمع، معتبرًا أن الحكم في الإسلام استشاري وليس ديمقراطيًا أو ديكتاتوريًا.
مقدمة الكتاب وأهميته
يتناول كتاب "ملامح العلاقة بين الدولة والشعب" موضوعاً ذا أهمية قصوى، كونه يرتبط بالحقوق المشروعة للشعب، ومبادئ المواطنة والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والأطر السيادية للدولة والحكم الرشيد. وتكتسب هذه الموضوعات حيوية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة السياسية والمجتمعية في المنطقة العربية والإقليم، بهدف إرساء العلاقة الحقوقية بين الأنظمة وشرعية حكمها.
إن هذا البحث هو من الموضوعات الحيوية والمهمة وذات الأفق الاستراتيجي. يخلص الكتاب إلى استقراء مصادر الشرعية للحكم والسلطة، وطبيعة العقد الاجتماعي والسياسي الذي يحكم ممارسة هذه السلطة على الشعب، وفق الأطر القانونية والشرعية لها. ويطرح المؤلف رؤاه وتصوراته عن الملامح العامة لهذا الموضوع، مستنداً إلى الفكر الإسلامي، ومستضيئاً من النص المقدس.
يعد مفهوم الأمانة ومصاديقها، في تأسيسها لبناء الدولة ومسؤولية الحكم، هو المرجعية الشرعية للأطر الحقوقية في الحكم وسيادة الدولة والصلاحيات المخولة لها. ونظراً لأهمية هذه الرؤى والمسؤولية في تبيان مسؤوليات الدولة وحدود سلطتها وأصول شرعيتها، ولأهميتها الراهنة والمستقبلية، فقد جرى تضمين المحاضرات المتسلسلة في كتاب بعد إعادة تحريرها ومنهجيتها وترتيبها المنطقي.
الأمانة كمرجعية شرعية للحكم
يُعد البحث في الإطار القانوني والشرعي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بين الدولة والشعب، من متطلبات الدراسة المعمقة، فهو يخلص لاستقراء مصادر الشرعية للحكم والسلطة، وطبيعة العقد الاجتماعي والسياسي. وتتركز شرعية الحكم والسلطة على مفهوم الأمانة ومصاديقها، وإسقاطها على الدولة ومسؤولية الحكم، وبيان الحدود الشرعية والعقلائية لها.
يستند منهج الدراسة في هذا الكتاب إلى البصائر القرآنية في تحديد معالم وأبعاد موضوع البحث، وفي وحدة موضوعه، من خلال آية "الأمانة" الكريمة. إن ما يلفت الانتباه في قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)، هو استخدام مادة الأمر بصيغتها المؤكدة والشديدة، ما يدل على الأهمية القصوى والوجوب أو الحتمية والضرورة للمطلوب الأكيد.
عمومية الأمانة ونطاقها:
الخطاب في الآية الكريمة عام للجميع على السواء، خلافاً لمن توهم أنه خاص بالحكام فقط. فالأمانة موجهة للحكام وللمحكومين، وللتجار ولرجال الدين، وللجامعيين ولعامة الناس. فرئيس الدولة أو رئيس الوزراء مكلف بأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، لأن الحكم أمانة والسلطة أمانة في عنقه.
وكلمة "الأمانات" وردت جمعاً محلى بالألف واللام، ما يفيد العموم والاستغراق لمختلف أنواع الأمانة وكافة أصنافها. قد تكون الأمانة مادية (كمال يُسلم لآخر)، وقد تكون معنوية (كرعاية الأب لابنه). وسلطة الحاكم هي أمانة في عنقه، وهي أعم من الأمانة المادية والمعنوية الشخصية؛ لأنها أمانة أمة أو شعب بكل ما تتضمنه من أبعاد مادية ومعنوية.
الأمانة في فكر أمير المؤمنين (ع):
يُستدل من الروايات على أن الحاكم ليس له أن يستأثر بالسلطة، فيأكل أموال المسلمين ويعتبرها طعمة من حقه. فقد قال أمير المؤمنين (ع): "أيها الناس إن أمركم هذا ليس لأحد فيه حق، إلا من أمرتم، وإنه ليس لي دونكم، إلا مفاتيح ما لكم معي". أي أن من ينتخبه الناس له الحق في الأمر والنهي، لكنه ليس مالكاً لأموالهم. كما وصف (ع) الحكام بأنهم: "خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، وَوَكَلَاءُ الْأُمَّةِ"، وعلى الوكيل ألا يخون فيما وُكِّل فيه.
الأمانة الارتباطية ومفهوم العدل الشمولي
يرجح الكتاب أن الأمانة في سياق الحكم هي أمانة ارتباطية. هذا يعني أن الأمانة والحكم من قبيل "العنوان والمحصِّل". فإذا سقطت أمانة الحاكم في جزئية واحدة، تسقط شرعية حكمه. وهذا المفهوم الارتباطي يعني أن الحاكم لو أدى الأمانة لكافة أفراد الشعب (99.99%)، لكنه ظلم سجيناً واحداً أو شخصاً واحداً، فإنه على المستوى الأخلاقي يُنزّل عمله منزلة العدم.
إن عنوان "الأمين" لا يصدق على الحاكم إلا إذا التزم بأداء الأمانة في كل الموارد. وإذا ظلم الحاكم شخصاً واحداً فقط، فإنه قد فقد أمانته، وتسقط عنه العدالة.
كما أن العدل مطلوب بكمّه وكيفه وجهته. فالعدل في الحكم هو أن يعطي كل ذي حق حقه. والعدل في الكيفية (طريقة الحكم) يتطلب ألا يتسلط الحاكم على المحكومين أو يتصرف بأموالهم، بل يجب أن يكون متواضعاً وشعبياً. أما العدل في الجهة، فيراد به أن يكون القاضي أو الحاكم عادلاً لله وللعدالة، وليس طمعاً أو خوفاً من الرقابة أو مكاسب شخصية.
مناشئ شرعية السلطة والأطر القانونية
ناقش الكتاب كذلك الأطر القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولة والشعب، وهي: الوكالة، الإذن، الإجارة، العقد المستأنف، الوالية، والتفويض.
1. الوكالة: الحاكم وكيل عن الشعب في تسيير أموره وحفظ استقلال البلد. وحدود الوكيل هي: ألا يتجاوز دائرة الوكالة، وحق الموكل (الشعب) في عزله متى شاء (لأن الوكالة عقد جائز)، وحق نقض قراراته التي تتم خارج حدود وكالته.
2. الإجارة (الليّس): الحاكم أجير للشعب لمدة محددة براتب معين مقابل خدمات يقدمها. وشروط الإجارة هي الرضا الطوعي من الطرفين (الشعب لا يكره على حاكم)، وضرورة أن يكون الأجير (الحاكم) قوياً وأميناً.
3. الولاية والتفويض: وهذا هو منطق الطغاة والمستبدين، حيث يرون لأنفسهم ولاية على الأمة وأن الناس بمنزلة العبيد.
4. العقد المستأنف: صيغة جديدة للعلاقة، ليست وكالة ولا إجارة، وقد يُصطلح عليها بالعقد الاجتماعي.
منطق الطغاة ونزاع الملكية والقهر:
يرى الكتاب أن منشأ حق الحاكمية المتوهم لدى الطغاة يرجع إلى "المالكية" (أي اعتبار الحاكم نفسه مالكاً للرعية وللثروات)، كما كان منطق فرعون. والطغاة يسعون لتملك الثروات أولاً، للسيطرة على رقاب الناس اقتصادياً.
والمنشأ الثاني لشرعية الحكم لدى المستبدين هو "القهر والغلبة". وهذا المنطق باطل شرعاً وعقلاً.
السيادة: الشعب أم الأمة؟
ناقش الكتاب الفرق بين مفهومي "الشعب" و "الأمة".
* الشعب: يعني آحاد الناس الحاليين، وهم من يملكون حق تقرير مصيرهم.
* الأمة: شخصية اعتبارية ترمز للماضي والحاضر والمستقبل.
إذا كانت السيادة للشعب، فكل آحاد الشعب لهم الحق في الانتخاب، ولهم حق العزل والرقابة. أما إذا كانت السيادة للأمة، فإن الحاكم يُمثل الأمة، وعندها لا يستطيع الشعب عزله على الإطلاق. ويرى المؤلف أن هذا التفريق الذي ذكره علماء القانون غير تام، وأن القول بأن الأمة قد أعطت ممثلها سلطة مطلقة دون رقابة أو عزل هو ادعاء بلا دليل. بل القاعدة العقلية تقتضي أن تكون لعامة الشعب الصلاحية في النصب والعزل والرقابة.
تشريع حق الرقابة على الحكام:
من البصائر المستنبطة من آية الأمانة، أنها تدل بالدلالة الالتزامية العرفية على تشريع حق رقابة الناس على الحاكم. فللناس الحق في الرقابة على الحاكم للتأكد من عدله في حكمه.
حقوق الشعب المسلوبة:
يؤكد الكتاب على ضرورة تفقه الشعب بالمسؤولية، وحدود سلطة الدولة. ويشير إلى أن الحكومات المستبدة تسحق حقوق الناس. ومن أمثلة الحقوق المسلوبة:
* حق العمل بحرية للسجين.
* حق اللقاء اليومي بأهله.
* حق الناس في تقرير مصيرهم.
* حق التملك (حيث تدعي الدولة ملكيتها للثروات العامة والنفط والمعادن، خلافاً للشرع الذي جعل الأرض لله ولمن عمرها).
دور الجيش والقوات المسلحة
يعد الجيش والقوات المسلحة السلاح الأقوى للطغاة والمستبدين. لذلك، يشدد الكتاب على ضرورة وضع أطر قانونية لتحديد الموقع الصحيح للجيش ومنع تركز القدرة بيد شخص واحد (كفصل سلطة قيادة الجيش عن رئيس الجمهورية).
موقع الجيش في نهج البلاغة:
وقد حدد أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) في عهده لمالك الأشتر الإطار الشرعي لموقع الجيش.
* "فالجنود بإذن الله حصون الرعية": فالجيش حصن للرعية، وليس حصناً للحاكم.
* "وزين الولاة": الجيش جمال للوالي ومفخرة له لأنه حافظ على دوره في حماية الشعب.
* "وعز الدين": الجيش يعز الدين إذا استخدم دفاعاً عن حقوق الناس.
* "وسبل الأمن": الجنود سبل للأمن، وليسوا أداة للقمع والإرهاب.
* مواصفات القائد: يجب أن يكون القائد الأشد إخلاصاً لله، والأنقى جيباً (نقي القلب واليد من الخيانة)، والأفضل حلماً، والرؤوف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء.
ضمانات استقامة الجيش:
لضمان عدم تحول الجيش إلى أداة قمع، يقترح الكتاب ضمانات هيكلية وقانونية:
1. انتخاب قائد الجيش: يجب أن يكون تنصيب القائد بالانتخاب وليس بالتعيين.
2. فصل السلطات العسكرية: ألا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش. ويُقترح تأسيس "السلطة العسكرية" كسلطة رابعة موازية للتنفيذية والتشريعية والقضائية.
3. نزاهة السجل: يجب أن يكون السجل الحقوقي والإنساني للقائد نظيفاً بل ومتميزاً.
4. التثقيف الحقوقي: تثقيف الجيش المكثف بـ "العلة الغائية" لدوره (الدفاع عن الوطن وحقوق الرعية).
5. تقليص هيمنة الحاكم على الجيش: تحويل نظام المثوبات والعقوبات (الرواتب، الترقيات، التنقلات) إلى جهة أخرى غير الحاكم (مثل البرلمان، العلماء، أو مجالس الشورى المحلية).
6. إلغاء التجنيد الإجباري وتقليص الجيش النظامي: التجنيد الإجباري خطأ شرعاً وعقلاً لأنه يخرق حرية الإنسان ويسهم في تضخم الجيش، ما يجعله أداة للطاغية.
7. تعميم التدريب التطوعي: الحل لمواجهة الأعداء يكمن في تدريب عامة الشعب تطوعاً على السلاح.
8. تقوية الموازي الشعبي للجيش: دعم العشائر وتقويتها وتسليحها لتكون موازناً طبيعياً للجيش، لأنها تكوين طبيعي يقرره الله في البشر.
ملامح الحكم الإسلامي
يؤكد الكتاب على أن الحكم في الإسلام ليس ديكتاتورياً (استبدادياً) أبداً، بل هو حكم استشاري. الديمقراطية (بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسه وأن تكون السلطة مستمدة من الشعب فقط) ليست صحيحة في الإسلام، لأن منشأ الشرعية هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل جلاله أقر في زمن الغيبة نظاماً استشارياً له مقومات ومواصفات أكمل وأفضل من الحكم الديمقراطي.
إن العدل هو أساس الدين، وهو ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو عبادة القلب وتنسكه ومسكنه. ويجب أن يُطبق الحكم الشرعي (مثل الحدود) في سياق يراعي العدالة الشاملة، فلا يصح تطبيق الحدود الإسلامية (كقطع يد السارق) إذا لم يكن النظام الاقتصادي الإسلامي مطبقاً في الأصل، وحيث الحاكم يمارس الاستبداد.
الانتخابات تحدد شرعية الحكم والسلطة
لقد جاء في الكتاب العديد من الملامح والتصورات حول الانتخابات، وذلك ضمن سياق تحديد مصادر شرعية الحكم والسلطة، وكيفية تفعيل هذه السلطة على الشعب.
يمكن تلخيص ما ورد في الكتاب عن الانتخابات في النقاط التالية، مع التركيز على علاقتها بالأطر القانونية للسيادة:
1. الانتخابات كآلية لشرعية الحكم وتفويض السلطة
تعد الانتخابات آلية أساسية يستمد منها الحاكم حقه في الأمر والنهي، وهو ما يؤكد أن السلطة ليست حقاً أصيلاً للحاكم:
* يُستدل على أن من ينتخبه الناس (الحاكم) يكون له الحق في الأمر والنهي.
* وُيشار إلى أن تداول السلطة السلمي يتم عبر صناديق الانتخاب.
* وفي إطار الوكالة، يُشار إلى أن الحاكم يكون وكيلاً عن الشعب في تسيير أموره، وإذا انتخب الناس الحاكم وكانت الوكالة هي العقد، فللناس حق عزله متى أرادوا.
* في إطار الإجارة (الليّس)، يجب أن تنعقد العلاقة بالرضا الطوعي، إذ لا تقع الإجارة إلا عن رضا وطوع واختيار من الناس.
* في إطار العقد المستأنف (العقد الاجتماعي)، يُمكن الافتراض بأن رضا الأكثرية يكفي لانتخاب الحاكم ونفوذ حكمه حتى على الأقلية غير المنتخبة له، خلافاً لما يجري في العقود المتعارفة الأخرى.
2. الانتخابات كمصدر للشرعية الإلهية والاستشارية (مقابل الديمقراطية المطلقة)
يوضح الكتاب الموقف الإسلامي من الانتخابات، حيث لا يُنظر إليها كمصدر وحيد للشرعية، بل كآلية ضمن نظام استشاري:
* في الإسلام، حق الانتخاب مكفول للناس.
* يجب أن يتوفر في الحاكم المنتخب شروط ومواصفات أكثر تكاملاً وعقلانية من الأنظمة الأخرى، مثل اشترط "العدالة" فيه، إذ لا يصح القول للناس بأنهم أحرار في انتخاب الخائن أو السفيه أو الأمي.
* الإسلام لا يقر بالديمقراطية بالمعنى الذي يعني أن السلطة مستمدة من الشعب فقط، بل يرى أن منشأ الشرعية هو الله سبحانه وتعالى.
* في زمن الغيبة، أقر الله نظاماً استشارياً له مقومات ومواصفات أكمل وأفضل من الحكم الديمقراطي.
3. الانتخابات والسيادة: الشعب أم الأمة؟
النقاش حول الانتخابات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمن هو مصدر السلطة المخوّلة: هل هو "الشعب" أم "الأمة"، وتختلف تبعات الانتخاب باختلاف هذا المصدر:
الانتخاب بناءً على سيادة الشعب:
* يعني أن آحاد الناس (الشعب الحالي) هم من يملكون حق تقرير مصيرهم.
* يكون الانتخاب هنا "حقاً" وليس إلزاميًا واجباً، وللإنسان أن يسقط حقه في الانتخاب أو يتركه.
* للرعية (الشعب) حق العزل والرقابة على ممثليهم.
* الممثل المنتخب يمثل دائرته الانتخابية فقط، لأن سكانها انتخبوه.
الانتخاب بناءً على سيادة الأمة:
* الأمة هي شخصية اعتبارية (ترمز للماضي والحاضر والمستقبل).
* مهمة الشعب تنحصر في تحديد الذين يمثلون الأمة عبر الانتخاب. فإذا مُثّلوا الأمة، لا يستطيع الشعب عزلهم على الإطلاق.
* تكون المشاركة في الانتخاب هنا واجباً ملزماً، وليس مجرد حق.
* الممثل المنتخب يمثل الأمة كلها، والاقتراع في دائرته كان مجرد علة محدثة (لتحديد نواب الأمة).
* الكتاب يستظهر أن القول بسيادة الأمة غير تام، وأن المنطق العقلي يقتضي أن تكون لعامة الشعب صلاحية النصب والعزل والرقابة، لأن الحاكم يتصرف في أموال وآحاد الشعب.
هل الديمقراطية مصدر الشرعية للحكم؟
تناول الكتاب مفهوم الديمقراطية بالنقاش والتحليل، خاصة فيما يتعلق بمصدر الشرعية للحكم، ومقارنتها بنظام الحكم الذي أقره الإسلام، كما ورد في النقاط التالية:
1. الديمقراطية في المنظور الإسلامي (الاستشارية)
يشير الكتاب إلى أن الديمقراطية بمعناها الشائع (حكم الشعب نفسه بنفسه وأن تكون السلطة مستمدة من الشعب فقط) ليست صحيحة في الإسلام.
* مصدر الشرعية: منشأ الشرعية في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى.
* الحكم البديل: أقر الله جل جلاله في زمن الغيبة (أي غياب الإمام المعصوم) نظاماً استشارياً له مقومات ومواصفات أكمل وأفضل من الحكم الديمقراطي.
* حق الانتخاب: رغم ذلك، فإن حق الانتخاب مكفول للناس في الإسلام.
* الشروط للحاكم: يختلف النظام الإسلامي عن الديمقراطية الغربية في أنه يضع شروطاً للحاكم أكثر تكاملاً وعقلانية، مثل اشتراط "العدالة" فيه، حيث لا يصح أن يقال للناس إنهم أحرار في انتخاب الخائن أو السفيه أو الأمي.
2. الشروط في الديمقراطيات الغربية
على الرغم من تحفظ الكتاب على الديمقراطية المطلقة، فإنه يلاحظ أن الديمقراطيات نفسها تفرض قيوداً وشروطاً:
* حتى في الدول الديمقراطية، توجد شروط في المرشح لانتخابه لمنصب الحاكم.
* الإسلام وضع شروطاً أكثر تكاملية وعقلانية من تلك التي في الدول الغربية.
* القيود القانونية: يرى المؤلف أن الحريات في الإسلام أوسع بكثير من الحريات الموجودة في أكثر الديمقراطيات في العالم اليوم. ويشمل ذلك قيوداً على حرية البناء، وحرية الإقامة، وحرية السفر، وحرية تأسيس الشركات.
3. الديمقراطية وعزل الحاكم (سيادة الشعب مقابل سيادة الأمة)
يرتبط مفهوم الانتخاب والديمقراطية بمسألة السيادة، وهل هي للشعب (آحاد الناس) أو للأمة (الشخصية الاعتبارية التي تمثل الماضي والحاضر والمستقبل):
* الديمقراطية وسيادة الشعب: إذا كانت السيادة للشعب، فإن الانتخاب حق وليس إلزاماً. وفي هذه الحالة، يكون للمنتخِب (الشعب) حق الرقابة والعزل على ممثليهم.
* سيادة الأمة ونفي العزل: يميل المذهب الذي يتبنى سيادة الأمة إلى أن مهمة الشعب تنحصر في تحديد ممثلي الأمة عن طريق الانتخاب، وعندما يصبحون ممثلين للأمة، فإن الشعب لا يستطيع عزلهم على الإطلاق.
* النقد الدستوري: يرى الكتاب أن محاولة المشرعين الفرنسيين في المادة الثالثة من الدستور الفرنسي الجمع بين سيادة الأمة وسيادة الشعب هو جمع بين نقيضين، ويعد في الواقع تخلّياً عن نظرية سيادة الأمة. وينتقد الكتاب هذا التفريق، مؤكداً أن القاعدة العقلية تقتضي أن تكون لعامة الشعب صلاحية النصب والعزل والرقابة.
4. إخفاق التجارب السياسية (بما فيها الأحزاب الإسلامية)
يناقش الكتاب إخفاق التجارب السياسية والحزبية في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية عملياً:
* الإخفاق شمل الأحزاب العلمانية والإسلامية على حد سواء في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية.
* يجب أن يكون الهدف هو تطبيق قوانين الإسلام، مثل العدل والإحسان والشورى، حتى داخل الحزب أو النقابة.
* يؤكد الكتاب أن الحكم في الإسلام ليس ديكتاتورياً أبداً، بل هو حكم استشاري.
5. مبررات الاستبداد والشبهة حول الأهلية للديمقراطية
يتطرق الكتاب إلى الحجج التي يستخدمها الحكام المستبدون لتبرير رفضهم للديمقراطية أو الحكم الشوري:
* الشبهة المرفوضة: يدعي المستبدون أن الشعوب غير مهيأة للحكومة الشورية أو الديمقراطية بسبب التخلف السياسي والثقافي.
* الرد على الشبهة: يرى المؤلف أن هذه الحجة واهية وعليلة، وهي خدعة لتبرير السيطرة غير الشرعية. ويشير إلى أن وعي الناس قد ازداد بمرور الزمن نتيجة توفر وسائل المعرفة.
* الحرية تحرر الطاقات: يؤكد الكتاب أن الحريات هي التي تحرر الطاقات وتوفر للكفاءات مناخ الإبداع.
* البرلمان والديمقراطية: في الدول التي تسمى بالديمقراطية، يلاحظ المؤلف وجود مظاهر استبداد، حيث تكون هيمنة الدول على البرلمان شبه تامة، مما يجعل البرلمان شكلياً وخاضعاً لضغط الحكومة.
خلاصة، يرفض الكتاب الديمقراطية بمعناها المطلق لأنها تنكر السيادة الإلهية، ولكنه يقر بحق الانتخاب ويؤكد على أن الإسلام يوفر نظاماً استشارياً أفضل وأكثر تكاملاً يضع العدالة كشرط أساسي للحاكم.
منطق المستبدين، وشرعيتهم الموهومة
يتناول الكتاب مفهوم الاستبداد بشكل واسع، بوصفه المشكلة الجوهرية التي تعيق العلاقة السليمة بين الدولة والشعب وتؤدي إلى سحق الحقوق والحريات. لقد أشار المؤلف إلى طبيعة ومنطق الحكام المستبدين، وأصول شرعيتهم الموهومة، والآليات التي يستخدمونها لفرض سيطرتهم، وكذلك سبل مواجهة هذا الاستبداد.
1. طبيعة ومنطق الحاكم المستبد
الحكام المستبدون هم الطرف الذي يحول العلاقة مع الشعب من علاقة الوكالة أو الإجارة (حيث الحاكم وكيل أو أجير) إلى علاقة الولاية (حيث الحاكم ولي أو سيد).
* منطق المالكية: يرى الكثير من المستبدين والطغاة أنفسهم "مُلاكاً للرعية". يعتبر الحاكم الجائر أن البلد كله ملك له، ويرى الثروات، مثل النفط والمعادن، ملكاً له، ويرى الناس عبيداً له. وقد استُدل على ذلك بمنطق فرعون الذي ادعى الربوبية، واعتبر نفسه مالكاً للمياه والأنهار لتكريس سيطرته الاقتصادية على رقاب الناس.
* منطق القهر والغلبة: المنشأ الثاني لشرعية الحكم لدى المستبدين هو "القهر والغلبة" (حدوثاً أو بقاءً). وهذا المنطق باطل شرعاً وعقلاً وفطرة. يرى المستبد نفسه القاهر الذي لا حق لأحد بمنازعته أو عزل قراراته.
* عقلية الاستعلاء والازدراء: منطق المستبدين عادة هو المنطق الاستعلائي والازدرائي، فهم يزدَرون الناس ويستحقرونهم ويطلبون الكبرياء لأنفسهم وللمتملقين لهم.
* عقلية الترويض والصمت: منطق المستبدين هو منطق "ترويض" الناس، حتى يتعلم كل فرد من أفراد الشعب أن لا يطالب بحقه. الحاكم المستبد وحكومته يقولون للشعب "أصمت".
2. آليات الاستبداد ومصادرة الحقوق
يستخدم الحاكم المستبد سلطاته المطلقة (أو ما يقاربها) في مصادرة الحقوق والسيطرة على مقدرات الناس:
* مصادرة الحقوق الخمسة المطلقة: تتمثل سلطات الحكومات المستبدة في خمسة حقوق تدّعيها لنفسها بشكل مطلق:
1. حق التصرف (بقول مطلق).
2. حق التملك (بقول مطلق)، بما في ذلك الثروات العامة والنفط والمعادن، خلافاً للشرع الذي جعل الأرض لله ولمن عمّرها.
3. حق التقنين (بقول مطلق)، حيث ترى أن لها حق التقنين حتى لو كان البرلمان شكلياً وخاضعاً لضغط الحكومة.
4. حق الإلزام (بقول مطلق).
5. حق الجزاء والعقوبة (بقول مطلق).
* التفرد بالقرار: المشكلة الكلية تكمن في الاستبداد والتفرد باتخاذ القرار ومصادرة الحقوق.
* تحول الخادم إلى سيد: في ظل الاستبداد، تتحول الحكومة من كونها "خادماً" للشعب (حسب الأصل الشرعي والقانوني) إلى أن تكون "السيد" و "المالك" الذي يغصب الدار والبيت، ويسيطر على كل مصير البلاد.
* المال الملكي (أكل أموال الله): المستبدون "يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ". فهم يستأثرون بالسلطة ليأكلوا أموال المسلمين ويعتبرونها حقاً ولقمة سائغة لهم.
3. الجيش كأداة رئيسية للاستبداد
يعتبر الجيش والقوات المسلحة السلاح الأقوى والأشد فتكاً ونفوذاً الذي يعتمد عليه الطاغية لتكريس دعائم استبداده وسلطته غير الشرعية.
* الجيش حصن للحاكم لا للرعية: في الدول المستبدة، الجيش هو حصن للحاكم والحكومة، وليس حصناً للرعية. يستخدمه الحاكم لقمع الشعب أو للعدوان على الدول الأخرى.
* غياب التثقيف الحقوقي: المستبدون لا يضعون تقنيناً قانونياً متكاملاً لضبط الجيش، مما يضمن أن لا يتحول إلى أداة لقمع الشعب.
* رفض الحيادية: الطاغية المستبد لا يريد أن تكون القوات المسلحة حيادية، بل يدعو إلى جذبها إلى السياسة الاستعلائية الفوقية لخدمة الديكتاتورية. وقد نُقل عن أحد قادتهم قوله: "تسعة من عشرة من الشعب لا يريدونني ويكرهونني وهذا لا يهم، المهم أن العاشر هو مسلح يقف إلى جواري".
* نظام المثوبة والعقوبة: إذا كان نظام المثوبات والعقوبات (الرواتب، الترقيات، الإقالات) بيد الحاكم بالكامل، فإن العسكري يتحول إلى عبد مطيع أو تابع، ويكون خضوعه أضعف لاحتمالات العمل بالعدل.
4. تبريرات المستبدين المرفوضة
يناقش الكتاب الشبهة التي يستخدمها المستبدون لتبرير بقائهم في الحكم:
* شبهة عدم الأهلية: يدعي المستبدون أن الشعوب غير مهيأة للحكومة الشورية أو الديمقراطية بسبب التخلف السياسي والثقافي.
* الرد على الشبهة: يصف المؤلف هذه الشبهة بأنها واهية وعليلة، وخدعة لتبرير السيطرة غير الشرعية. ويسأل الكتاب: أين برنامج الحاكم لتهيئة الناس لتقبل الاستشارية والديمقراطية؟. بل يؤكد أن الحريات هي التي تحرر الطاقات وتوفر للكفاءات مناخ الإبداع.
* تهمة الجهل: المستبدون يعتمدون على الجهل السياسي والحقوقي لدى الشعب. ويخططون متعمداً لكي يستمر الناس في عبوديتهم وجهلهم وتهميشهم.
5. عواقب الاستبداد وسبل المواجهة
الاستبداد هو داء عضال أصاب الأمم، وينتج عنه الفقر رغم وفرة الثروات.
* المصير الأسود: الحاكم المستبد يغفل أو يتغافل عن المصير الأسود الذي ينتظره؛ "لأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم". ويشير إلى مصير صدام وحسين مبارك والقذافي وبن علي كشواهد على الذل والعار.
* زيادة الوعي: يرى المؤلف أن الناس قد ازداد وعيهم بسبب توفر وسائل المعرفة (الفضائيات والشبكة العنكبوتية والكتب). وهذا الوعي هو الذي أدى إلى "الربيع العربي".
* المواجهة السلمية: يطالب الكتاب بمواجهة الطغاة والمستبدين بـ "طريقة سلمية"، عبر: الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والإضرابات السلمية، والاعتصامات السلمية، والعصيان المدني السلمي.
* الحل هو العدل والأمانة: إن وعي الناس المتزايد هو السلاح الحقيقي لمواجهة الطغاة، بشرط التمسك بالسبل السلمية. والحل يكمن في تطبيق العدل وأداء.
الخلاصة:
يختتم الكتاب بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو أن يعمل الجميع بالآية الكريمة: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). وأن المشكلة الكلية تكمن في الاستبداد والتفرد باتخاذ القرار ومصادرة الحقوق وخضم أموال الله وأموال الناس. إن وعي الناس المتزايد (أحد أسباب "الربيع العربي") هو السلاح الحقيقي لمواجهة الطغاة، شريطة أن يتمسكوا بالسبل السلمية مثل التظاهرات والإضرابات والعصيان المدني السلمي.


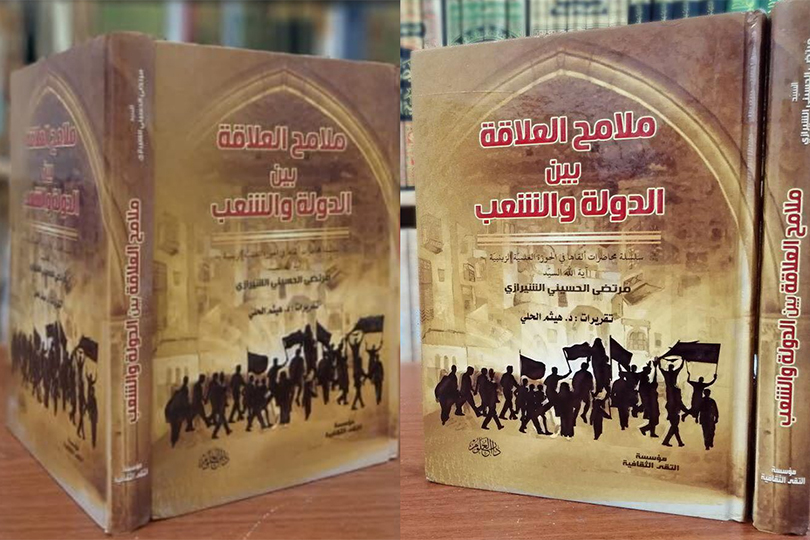

اضف تعليق