|
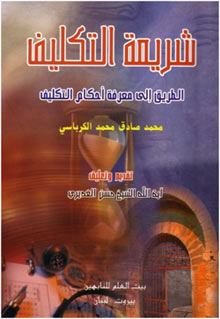
الكتاب: شريعة التكليف..الطريق الى معرفة
أحكام التكليف
المؤلف: آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
الناشر: بيت العلم للنابهين - بيروت
عدد الصفحات: 72 – قطع صغير
عرض: نضير الخزرجي*
شبكة النبأ: ما من إنسان من ذكر أو
أنثى إلا ويقف أمام المرآة قبل ان يعزم على الخروج إلا ما قل، لضمان
تطابق مظهره الخارجي مع ما يرغب الخروج به على الناس، فيحسن من مظهره
ويشذب به، وهي حالة فطرية يتحسسها الإنسان بغض النظر عن ما يحمله من
علم كبر حجمه أو صغر.
وهذا الإنسان إذا ما اعترته مشكلة قانونية في حياته اليومية فانه
يلجأ بصورة طبيعية الى المحامي بوصفه الرجل الواقف على القانون ومداخله
واعرف به، فيضع سره عند رجل القانون ليخرجه مما هو فيه من مشكلة.
وهاتان الصورتان من الممارسة العملية لبني البشر، تشبهان الى حد
كبير تعاطي الإنسان مع ما أملته السماء على المخلوق من عبادات وفق
القاعدة القرآنية: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) سورة الذاريات:
56، فالإنسان البالغ الراشد من الجنسين، كما هو يستخدم المرآة فانه
تواق الى ان تتطابق أعماله من عبادات ومعاملات مع ما جاءت به كتب
السماء بوصفها المرآة الصافية التي تعكس الواقع الشرعي، فيكون من شأن
الإنسان توخي الدقة في التعاطي مع تعاليم السماء أو الاقتراب منها ما
أمكنه ذلك سبيلا.
ومن الطبيعي فان هذا الإنسان لانشغاله بتصريف شؤون حياته الشخصية
والمنزلية والاجتماعية، لا يمكنه الوقوف على تفاصيل وجزئيات تعاليم
السماء، لان الواقفين قلة قليلة، قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين..) سورة التوبة: 122، فلذلك فان حاجته
الى معرفة التعاليم فيما يبتلى به كحاجته الى رجل القانون، ولذلك لا
غنى للبالغ الراشد في معاملاته وعباداته عن رجل الشريعة بوصفه الرجل
الواقف على تفاصيل فقه الدين من معاملات وعبادات، ومن هنا جاء تقليد
عموم الناس للفقيه، لان التكليف يحتم عليهم معرفة الأحكام الشرعية
والاحتكام إليها، والناس في هذه المسألة الحساسة على طبقات فإما ان
يكون الإنسان مجتهدا يلجأ الناس إليه في فتاواهم وهم القلة القليلة،
وإما ان يكون محتاطا بحيث وصل مرحلة من العلم لا يحتاج الى فقيه ويعمل
بما يراه صائبا في مواقع الاجتهاد وهؤلاء في العلماء قلة، وإما ان يكون
من المقلِّدة (بكسر اللام) وهم الكثرة الكثيرة، أو ان يتطابق فعله
التكليفي مع الواقع الشرعي.
هذه المسألة المصيرية في حياة كل إنسان وبخاصة المسلم، يتناولها
الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي في كتاب "شريعة التكليف
.. الطريق الى معرفة أحكام التكليف" الصادر عن بيت العلم للنابهين في
بيروت، في 72 صفحة من القطع الصغير، مع تقديم وتعليق بقلم القاضي آية
الله الشيخ حسن الغديري.
علاقات وأحكام
يرتبط الإنسان وهو في رحم الحياة بمشيمة سداسية الشعب، لا ينفك
عنها، ولكل شعبة قوانينها وأحكامها، ينبغي التعامل معها بما يليق به
كانسان استخلفه الله في الأرض واستأمنه الأمانة التي عجزت عن حملها
السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها، وهذه العلاقات لا تخرج عن واحدة
من ست منفردة أو مجتمعة، كما يؤكد الفقيه الكرباسي: "علاقته بالله جل
وعلا (علاقة المخلوق بالخالق)، وعلاقته بنفسه (العلاقة الذاتية)،
وعلاقته بالفرد الآخر (علاقة النظير بالنظير)، وعلاقته بالمجتمع (علاقة
الأسرة الكبيرة فيما بين أفرادها)، وعلاقته بالدولة (علاقة المحكوم
بمؤسسة الحاكمين)، وعلاقته بكل ما حوله (علاقة الفرد بالبيئة)".
ولا شك ان التوازن بين هذه العلاقات، تقود الفرد والمجتمع الى سلم
الرقي والنهوض المدني والحضاري، وتخلق شبكة من العلاقات الحميمة بين
المجتمعات المدنية بما يخدم الأرض والبشرية ويؤسس لعلاقات طيبة ونهضة
علمية وعمرانية للأجيال القادمة، لان معرفة الأحكام والقوانين في كل
واحدة من هذه العلاقات يمهد الطريق أمام المعرفة الكاملة بالحقوق
والواجبات بما لا يجعل كفة تميل بالضد من الكفة الأخرى، ويجعل الإنسان
كفرد والإنسان كأمة على معرفة تامة بمآلات السماء الراعية لبني البشر
بما فيه خيرهم في الدارين، ويعبّد الطريق أمام قيام دولة العدل الإلهية
الموعودة.
وقياس نجاح الأمة ورجاحة عقول أبنائها تقاس بمدى رعايتها للقوانين
والأحكام التي تبانى على إقامتها وتطبيقها عقلاء الأمة من رجال دين أو
قانون، لان النجاح يساق بالنظام والنظام توأم القانون، بغض النظر عن
طبيعة القانون مدنيا كان أو شرعيا، لان القانون في اصل وضعه يتوسم
مصلحة الإنسان والأمة. والتشريع الأسلم هو الذي يتجرد فيه واضعه عن كل
مصلحة ذاتية، ولا أسلم من التشريع الإسلامي المنزل من رب السماء الذي
خلق عباده ليزرعوا الأرض بالخير ويحصدوا جناته وحياة أبدية لا لغو فيها
ولا نصب.
التكليف والمكلف
ويشكل كتاب "شريعة التكليف" باكورة (سلسلة الشرائع) التي يتولى
الفقيه الكرباسي فيها: "تبيان الأحكام الإسلامية التي كانت ثلة كبيرة
وبالأخص في الغرب بحاجة إليها، بعد ان اختلفت المقاييس، أعني مقاييس
الفهم والوعي، ومقاييس التفهيم، ومقاييس التقبل، الى جانب مقاييس
أخرى"، ولذلك جاء هذا الكتاب والكتب التي ستصدر تباعا ليضع النقاط على
الحروف ويقدم خطوطا عريضة لفهم التكاليف الشرعية، وما أوحى الى الشيخ
الكرباسي هذه السلسلة بعد عقدين من الإقامة في المملكة المتحدة: "عدم
وضوح الكثير من المسائل الإسلامية على عامة الناس من الجنسين وحتى
المتعلمين منهم، وكثرة الأسئلة الواردة علينا من خلال المكالمات
الهاتفية والتي تصب في باب السؤال عن أحكام الإسلام في الموضوعات
المختلفة والمتنوعة". وبخاصة وان هناك مستحدثات ومستجدات في باب الفقه
لا يستطيع الفقيه الجالس في الحواضر العلمية في العراق أو إيران أو مصر
أو الحجاز أو غيرها البت فيها بتمام مسائلها إلا بالوقوف عليها
ودراستها من كل جانب، وهذا لا يكون إلا بالإحاطة الدقيقة كأن ينتقل
الفقهاء الى بلدان المهاجر الغربية أو تمتد جسور المعرفة الفقهية بين
المهاجر والحواضر الفقهية عبر قنوات فاعلة حركية وأمينة، إذ لا يكفى
للوسيط العمة والجبة لتحقيق آلية الوساطة بين الحاضرة الفقهية والمهجر،
إذا لم يحتك الوسيط بالمجتمع الغربي ويقرأ مجريات حوادثه اليومية
(وقليل ما هم!!)، فيكون صادقا وأمينا في نقل الصورة أو المسألة الفقهية
الى الفقيه الجامع لشرائط التقليد حتى يتلقى السائل الجواب الشافي، هذا
إذا انعدم في المهجر الفقيه الجامع للشرائط.
وكما هو سائد في الأعراف القانونية والتشريعية أن التكليف يقع على
البالغ، لان مدار الثواب والعقاب هو الرشد المتعكز على العقل والإدراك،
ثم: "وبالبلوغ تتم عملية التحول الى مرحلة النضج التي يترافق معها
النماء والعطاء"، من هنا كما يقرر الفقيه الكرباسي فان: "التكليف
والبلوغ أمران متوازيان مترابطان، بينما التكليف والعقل أمران مترتبان
متسلسلان، فلا تكليف بدون عقل، بل التكليف يرتبط بالعقل أولا وبالبلوغ
ثانيا".
عقيدة بلا تقليد
وهذا التكليف ليس تحميلا تعجيزيا للبشر بل هو بما ينفعهم في دنياهم
وأخراهم، ولذا فان: "سبل براءة الذمة شرعا وعقلا تنحصر في أربعة طرق:
الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، التطابق"، والتقليد لا يقع في المسائل
العقائدية، لان معرفتها تتم عبر العقل، نعم: "يجوز فهم المسائل
العقائدية عبر التعلّم، ولكن القرار يجب ان يكون معتمدا على استنتاجات
الشخص نفسه، فلا يجوز التقليد – أي مجرد التبعية- في ذلك، لأنه لا يعبر
عن رأيه وقناعاته، كما لا يجوز العمل بالاحتياط، لان مؤاده الشك، ولا
يجوز سلوك غيره من السبل أيضا"، ويعلق الفقيه الغديري على هذه المسألة
بالقول أن: "الجاهل المحض الذي لا يقدر على الاجتهاد ولو بالشكل البسيط
فيعتمد على رأي العالم فيعتبر رأيه رأيه، وقناعته قناعته، ولا يعد ذلك
تقليدا بالمعنى المصطلح عليه"، ولكن لا غنى للآباء من طرق أبواب عقول
أبنائهم في المسائل العقائدية وتحفيزها حتى يلج الجيل الناشئ باحة
المرحلة الجديدة من حياتهم برصيد عال من الثقة والإيمان، ولذلك يعتقد
الفقيه الكرباسي ان: "على الأولياء مناقشة أولادهم في المسائل
العقائدية، ليتمكنوا من اختيار عقيدتهم بأنفسهم، وعليهم مساعدتهم في
النقاش والحوار"، وفي غيرها من المسائل فان: "على الأولياء تمرين
أولادهم قبل البلوغ على القيام بالواجبات، وحثهم على اجتناب المحرمات".
ولما كان البلوغ انتقالة الى مرحلة عمرية متقدمة، ومن اللاأبالية
الى المسؤولية، فان الفقيه الكرباسي يعتبر ان: "الاحتفال بيوم التكليف
جائز، بل لا يبعد استحبابه لما فيه تشجيع للالتزام بالدين، شرط ان لا
يُستخدم فيه المحرمات"، وهذا الفهم المتقدم للشريعة الإسلامية يخالف
البعض من الذين أوقفوا عجلة الشريعة وتحجروا على مقولات بعض السلف ولم
يلحظوا المصلحة العامة ولا تطورات الزمن ولا مقومات المكان والبيئة،
والأخيرة تدخل ضمن علاقة الإنسان بالبيئة والتي يركز عليها الفقيه
الكرباسي لأنها تفتح الكثير من المغاليق الفقهية، لاسيما وان الحكم
الشرعي لا يخرج عن أن يكون واجبا لا مجال لتركه أو حراما لا يجوز
القيام به أو مستحبا يحبب الإتيان به وليس فيه إلزام أو مكروها يحبب
تركه وليس فيه إلزام أو مباحا متروك أمره للمكلف العمل به أو تركه،
وأكثر الأحكام المستجدة تقع في دائرة المباحات أو منطقة الفراغ الفقهي
المتروك أمرها للفقيه البت فيها ضمن سياقات البيئة الزمانية والمكانية،
بناءاً على مرتكزات ومبان فقهية قويمة، على إن للعرف مدخلية كبيرة في
الاجتهاد.
الاجتهاد مسؤولية
يقع الاجتهاد في كل منحى من مناحي الحياة، وهو أمر محبوب في ذاته،
والاختصاص في أية مهنة أو علم يعد واحدا من مصاديق الاجتهاد، لكن
الاجتهاد الفقهي هو المصداق الأكبر للاجتهاد، باعتبار ان الفقه يدخل في
العلاقات الست مدخل الدم في الشرايين، ومؤدى الاجتهاد: "الوصول الى
الأحكام الشرعية عبر الأدلة الشرعية والتي أهمها القرآن الكريم والسنة
الشريفة بشروطها"، وعند الفقيه الكرباسي ان التقليد يقع عند العسر
والحرج، لكون: "الاجتهاد هو الأصل في الوصول الى الأحكام الشرعية، فمن
كان قادراً على الإجتهاد يتعين عليه ذلك"، أي أن الأصل في إبراء الذمة
في أي تكليف شرعي هو الإجتهاد.
ولما كان الاجتهاد صنو المسؤولية، فانه: "لا يحق للمجتهد الذي لم
تتحقق فيه الشروط الأساسية أن يتحمل أية مسؤولية عامة يشترط فيها
الاجتهاد كالقضاء مثلا"، لان الاجتهاد ولو كان جزئيا في المجال الذي
يتولى فيه المسؤولية هي شرط أساس في تولى الأمور العامة التي فيها
مصالح الناس من دماء وأعراض وأموال، وهذا الشرط الذي غاب عن كثير من
أنصاف الفقهاء والمتفيقهين هو الذي جلب ويجلب الدمار الى الشعوب عبر
المحاكم الشرعية غير المنضبطة التي يتولاها صغار طلبة العلوم الدينية
هنا وهناك، وهؤلاء أولى بسوقهم مخفورين الى المحاكم الشرعية المسؤولة
كمدانين وحسب تعبير الفقيه الغديري: "إذا قام بتولّي الأمور من دون
وجدان الشرائط فقد أثم، ويتحمل وزر من يتولّى أمره، ويعاقب بأشد العقاب
لكونه ضالاً ومضلاً".
من هنا يرى الفقيه الكرباسي أن: "مَن ليس أهلاً للفتوى يُحرّم عليه
الإفتاء، بمعنى عدم جواز العمل على تقليده، كما لا يجوز لنفسه العمل
برأيه، أما مجرد إبداء رأيه أو استنتاجاته فلا إشكال فيه"، وهذه مسألة
على جانب كبير من الخطورة، لان البعض من طلبة العلوم الدينية الذي لم
يبلغ الحلم الفقهي أجاز لنفسه الإفتاء وتذييل الفتوى بختمه واسمه
مستغلا جهل السائلين وعواطفهم غير المنضبطة، فاستخف المفتى قومه
فأطاعوه، وبعضهم قفز على سطح المرجعية دون أن يرتقي سلمها بتؤدة،
وبعضهم أعطى لنفسه مكانة قريبة من مكانة الإمام المعصوم، فضاع وأضاع
تابعيه!، ولهذا فعند الكرباسي ان: "العمل بمقتضى فتوى مَن ليس بمجتهد
لا يجوز وباطل"، كما ان: "التحاكم عند غير المجتهد للأخذ برأيه حرام".
وبتقدير الكرباسي ان: "الاجتهاد لا يرتبط بلبس زي خاص، ولا يقيد
بمكان خاص، ولا التخرج من مجمّع دراسي خاص، أو التتلمذ على شخصية
معينة، أو التزود بشهادة معينة"، ولا يعني ترك الأمور سائبة لأن من طرق
إثبات الاجتهاد: "أن يكون الشخص الذي يُراد تقليده يحمل شهادة اجتهاد
من مجتهد جامع للشرائط، مسلّم باجتهاده، شرط أن تكون شهادته عن دراية"،
كما ان الأعم الأغلب يرى شرط الذكورة في الفقيه الجامع لشرائط التقليد،
لكن الفقيه الكرباسي على خلاف ذلك يرى انه: "إذا استوفت المرأة الشروط
السابقة الذكر، ولم تكن مغلوبة على أمرها لا دليل على عدم جواز
تقليدها، وربما اشترطنا ذلك في مقام المرجعية"، ولذلك فان: "المرأة
تقلد المرأة، وفي تقليد الذكور لها ربما قلنا بالاحتياط"، أي بتعبير
الشيخ الغديري: "مستندا الى العرف الخاص، إذ لا دليل يمنع عنه، فمع ذلك
كله فالاحتياط يقتضي تطبيق ما ذهب إليه عرف المتشرعة المستندة الى أصول
قويمة وأدلة سليمة دون الاستحسانات المزعومة".
كما ان المرجعية هي رتبة أعلى من الاجتهاد لتحقق الاجتهاد العام
فيها دون الجزئي، ولكن المرجعية العليا: "تتحقق لمن امتلك الشروط مع
انتخاب الأمة له ولو عبر كثرة المقلدين له، بمعنى أن نسبة المقلدين إذا
كانت أكثر من النصف – بين الشرائح المقلدة عامة – بالنسبة الى المراجع
الآخرين، فيمكن اعتباره المرجع الأعلى". أي أن يكون المرجع الأعلى اعلم
المراجع ولكن مع هذا التقدير فان تحقق الأعلمية أمر في غاية الصعوبة
وهو اقرب للاستحالة، لإمكان تحقق الأعلمية في أكثر من فقيه في أكثر من
مكان وفي زمان واحد، ولهذا فعند الكرباسي: "من الصعب جدا ثبوت أعلمية
مجتهد من بين جميع المجتهدين في كل مكان، بل هو الى الاستحالة أقرب"،
ولذلك فانه يتبنى فكرة إقامة مؤسسة مرجعية لإدارة شؤون المسلمين. على
أن: "التقليد يجب أن لا يخضع للانتماءات القومية أو العرقية أو ما شابه
ذلك"، أي أن: "المرجعية ليست حكرا على قومية معينة" كما هو الحاصل في
بعض المرجعيات في يومنا هذا ومن قبل تقريبا، كما انه: "يجب المحافظة
على استقلالية منصب المرجعية عن الأنظمة، لتكون القرارات الصادرة عنها
حرة ونزيهة، إلا إذا كان النظام خاضعا لفتواه، وهو مرشد له، شرط عدم
التأثير عليه"، باعتبار ان المشار عليهم من أصحاب الاختصاص وأهل الحل
والعقد، كما ان: "على المرجع الاستشارة قبل الإفتاء في الأمور ذات
الطابع الاجتماعي أو الإختصاصي"، كما أن: "المرجعية ليست وراثية" كما
هو الحاصل اليوم عند بعضها، حيث تتوارث المرجعية حتى وان كان المعني لم
يبلغ درجة الاجتهاد ناهيك عن الاجتهاد المطلق الذي يكون فيه مجتهدا في
جميع المباني الفقهية والأصولية والرجالية، وإذا كان التقليد ساحة رحمة
فتحها الله لعباده، فإنها تصبح ساحة لعب ونقمة إذا تحزّب البعض لهذا
الفقيه أو ذاك أو قام بالترويج لهذه المرجعية أو تلك بالأساليب البعيدة
عن التقوى وتزكية النفس، وهو ما وقع ويقع في كل مرحلة بخاصة إذا مات
مرجع يشار له بالبنان، فيصادر من الأمة رأيها وعزمها ويخضعها لمؤثرات
قد تبتعد عن الواقع الفقهي.
في حقيقة الأمر ان التكليف تشريعيا على قدر كبير من الخطورة
والأهمية، كونه آلية حتمية لتنظيم عمل الإنسان، وبما يحقق الانسجام
التام بين العلاقات الست التي يتبنى الفقيه الكرباسي تأطير تشريعاتها
لصالح مجموع البشرية.
*إعلامي وباحث عراقي
الرأي الآخر للدراسات – لندن
alrayalakhar@hotmail.co.uk |
