|
د. غالب الشابندر |
|
(1) |
|
لا تكتمل نهضة الأمة المسلمة إذا لم تنهض المرأة، ليس لأن المرأة نصف المجتمع كما اعتاد القول جملة من المفكرين، بل لأن المرأة منبت الوجود الإنساني وجوهر الذات البشرية في مستودع التكوين الآدمي، تزوده بأسباب البقاء والنماء والاستمرار وبالتالي هي سرّ الصيرورة والحركة والتكوّن، فالمرأة - إذن - ليست حدثاً أو فقرة عابرة في تقرير التاريخ، تتصل بها الحياة وتتصل بالحياة على نحو جدلي نشط ومصيري. ومن هنا لا نستغرب أن تكون كلمة (الأم) ذات أصالة مرجعية نهائية، وكأنها منبع التعليل والتفسير، والأم امرأة قد اكتمل أداؤها الرسالي العظيم من مسيرة الحياة.. ولكن المسألة الأهم التي ينبغي أن يدور حولها الحديث، هو مضمون هذا النهوض وهويته، أو فلسفته بشكل عام، وفي تصوري أن نهوض المرأة يتجسد أولاً وقبل كل شيء بتحريرها من أوهام النظرة المبتسرة والزاوية الضيقة؛ فهي ليست لعبة مؤقتة مرهونة بأداء وظيفة حسية، ومن ثم تلقى على قارعة الطريق كأي سلعة انتهى وقتها ودورها، وأكبر دليل على ذلك أنها المعادل الموضوعي للطرف الثاني من معادلة النشأة الإنسانية (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا..) ، فهذا التعادل يؤكد أن كلاً من الرجل والمرأة سبب جوهري في إبداع الإنسان وكينونته، وبهذا فإن كلاً منهما يمثل مكانة توازي نظيرها، وتساوي قيمتها؛ فلا زيادة هنا ونقيصة هناك، وإلا لما جاء الخطاب القرآني بهذه الصيغة المتوازية والمتكاملة. |
|
(2) |
|
|
|
(3) |
|
ولكن ما هو موقع الدرجة في هذا البيان، وفي تصوري أن (الدرجة) هنا هي زيادة في مسؤولية الرجل إزاء المرأة؛ إنها ليست منزلة تفوقية، ليست مرتبة زائدة، لأنهما قسيمان متوازيان لمقسم واحد هو الإنسان، والدرجة لا تعبر عن إمرة أو طاعة أو ميراث أو جهاد، كما قال بعض المفسرين، بل هي ممارسة أخلاقية يقوم بها الرجل إزاء المرأة تتمثل في صفحه وتغاضيه عما يبدر من زوجته إزاء حقوقه عليها؛ وهكذا فإن جو الآية يدور حول التكافل العملي المتبادل، الذي من شأنه استقرار الحياة الزوجية وسيادة الأمن والاطمئنان فيها، وهذا ما التفت إليه ابن عباس في تفسيره لهذه الآية الشريفة، وهذا ضروري نظراً لما تبذله المرأة من جهد نفسي عظيم لتكون سكناً، فإن هذا السكن ليس عطاءً معنوياً، يتأتى من دون مبادرة تصدر عن المرأة، وإلا كم امرأة تتحول إلى جحيم، فالدرجة لا تعني امتيازاً خلقياً ولا تشير إلى امتياز حقوقي، بل هي تعبير عن إلزام موجه إلى الرجل، يتوجب عليه بحكمه أن يكون واسع الصدر إزاء أي تقصير من الزوجة، وهذا الشعور ينبغي أن ينبع من وعي بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في حياة الرجل.. حيث ينبغي أن تكون الحاضن الذي يعيده إلى هويته الإنسانية وفضله الرجولي. إن فضل الرجولة يفتقر إلى هذا السكن وإن (اللام) في قوله تعالى (لتسكنوا) تحقق غاية كونية، تتصل بعمق التكوين الذاتي للرجل، إنه ليس احتضاناً حسياً أو بيولوجياً، بل هو احتضان حياة، إنها تستقبله كملجأ روحي وعاطفي وجسدي فيشعر بالراحة بعد النصب، وبالقوة بعد الضعف، وبالأصالة بعد الضياع، وبالأمن بعد الخوف، وما على الزوج إلا أن يقارن بين حالته وهو في السوق أو الدائرة أو المعمل وبين حالته وهو يلتقي زوجته!.. |
|
(4) |
|
قال الله تعالى: (الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (القيمومة) هنا حكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء من الجهات العامة؛ كالحكومة والقضاء والدفاع وغيرها، وبالتالي فهي - أي القيمومة - ليست في دائرة العلاقة الزوجية وما يضبطها من حقوق وواجبات، وتكاد تؤسس لقاعدة الولاية على التصرف، في حين أن القيمومة في النص ومن خلال الروح العامة للسياق تؤكد وتجذر واجبات الرجل أو بالأحرى الزوج إزاء زوجته، فهي خاصة في دائرة الزوجية، والمعنى العام أن الزوج قيّم على الزوجة بما يجب عليه من إنفاق ورعاية وإحاطة؛ فكم هو الفارق بين المعنيين؟!. فالرجل قيم على امرأته، أي متكفل بشؤونها الاقتصادية والرعوية، وبهذا فإن الآية الشريفة هنا توسع من مسؤولية الرجل قبال زوجته، وليست القيمومة عبارة عن سلطنة أو قهر أو قيادة، بدليل أن من حق المرأة أن تشتغل اقتصادياً، ومن حقها أن يكون لها رأيها الخاص في الأمور الدينية والسياسية، ولا يجب عليها شيء من أمور البيت كالطبخ والكنس والرضاعة إلا عن رضاها وقناعتها، وتبقى مسألة الحكم قضية مطروحة للنقاش في دوائر الفكر الإسلامي المعاصر ولا مجال للتفصيل في هذه القضية الآن. إن القيمومة - إذن - مسؤولية، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن أو بخلاف ما هو شائع في الأوساط العامة. |
|
(5) |
|
انحصر حق الرجل على المرأة بموضوعين أساسيين: الأول: الاستمتاع. الثاني: المساكنة. وكلا الحقين خاضعان لضوابط شرعية مرنة، فالاستمتاع ليس إشادة واستجابة، بل هو ممارسة محكومة بشروط وواجبات، والفكر الإسلامي الحديث لا يجعل الاستمتاع حقاً محصوراً بالإرادة الذكورية؛ فإن الشهوة ليست خاصية ذكورية وحسب، بل خاصية إنسانية موجودة لدى الطرفين، والعقد إنما هو عقد نكاح بين الطرفين، والإيجاب والقبول قائم على سراية هذا الحق لدى الزوج والزوجة، وبالتالي على الرجل أن يراعي هذا الحق بمزيد من العناية والرعاية، وإلا فإنه يظلم المرأة. إن حصر هذا الحق بطرف واحد، وحصر الاستجابة بالمرأة على نحو أحادي صارم، يصادر الطبيعة، ويضيق من نطاق الحقيقة، وإن مثل هذا الموقف، يجعل من المرأة محط انصباب وتلقي موقوت، في حين أن المرأة كالرجل مخلوق مفطور على الرغبة الجنسية، أي إنها تطلبها وتسعى إليها وتعمل على تحصيلها؛ فليس قبل من المعقول مع كل هذا أن يكون حق الاستمتاع محصوراً بالرجل وحسب؟! فيما أن الإسلام قائم على الفطرة؟! بل هو دين الفطرة أساساً. إن حق الاستمتاع مشترك، وأعتقد أن الثقافة الإسلامية تعلمنا مبدأ التفاهم المتبادل في توزيع أو إشباع هذا الحق من كلا الطرفين لكلا الطرفين، بطريقة حضارية راقية، تعتمد الفهم العميق للحاجات الإنسانية، وتتوسل بأرقى الأساليب لتوفير الاستمتاع الحيوي لطرفي المعادلة. والمساكنة - في جوهرها - حق أسري قبل أن يكون حقاً للزوج على نحو الإطلاق، وهو ليس لضمان حق الاستمتاع، بل هو فرع من غاية أرفع وأشمل، تلك هي تكوين أسرة مستقرة يسودها التفاهم والتواد. إن حق المساكنة لا يعني الحجر البيتي القاتل، لأن المرأة لم تخلق للبيت بل خلقت للحياة، والحياة أوسع مفهوماً من (البيت) بالمعنى التقليدي، ومن ذا الذي يقول أن البيت وحده كاف لتحقيق الذات الأنثوية، إن الحياة هي التي تفيض على المرأة حيويتها الأنثوية الحقيقية؛ أي البيت والعمل والشراكة السياسية والاجتماعية والمواصلة مع الآخر؛ ولذلك فإن حق المساكنة هنا يلاحظ فيه مقدار الحاجة إلى إدارة شؤون الأسرة، ومن ضمنها موضوع الاستجابة، على أن من غير الطبيعي أن نتصور بأن حق الاستمتاع الذكوري سلطة قائمة مع الزمن، فهذا غير معقول أبداً، وهو حق متوقف على دواعيه التي تخضع لضرورات الزمان والمكان والظروف الاقتصادية والسياسية. إن حق (الاستمتاع - المساكنة) مركب شامل معقد، اشتركت فيه العوامل البيولوجية والنفسية والاقتصادية، ومن الضروري أن يخضع لتفاهم مشترك. |
|
(6) |
|
أعود فأقول، إن هذه التوضيحات إنما هي من أجل النهوض بالمرأة؛ لأن المجتمع الإسلامي يبقى عاطلاً إذا لم تدخل المرأة ساحة المعركة الحضارية القاسية التي تمر بها هذه الأيام، ولقد كانت المرأة المسلمة في أوائل عهدها متحركة فاعلة؛ فهي تقاتل وتخطب وتجادل، بل أكثر من هذا فقد كانت تطالب بحقوقها الجنسية الصرفة من خلال حواراتها العميقة مع الحكام والقضاة والأزواج، ويحفظ لنا التاريخ العديد من الحوارات الرائعة بين النساء والنبي(ص). إن الحديث الصريح المحكوم بقيم الشريعة ومُثل العقل السليم بين المرأة والرجل في شؤون الجنس والزواج لا غبار عليه، خاصة بعد أن أصبحت الثقافة الجنسية شائعة في الكتب والدوريات والفضائيات، إلا أن بعض فقرات هذه الثقافة ساقطة وتافهة؛ لأنها تتعرض لأمور خارج دائرة الحاجة المنطقية، وأعتقد أن من يقرأ أحكام الشرع الحنيف في قضايا الجنس سوف يندهش لصراحتها العفيفة ووضوحها المنضبط بالقيم، ومن هنا يمكن أن نستدل على عبقرية الشريعة المقدسة. |
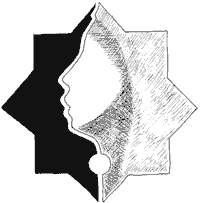 وأعتقد أن هذا التعادل والتكافؤ في صيرورة
المخلوق الإنساني، بين المرأة والرجل، هو السر الذي يكمن وراء قوله تعالى:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) فإن
الآية الكريمة تجعل من (المعروف) مقياساً للتعامل الرجالي مع المرأة،
والمعروف هنا ليس منّة أو صدقة، بل هو مجموعة قيم خلقية تتمثل بالحب والتسامح
والاحترام والمشاورة، مع العلم أن جهة التكليف هنا هو (الزوج)، وفي الحقيقة
أن هذه المفارقة تدعو إلى التساؤل؛ إذ ما هو السبب في هذا التكليف المسمى
صراحة وبهذا الوضوح؟، أعتقد أن المرأة ليست معادلاً موضوعياً للرجل في صيرورة
الخلق الإنساني فحسب، بل لأنها إضافة إلى ذلك (الحاضن) الطبيعي للرجل يجد في
حنايا المرأة ذاته البعيدة، بل يستعيد من خلال هذه الحنايا ذاته المفقودة في
زحمة الحياة القاسية (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
إليها)، (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها.. )، ربما
السكن في الآية هو عودة إلى الذات الأولى، واسترداد ما فقده الزوج من إحساس
بالوجود؛ هذا الإحساس الذي قد يتبلّد أو يتصدع أو يغفو نتيجة الانصهار بعالم
المادة والصراع والعراك، إذا لم يصبه العطب، فإن (السكن) المذكور في الآية
يصعّد من هذا الإحساس ويوتر مسؤوليته، وبالتالي يشعر الزوج بأنه رجل حقاً!!
وللأسف الشديد لقد فسر هذا السكن بمفاهيم عاطفية ساذجة، أو أعطي مداليل
الراحة النفسية المجردة، فيما هو (عودة) إلى الذات أو تصعيد لعنوانها
الإنساني.
وأعتقد أن هذا التعادل والتكافؤ في صيرورة
المخلوق الإنساني، بين المرأة والرجل، هو السر الذي يكمن وراء قوله تعالى:
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) فإن
الآية الكريمة تجعل من (المعروف) مقياساً للتعامل الرجالي مع المرأة،
والمعروف هنا ليس منّة أو صدقة، بل هو مجموعة قيم خلقية تتمثل بالحب والتسامح
والاحترام والمشاورة، مع العلم أن جهة التكليف هنا هو (الزوج)، وفي الحقيقة
أن هذه المفارقة تدعو إلى التساؤل؛ إذ ما هو السبب في هذا التكليف المسمى
صراحة وبهذا الوضوح؟، أعتقد أن المرأة ليست معادلاً موضوعياً للرجل في صيرورة
الخلق الإنساني فحسب، بل لأنها إضافة إلى ذلك (الحاضن) الطبيعي للرجل يجد في
حنايا المرأة ذاته البعيدة، بل يستعيد من خلال هذه الحنايا ذاته المفقودة في
زحمة الحياة القاسية (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
إليها)، (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها.. )، ربما
السكن في الآية هو عودة إلى الذات الأولى، واسترداد ما فقده الزوج من إحساس
بالوجود؛ هذا الإحساس الذي قد يتبلّد أو يتصدع أو يغفو نتيجة الانصهار بعالم
المادة والصراع والعراك، إذا لم يصبه العطب، فإن (السكن) المذكور في الآية
يصعّد من هذا الإحساس ويوتر مسؤوليته، وبالتالي يشعر الزوج بأنه رجل حقاً!!
وللأسف الشديد لقد فسر هذا السكن بمفاهيم عاطفية ساذجة، أو أعطي مداليل
الراحة النفسية المجردة، فيما هو (عودة) إلى الذات أو تصعيد لعنوانها
الإنساني.