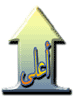|
أحمــد البــدوي |
|
في سياق بحثه في النظريات السياسية للتيارات الشيعية الراديكالية في القرن العشرين. أشار الباحث فالح عبد الجبار في دراسته المنشورة بالعنوان أعلاه في العدد (296) من مجلة الثقافة الجديدة، إلى مسائل ملحّة في الأفق السياسي التنظيري (الفكر السياسي) ونسب كثير منها إلى هذه التيارات، سيما أنها - السلطة، الانتخابات، التشريع - مسائل تمتلك مفاهيم ولوازم معرفية فضفاضة.. في أبعادها ومداخلها، وتوجهاتها لارتباطها بفكرة الحق ومسارها في الناظم الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من سحبها إلى عناوين سلبية وتُهم، هيِّن إلى أبعد حد. هو مشهود في مشكلات المنهج لدراسة هكذا مسائل، فهو لم يحدد الإطار (الجامع المانع) لهذه المسائل في جهاتها المتعددة، كما أنه سار بمرجعيات معرفية (قبليات أو مسبقات) جعلها وكأنها الأسس الأولى للمعرفة في حيز التسالم. بينما من دواعي المنهج القويم هو الغور والرجوع إلى الأسس المؤسسة للمسألة ودراستها ووضعها في نظرية المعرفة، أو أقلّها ذكر تفاوت المدارس في الرؤية، وليس جعلها الإتكاء المعرفي الوحيد، وهو ما يمكن توجيهه بـ(اللاشعور المعرفي) لدى الباحث في مرجعياته، بما أثير في إشكاليات المنهج أو بما يسميه الدكتور عبد الوهاب المسيري بـ(فقه التحيّز) أو بما أُثير في الايبستمولوجيا المعاصرة في فلسفة العلم ومسألة تدخل المرجعيات - لا شعوراً - في المسألة المعرفية بما أستفيد به من علم النفس التحليلي بما اضفاه الإيبستمولوجي الفرنسي (غاستون باشلار) وكذا بعلم النفس التركيبي كما في رؤى (جان بياجيه)، وذلك بتدخل النوازع الإيديولوجية القابعة في الذهن من أثر الوسط والمحيط المدرسي على الأطروحات؛ فيكون المدار المعرفي ذا وظيفة إيديولوجية وليس معرفية محضة. حينما يمرّ فالح عبد الجبار على الأفق الشيعي السياسي يخلي هذا الفكر من مسائل فصل السلطات أو البرلمان أو الانتخابات، أو التشريع البشري ويعتبرها - بدلالات السياق - من معيبات هذا الفكر قياساً على مرجعياته، وكأنّ هذه المسائل أمور تمثل (الضرورات المنطقية) للفكر البشري في بعده الحقوقي، ولا يختلف فيها اثنان من العقلاء، مع إن الاحتدامات التي تتناجزها العقول والثورات منذ أن دبّت إلى يوم الناس هذا، وهي في سجال، سيما في القرن الثامن عشر حتى نهايات القرن العشرين، أي منذ عصر الإيديولوجيات والثورات، ومسائل السلطة والعقد الاجتماعي، والحريات، واختيار الحاكم،... الخ، وهي تتطوح يمنة ويسرة في أذهان مفكري هذه القرون وعقولها. ونحسن الظن بالباحث في نسبته تلك، ونفترض أنه غير مطلع وليس مغرضاً، إلا أن بعضها يعتبر من الأدبيات الحديثة للفكر الإسلامي الشيعي، من قبيل السلطات الثلاث والبرلمان، والانتخابات والشورى. وبعد من التشريع البشري بالمعنى الدنيوي.. في التوجيه الاختصاصي بما يطرحه الإسلام من مفهوم الكفاءة، وقلنا الإشكالية في فضفاضية ومطاطية هذه المصطلحات بما لا تمسكه اليد إذا وضعت إطلاقاً، كما وسمت بالراديكالية، بينما يمكن أن نجد عقلانية تامة في الانفتاح على موضوعيات العصر واقتضاءاته العلمية، كما إن (المحافظ) بما يثيره مصطلح الراديكالية، ليس دائماً يجر وراءه بُعدي (التحجّر والجمود) بقدر ما يدل على ارتباط بمبدأ عقلاني تُفرّغ من نطاقه العلمي، والتزام لأسس ثابتة انتهي من حجيتها الصلاحية بما سيأتي في فلسفة الثابت ومفهوم الخاتمية. لا بأس أن نخوض في عمق الأدبيات الإسلامية لفقيه وصاحب تيار أخذ حصته من هذا الاتهام، وسنركز على الحيثيات العقلانية وآلياتها التي يتمثلها الاجتهاد الإسلامي، وموضوعيته، وواقعيته، سيما في كلياته، التي تمثل قوانين يحيطها إطار العقلانية والموضوعية والفلسفية، ولو في البعد الحِكمي - كقيمة حاكمة - في أنها تغطي المفردات والجزئيات، وهذا ما يوجه (المحافظة) الموسومة بالراديكالية، للوجه الإيجابي لها. في كتابه (الدولة الإسلامية) الجزء 101 من موسوعة الفقه، يناقش الإمام الشيرازي - اجتهادياً - موضوع السلطات الثلاث حيث يقول: (لو فرض وجود صيغتين صالحتين للحكم أحدهما السلطات الثلاث والأخرى غيرها كان للحاكم في عدم صورة الشرط عليه اختيار أيهما شاء، كما أنه لو فرض وجود صيغة واحدة صالحة - ويلاحظ هنا مناط المصلحة وأسها العقلاني المتسالم به عند الحقوقيين الأكاديميين - غير السلطات الثلاث حتى أن السلطات الثلاث تعد غير صالحة في قبال تلك الصيغة الجديدة يكون الواجب على الحاكم اتباع تلك الصيغة)(1)، ويمكن النظر هنا بعيداً عن الراديكالية بمعناها السلبي، وذلك في توجيه مسألة السلطة على أساس مبدأ المصلحة - وهو مبدأ فطري أولي - في البعد العقلاني للسلطة سواء بالتوجه الغربي في السلطات الثلاث أو غيرها. ولا يقف الإمام عند هذا بل يحاجج فقهياً في جواز صيغة السلطات الثلاث مع أنها غير موجودة في عصر المعصوم (وهذه لمحة كانت تقتضي إن كانوا راديكاليين أن يتجمدوا على الوجه القديم) فهو يضع فرضاً في محاججة أحدهم فيجعل للمحاجج اعتراضاً يقول فيه: (لم يكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي(عليه السلام) السلطات الثلاث فمن أين تقولون بها، وعليه يكفي للحاكم الإسلامي واحداً كان أو مجلساً أن ينصب بنفسه شخصاً وزيراً للقضاء، وشخصاً آخراً وزيراً للإجراء، وشخصاً ثالثاً وزيراً للتطبيقات، كرئيس مجلس الأمة، وحكم واحد من الثلاثة يجعل الأفراد صالحين للأمور الثلاثة، كما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) بأنفسهم يعينون القضاة، ورؤساء الجيش، وعمال الصدقات، وأمراء العشائر لإدارة العشائر، وأمراء البلاد، كما يجده من أراد في التواريخ والروايات والتفاسير(2). كل هذه المحاججات يعرضها الإمام على نفسه حتى لا يصادر ويحاول أن يعرض بعض الآفاق المعرفية إزاء الفكرة.. بل يضيف عليها معارضة (للسلطات الثلاث) قبل أن يجيب فيقول مشيراً إلى أفق الاعتراض، مثلاً أحدهم يعترض: (إذا أردنا إرجاع الإسلام فيجب أن نعمل كما كان يعمل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)أو خلفاؤه وهم لم يكونوا يعملون إلا كما ذكر في السيرة الشريفة لهم، فعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) في أيام الأولين القصيرة وعمل الحسين (عليه السلام) في الساحة المحدودة بين المدينة وكربلاء بعد موت معاوية لم تكن إلا كما عملها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)فمن أين لكم بالسلطات الثلاث؟) (3). فيجيب الإمام الشيرازي عارضاً الأفق المنهجي للاجتهاد في الفكر الإسلامي بكل موضوعيته بما ينشره هنا وهناك من آليات في العقلانية الإسلامية، يقول الإمام مجيباً: (كان للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في جملة شؤونه الكثيرة، تطبيقات حسب الظروف،وتلك يجب أن تكون في كل ظرف حسب ذلك الظرف؛ فإنه معنى كونه أسوة لا الموافقة حرفياً، فإنها خلاف الأسوة حسب ما يتلقاه العرف من هذه الكلمة) (4). ويمكن انتزاع حدود المنهج هنا والآليات الموضوعية للتأصيل في الاجتهاد الإسلامي، فبعد (الظرف) وفلسفته في الأحكام وتغيراتها، في عدم الجمود والتوقف على نفس التطبيقات السالفة - في أنه إجراء وتنزيل لقيمة شرعية كانت لها حيثياتها وهي بالتأكيد دخول في فلسفة (الثابت والمتغير) في الشريعة - (فأين هي الراديكالية أو أقلها.. أين نفي السلطات الثلاث) - كذلك تحليله بعد (الأسوة) بين (الموافقة الحرفية) و(الجوهرية)، وهو بالتأكيد واضح جداً في توجيه صارمية الآليات في الاجتهاد الإسلامي، وعلمية منهجه الإجرائي. ويوضح ذلك في أمثلة ترفع اللبس مدافعاً عن اجتهاد التغيير في التطبيق - مثلاً -: (أمر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أسامة لأنه رآه صالحاً للإمارة، فإذا مضى على عمر أسامة مائة سنة واتفقت حرب فهل نؤمر أسامة غير الصالح لشيخوخته، أو نؤمر من هو بمنزلة أسامة في صلاحيته، إن الأسوة تقتضي الثاني، أما الأول فخلاف الأسوة) (5)، ويمكن ملاحظة المنهج الاستدلالي في بعده الموضوعي العلمي.. يقول: (فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنه لجدير بالإمارة، ليس معناه إلا بشرط الموضوع، فإذا انتفى الموضوع، انتفت الجدارة منه شخصاً، وإن بقي الملاك في لزوم جعل الجدير) (6) ، فليست القيادة مناطة به كشخص، وإنما كإطار للمصداق وكمناط وملاك.. (كذلك لا يجب تأميره خاصاً إذا بقي على الصلاح، وكان هناك صالح آخر في عرضه، أو كان أصلح منه، فإنه في الأول يختار الحاكم أيهما شاء، لأن الملاك فيهما موجود، ولا خصوصية لأسامة، وفي الثاني يختار الثاني لفرض أنه أصلح، فهو مثل قوله: الخيل معقود بنواصيها الخير، والجنة تحت ظلال السيوف، فإنه إذا تبدّل الخيل والسيف إلى الدبابة والبندقية، كانت الأسوة فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) باتخاذهما) (7). فيمكن من هذا الطرح استلال آليات منطقية منهجية تحاكم بعيداً عن أي جمود وتحجر يملكهما مصطلح (الراديكالية)، في الرجوع إلى النص والتوقف على حرفيته، أي التقليد المفرط للنص دون إعمال العقل كما هو سير المنهج المدرسي الكنيسي في القرون الوسطى وما بعدها. فنجد في معالجات الإمام الشيرازي إشارات علمية، في شرطية الموضوع لا الشخص في منجزية الحكم، وفلسفة الملاك (الجدارة هنا) في انتقاليته وتبعية صلاحية القيادة به، كذلك قاعدة الأهم والمهم في الصالح والأصلح، وهي قاعدة عقلائية محضة، يرجع بها إلى سيرة العقلاء والمنطق القبلي في أولياته وضرورياته، ثم يحاول أن يبلور المنهج المُطْرَق في نقل المصاديق (لتوليد الحجة في التعامل مع مسألة السلطات الثلاث) فيقول: (والحاصل؛ المعيار الصلاحية الجهوية لا الشخصية، لذا لم يستشكل الفقهاء (من الأشكال الإدارية الحديثة)، في نصب الإذاعات المرئية، وجعل أنظمة للشرطة والمرور، والنجدة و...، بل يجدون كل هذه الأمور من صغريات الكليات الإسلامية المنطبقة عليها حسب الزمان، وإن لم تكن أيّها في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ) (8) . إذن لا انغلاق ولا رفض للأنماط الحديثة، فالأمر يوجه معرفياً وليس كمسألة انتماء أو ظاهرة آبائية في التحجر على نمط القرون البالية،حتى يمكن النيل من أفق التيارات الشيعية بأنها راديكالية في الوجه السلبي، فجملة الإمام الشيرازي في كون القضية هي الصلاحية الجهوية وليس الشخصية توجه عملية ديمومة الشريعة واستمرارها مع الأنساق المختلفة في الحياة تقادماً مع الزمن،سيما مع فكرة الصغرى والكبرى (حسب الاصطلاح المنطقي) في أن الشريعة أعطت كليات (كبرى) يمكن أن تجد نفسها في كل زمان ومكان، ومن هنا تأتي فلسفة الخاتمية لو أُريد نقاشها.. لأنها قائمة على أساس هذا البعد في أن الكليات يمكن أن تمثل لكل مفارق الحياة بكل زمكانيتها بعملية التفريع وإنزال المصاديق. أما قضية الانتخابات فيمكن أن يجد فالح عبد الجبار مظانّها هنا أيضاً. ولننتقل بادئ ذي بدء إلى نص الإمام الشيرازي في توجيه ذلك، يقول: (إذا فوضت الأمة (الشعب) أمر اختيار القوى الثلاث إلى أيدي أولئك الفقهاء (شوراهم) أو الفقيه (المنحصر فيه أو المنتخب بما يوضحه السياق السابق) (9) الواحد فهو، وإلا كما هو الحال الحاضر، فإن الأمة تنتخب مرة ثانية نواب المجلس التطبيقي، والذي يسمى في الديمقراطية بالمجلس التشريعي ويكونوا هم للمشاورة، أي تطبيق الكليات الشرعية الفقهية التي استنبطها مجلس المراجع على الموارد الخارجية المقررة، حيث أن الحكم ليس إلا لله تعالى، ويستنبطه الفقهاء من الأدلة الأربعة، كما أنه بالتعاون بين مجلس الفقهاء ومجلس الأمة تتولد القوتان الأخريان، أي القضائية والتنفيذية، وكل قوة من هذه القوى الثلاث تشمل القوى الأخرى أيضاً، فالتطبيقية تعم بتطبيقاتها القضاة، والقوة المجرية بكامل وزرائها) (10)، ويمكن إيجاد لمحة أخرى في الانتخابات بما يعرضه في أفق تعين رئاسة الجمهورية؛ يقول: (وإن صلح جعل الرئيس لها، إذا أرادته الأمة ومجلس الفقهاء (...) فقد يناط انتخابه بأكثرية مجلس الأمة ومجلس الفقهاء، وقد يناط جعله بانتخاب نفس الأمة له) (11) ، فالأمر منحصر إما بانتخاب الأمة مباشرة بنفسها أو بانتخاب مجلس الأمة.. وهو أصلاً منتخب من الأمة وكذلك مجلس الفقهاء.. سيما أن الفقهاء مقلّدون اختياراً حسب الشروط الفقهية، فالنتيجة أن الأمة هي ذات الشأن الأساس وليست معزولة عن الأفق السياسي، كما يُستشف من كلام الباحث. إذن النص واضح في انتخاب الأمة مرة للمرجع إذا لم ينحصر، وحتى إذا انحصر، ولم يكن ضمن الشروط والمميزات الموضوعة إسلامياً فليس له، كما للأمة انتخاب مجلس الأمة. أيضا لو عدنا إلى مسألة فصل السلطات (الزمنية والروحية)، فكذلك وجدنا الباحث يمر - على خلو التيار الإسلامي منها - مرَّ المعيب دون نقاش أحقية وصلاحية هذا النظام السياسي (نظام الفصل)، مع ذلك - كما قلنا أن هذه المسائل فضفاضة جداً - فالبحث العلمي يقتضي مراجعات أسس الخلاف بين النظام العلماني والإسلامي، فالباحث ينطلق من وجه علماني، أي يتعامل مع سلطة المرجعية الفكرية التي يتبناها، مما يجعله يقفز على الأسس، وهو خلاف المنهج العلمي، كون الآخر لا يتسق معك في نظرية المعرفة، فالنقاش تحتي وليس فوقي، وقد أُسهب به كثيراً منذ بدايات القرن العشرين، سيما مع حركات الاستقلال في الشرق، وانشطار النخب في ذلك، وتكفي نكسات أطروحاتهم في الواقع وأزماتها المحصاة في ذلك، بل إن عمق المسألة عمق تراثي بالنسبة للأطروحة الإسلامية أي أُصل لها منذ (14) قرناً في بعد سماوية الدستور بما يضعه الإيمان بالعقيدة الذي أسسته العلوم العقلية قبل النقلية (= علم الكلام) أما الأطروحات العلمانية فهي لم تحتك بذلك احتكاكاً كافياً إلا بعد عصر الأيديولوجيات في القرن الثامن عشر مع تحولات عصر النهضة سيما مع الثورة الفرنسية. كما يمكن عمل بحث مقارن بين المنهجين في الحكم القائم على فصل السلطات، والمدمج لهما، واستخدام قاعدة الأصلح، فالحاكم الإسلامي مقيد بدستور من صنع غيره، والحاكم العلماني يتحرك في إطار دستور، تدخّل بنفسه في فقراته أو تدخل حزبه بذلك. الحاكم الإسلامي مقيد بشروط ومميزات شخصية ثقيلة صارمة تضعه في حد الكفاءة، وهذا يأخذ بنا إلى ما هو مطروح من قبل الفلاسفة، سيما المعاصرين - في حكم الأكفاء - وهي فكرة عقلائية محضة بينما لا يبتنى على هذا التوجه من قبل النظام العلماني، فقد تجده ذا شخصية خارجة عن إنسانيتها أصلاً (كما يعرف لاحقاً عنهم في مذكراتهم أو مذكرات غيرهم أو بما كتب عنهم من فضائح) والأمر يستدعي طرحاً غزيراً ليس محله هنا. وعين مسألة فصل السلطات تقوم على إشكالية التشريع بين البشري والسماوي.. بما أثاره أيضا الباحث عبد الجبار وهذا الكلام يجر إلى آفاق عدم قدرة الشريعة الدينية على توجيه دفة الحياة لأنها - حسب رؤيتهم - ليس لديها نظام شامل يمكن أن يغطي المجتمع، ولا أدري هل الباحث لم يقرأ كل الأطروحات التي وضحت القانون الإسلامي، والصيحات والبحوث الغربية التي أكدت كفاءة التشريع الإسلامي السماوي، كما أن هناك بعداً مهماً يجب توضيحه قد يكون في حساب التهمة من قبل الباحث عبد الجبار لما تملكه هذه المسائل من فضفاضية. فاندماج السلطة الزمنية مع الروحية، بوجود التشريع السماوي، لا يعني طرد الناس ومنعهم عن حركتهم الإبداعية في الحياة.. بحيث يتدخل الحاكم في أمور المهندس والطبيب.. أبداً هذا يرفضه العقل السليم بل في صلب الفكر الإسلامي توجد مناطات لهكذا مسائل وقواعد تؤسس لهكذا مرقى، فالآية: (اسألوا أهل الذكر..) التي أُطرت بقاعدة (الرجوع إلى أهل الخبرة) تجد الحاكم الإسلامي معها، يستشير بنفسه كل إنسان في اختصاصه؛ السياسي، العسكري، الاقتصادي، الاجتماعي، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بفقه الواقع. الكلام يطول.. إلا أنه من الأجدى سيما مع الأعراف الأكاديمية الحديثة هو اتباع منهج الأمانة والتفرغ من البحث. قبل إنزال رؤى قد تكون تقولات على الآخر.. وهذا ما يعطي وصمة للكاتب نفسه.. علماً أن الباحث لم يتناول الكليات النظرية في أسسها تحليلاً إرجاعياً إلى الآليات العقلانية الموضوعية، فقط أراد ذكر المتبنيات التي اتهم في خلوّه منها، وذكر استناداتها في تلك الكليات بعيداً عن التحليل التام لها.. وسيكون لنا معها (إن شاء الله) خطوة تحليلية في عدد قادم. لذا يكتفى بتوجيه الباحث أن الفقه والتشريع الاجتهادي الإسلامي لا يخرج جزافاً من النص بل هو يعتمد على علم كامل (أصول الفقه) بما يوسم أنه منهج عقلنة الفقه الإسلامي وهذا العلم بما هو معروف علم إسلامي أصيل بعيداً عن كل شوائب الثقافات الأخرى، ويمكن الإطلاع على مباحثه في التأصيل واعتماد على القطع العقلي بالدرجة الأولى.. ثم أنه حتى استخدامات النص واستفادات دلالته، تقوم على إعمال العقل في مناهج وآليات تفسيرية.. محكومة بكليات وقواعد تسمى عادة بالحاكمة.. أو القواعد العليا في الفكر الإسلامي.. وهي التي تسمى بالكليات في الفكر الإسلامي.. ثم إن هذه الكليات ذات عمق في الكدح العقلي لقرون طويلة منصرمة استطاعت أن تبلور أطرها القاعدية أي أن عملية التقعيد، هي عملية آلية تعاضدت معها كثير من العلوم. |
|
الهـــوامـــش : |
|
(1) الشيرازي، محمد الحسيني؛ الفقه، كتاب الدولة الإسلامية، دار العلوم، بيروت ط1، 1420هـ، ص108. (8) ن.م: ص110. (9) أنظر السياق السابق - الموضّح - نفس المصدر السابق: ص117 (فإذا انعقدت الإمامة في فقيه واحد، إذا كان المرجع منحصراً فيه أو لم تختر الأمة سواه). (10) ن.م: ص118. (11) ن.م: ص118. |
|
|