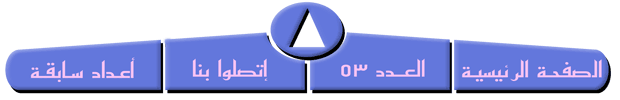|
||
|
||
|
فاضل الصفار |
||
|
لا يكفي أن يهتم العاملون بإقامة المؤسسات أو توفير عناصرها ويتركوا الحبل على الغارب لتجري بها الريح حيثما تشتهي لا كما تشتهي السفن... بل لابدّ من العمل على توفير عناصر الوجود وعناصر الاستمرار والبقاء حتى تصبح المؤسسة مؤسسة قائمة والعمل فيها مؤسّسيّاً حقيقياً.
إن عطاءها يظهر في ديمومتها وبقاءها كما إن قدرة القائمين عليها تظهر في إبقاءها قوية راسخة لا تهزها العواصف ولا تزيلها القواصف . لاشك أن الكثير من أصحاب المؤسسات يعانون من أزمات قاسية وصعبة ابتداء من حسن الإدارة إلى قوة الدعم إلى تعاطف الناس إلى التأثير على الرأي العام إلى غير ذلك إلا أنه تبقى المشكلة العويصة حقاً والتي يغفل عنها في الغالب مع إنها تأتي في الصف الأول من الأولويات تتمثل في إيجاد عناصر البقاء والمحافظة عليها قوية متينة ... لعلّ بعض الرجال لهم دور كبير في التأسيس ويجزيهم ربهم لأنهم حظوا بهذا التوفيق فأقاموا وأسسوا وهناك رجال يجزيهم ربهم أيضا لأنهم مشوا ومضوا وعملوا، وهناك رجال ربما سيكون جزاءهم أكبر لأنهم حافظوا على العمل قائماً عشرات بل مئات السنين فان من الواضح أن مَثَل هذه المؤسسات كمثل الصدقات الجارية التي مادامت قائمة فهي تنتج مادياً ومعنوياً لصالح العاملين فيها فضلاً عن الآخرين... وفي هذه الفرصة نجد من الضروري بحث المؤسسات من حيث عناصر البقاء ومعرقلاته ونتعرض إليها عبر الأمور التالية : الأمر الأول : مراحل تكامل المؤسسات إن المؤسسات كالأفراد تمر بمراحل نمو تدريجية إذا قطعتها بشكل طبيعي ومتوازن تكون أقوى تأثيراً وأقوى على البقاء ومقاومة الصعوبات لأن الطفرة والقفزة ونحوهما في النمو قد يتصور في بادئ الأمر أنها انتصار كبير إلا أنه لا يتفاءل معها بالخير دائماً وقد جعل اللّه سبحانه سنّ الأربعين أفضل المراحل لبعض عباده لبلوغهم الرشد الكافي والنضج اللازم في العقل والروح والعمل، كما قال سبحانه: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ) (1).. والأعمال الجماعية أيضاً ينبغي أن تقطع أشواطاً لبلوغ هذه الغاية وهناك مراحل متكاملة ينبغي أن تقطعها المؤسسسات حتى تصل إلى مرحلة القمة كما في الأفراد ولكن بفارق أن المؤسسات بما أنها تقوم بالجماعة والتكتلات فيمكن أن تختصر المسافات الطويلة التي يقطعها الإنسان بمفرده في فترة قياسية وهنا تتجلى أهمية التكتلات والتجمعات والأعمال القائمة على الجماعة والشورى، حيث أن ثمارها أعمّ وأفضل بالقياس إلى الأعمال الفردية. وهناك أربع مراحل لابد لكل مؤسسة أو جماعة أن تراعيها في هذا السبيل هي : 1. مرحلة البقاء على قيد الحياة: من الواضح أن كل عمل مبتلى بالأزمات والمشاكل التي تهدده بالضعف أو بالموت، والعبء الأساسي أولاً يقع على أصحابه ويتمثل في كيفية مواجهة تحديات البقاء ومعالجتها بنجاح وهذه مشكلة حقيقية تعاني منها الحكومات والدول والمنظمات العالمية والأحزاب والشركات الاقتصادية والإعلامية وغير ذلك فكيف بالمؤسسات الأخرى التي قد تكون أضعف منها قوة ودعماً . 2. مرحلة النمو: فأن من الواضح أن تجاوز مرحلة البقاء وحده غير كاف لإعطاء المؤسسة دور ناجح ما لم تبدأ بالمسير باتجاه النمو والصعود . فالتنظيمات والمؤسسات كالطفل تماماً فان الطفل يولد عاجزاً ومعتمداً اعتماداً كلياً على أبويه حتى يستطيع العيش... إلا أنه ينبغي أن ينمو ويصلب عوده ويصبح أكثر استقلالاً بذاته وأقل اعتماداً على غيره حتى يأخذ استقلاله الكامل فيقف على قدميه بقوة وجدارة... ومراحل نمو المؤسسات أيضاً كذلك .. صحيح أنها في مرحلة الولادة تبدأ معتمدة على الدعم والإسناد من مراكز القوة والقدرة وهذا أمر طبيعي في بادئ الأمر إلا أنه يعد نقصاً كبيراً يتجلى فيه العجز عن البقاء والاستمرار إذا ظل هذا الاعتماد قائماً على طول الوقت . لذا فإن الجدير بالقائمين عليها أن يأخذوا طريقهم إلى الصعود والنمو بعد تجاوز أخطار الفشل بالاعتماد على أنفسهم شيئاً فشيئاً حتى يصلوا إلى المراحل الأقوى والابلغ في الاستقلال الذاتي الذي يعطيهم قوة على قوة ويزيد من استقلالهم في الرأي والقرار أيضاً. على ذلك فأن مشكلة المؤسسات لن تستمر في صورة الصراع والتحدي من أجل الحياة بل ستأخذ شكلاً جديداً بمرور الوقت هو الصراع والتحدي من اجل النمو. 3 ـ مرحلة الاستقرار: وهي مرحلة مهمة جداً في حياة كل مؤسسة وجماعة لأنها تتطلب توافر قدرات عالية من الحكمة والخبرة والتماسك بين العاملين فيها وحفظ مستوى جيد من العلاقات الخارجية التي تحميها وتسندها وتتعاطى معها إيجابياً... ونعني بالاستقرار الاحتفاظ بمستوى جيد من النمو يكفل الثبات ويضمن الاستقرار للمؤسسة في مواجهة أية هزة أو تقلب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي وهذا يتطلب أولاً إرادة جدية وتصميماً أكيداً من العاملين على النجاح ولولاه سيكون الفشل هو المصير... وهناك مثل يقول : (ليس هناك أفضل من النجاح إلا النجاح) أي أن استقرار المؤسسة عند مستوى معين يدفعها دائماً إلى محاولة بلوغ المستويات الأعلى من الاستقرار وهكذا تدعم المؤسسة استقرارها دون فتور أو تراجع لأن الوقوف عند مرحلة من النمو معناه الهبوط إلى الأسفل شيئاً فشيئاً فأن طبيعة الجمود تؤدي إلى التفكك والفساد الداخلي الذي يعم ليشمل الدوائر الأوسع وبعكسه الحركة والنشاط والحفاظ على الهمة والحماس والأمل فإن من شأنها أن تحفظ حيوية الأفراد وقوة المؤسسة وقدرتها على النجاح..ولا تنسى المثل الذي يقوله الناس . (إن الماء الراكد يتعفن والماء الجاري عذب ومعتصم بذاته عن الأوساخ والملوثات...). 4. مرحلة القيادة الرائدة: وهي آخر مرحلة من دور حياة المؤسسات ونعني أن تأخذ المؤسسة دوراً قيادياً رائداً في مجالاتها وأنشطتها فتصبح عاملاً مؤثراً في المجتمع بصفة عامة: - فتؤثر في قيادة الرأي العام. - وفي قرار المجتمع أو القوى الفاعلة فيه. - وتقود المجموع إلى الأهداف العليا التي يطمع إليها. طبعاً لاشك أن لكل مؤسسة دوراً ما في القيادة إلا أن هذا ليس هو الطموح الأخير الذي تسعى إليه المؤسسات القوية .. لوجود ما هو أفضل منه وهو دور القيادة الرائدة الذي يمتلك زمام الأمر بحكمة وقدرة وكفاءة حتى يفرض نفسه واحترامه وهيبته على الجميع بما يمنع من تجاوزه أو إهماله.. ويتجاوز أن يكون نسخة ثانية في البلد ولا يمتاز عن غيره بمؤهلات القيادة العالية ليصبح المرجع الطبيعي والواقعي الذي يستقي منه الجميع بقوته وجدارته وحكمته ويركنون إليه في الآلام والآمال. وطبعاً هذا يتطلب من العاملين المزيد من التعقل والواقعية والإنصاف وحسن المعاشرة والإيثار والمجاهدات الطويلة في مختلف الأبعاد لان الناس ليس من السهل أن يسلموا زمام أمورهم إلا لمن يجدوه جديراً بذلك كما إن المنافسين والخصوم لا يقّرون بقوة حليفهم إلا إذا أيقنوا بقوته ومهارته وهو ما يعبر عنه في علم الإدارة (بحس الأداء). ونحن في كل هذه المراحل بحاجة إلى التخطيط الوافي للحفاظ على القوة والتماسك والنمو المتزايد ولولا ذلك فأن العدّ التنازلي يبدأ تدريجياً وبشكل غير محسوس حتى إذا تفاقم انهار العمل بشكل لا يقبل الحل . ولذا ورد في الحديث عنهم(ع): (من لم يكن في زيادة فهو نقصان). الأمر الثاني : تحسين مستوى الأداء أهم شيء في الحفاظ على مستوى جيد من الأداء والتنفيذ روحياً وعملياً هو الهدفية فإنا لو استطعنا أن نشعر كل فرد من أفراد الجماعة بأهمية الأداء وأهمية الإتقان والجودة لديه لما يترتب عليه من آثار ومنافع تعود على شخصية الفرد وشخصه حالاً ومستقبلاً فسنكون قد ساعدنا على تماسك العمل وحققنا أهم عناصر بقاء المؤسسة وديمومتها .. فان المؤسسة ليست مركزاً أو بناية مكونة من طبقات أو غرف ودوائر وان كانت هذه مهمة بل المؤسسة الحقيقية في واقعها وتماسكها ونظامها ودورها العملي وتواجدها في الساحة وتأثيرها.. ويرى بعض علماء الإدارة: إنّ الأداء مقياس لقدرة الفرد على تأدية عمله في الحاضر وكذلك على مستوى نموه وتطوره ورقّيه مستقبلاً لذلك يجب على كل فرد أن يوجّه اهتماماً خاصاً لأدائه في العمل لا لأن إجادة الأداء شيء مفروض عليه من فوق وإنما لارتباط الإتقان والجودة في عمله بمستقبله الشخصي والوظيفي كما يرتبط الأداء من وجهة نظر الفرد بأهم الحاجات الأساسية له وهي الحاجة إلى الاستقرار في العمل مضافاً إلى تحقيق الآمال والطموحات ومن الواضح أن الاستقرار العملي لا يناله من يعجز عن الأداء أو يقصرّ فيه والملحوظ في أكثر المؤسسات أن نتيجة الأداء الممتاز تظهر حينما يصاب العمل بعجز ما أو يرقى إلى مستويات أعلى بحيث يحتاج إلى كفاءات أعلى ومهارات أرقى فان من السهل الاستغناء عن الأفراد الذين لا يحظون بمستوى عال من الأداء تمهيداً لصعود الأفضل. والأنكى من ذلك أن الفرد الذي يخرج من هذه الحالات - لعدم كفاءته - لا يحصل على فرص عمل جديدة إلا بأدنى المستويات، وذلك للتجربة الناقصة أو الفاشلة التي خاضها في عمله السابق وهذه مسألة من شأنها أن تهدد العاملين بالأخطار المستقبلية لذا ينبغي التفكير دائماً بمهارات الأفراد لدى إقامة المؤسسات والتخطيط المستمر لتربية المهارات والكفاءات لكي لا تصاب المؤسسات بالعجز أو التراجع لكي نقدم مستوى جيد من العمل والإنجاز. ويوعز العديد من علماء الاقتصاد سبب تطوّر المؤسسات القائمة على الأنظمة الرأسمالية الحرة بالقياس إلى المؤسسات المحكومة بالنهج الفردي المستبد كما في دول العالم الثالث ونحوها إلى انعدام الأنظمة الموحدة في حوافز العمل والإنتاج بأشكالها المادية والمعنوية فأن من الواضح أن في المؤسسات الحرة غير النمطية الجامدة يشعر كل فرد بأهمية أدائه كما يجد أبواب الفرص مفتوحة أمام ناظريه لبذل المزيد من أجل الرقي والتطور... وهذه مسألة جوهرية في التطور والرقي لدى كل مؤسسة .. تحسين مستوى الأداء ورفع مستوى الأفراد لتفهم أدوارهم وإيجاد الطموح فيهم للترشيد والتكامل خصوصاً وأن مشاكل الحياة وهموم العمل وترهلات الإنسان كلما تقدم به العمر من شأنها أن تعرقل مسيرة الإنسان وتميت فيه الأمل والشعور بالثقة للوصول إلى الأفضل الأمر الذي يتطلب من القائمين دائماً إيقاد جذوة الأمل والحماس في الأفراد للقضاء على عوارض الجمود والموت في المؤسسة . ويقول خبراء الدول والحكومات بضرورة تبديل الكثير من الكوادر والكفاءات في الأجهزة الإدارية والحكومية للدولة سواء برفع الدول للاستشارات أو تغيير المواقع إلى مواقع تناسب وضعهم حتى تحفظ الدولة شبابها وحيوّيتها واندفاعها وحسن إدارتها.. لأن الكادر القديم على الرغم من مهارته وكثرة تجاربه وحكمته وخبرويته التي لا غنى عنها للمجتمع إلا أنه يبقى مستوى العمل وحوافزه وجودة الأداء متوقفاً على روح جديدة وقلب مفعم بالأمل والطموحات .. لذا فأن الأفضل هو الجمع بين خبروية الكبار وحيوية الشباب للحفاظ على مستوى جيد من المهارة في الأداء مع قوة وحماس ونشاط وبذلك تضمن إيجابيات كلا القوتين والمؤسسات العاملة لا تقل عن الدول في هذا الشأن... فخلاف الحكمة بل والأخلاق وربما الدين الاستغناء عن الكبار و القدامى، نظراً للأضرار الناجمة عن فقدانهم كخبرات وقدرات حقيقية راسخة كما ليس من الحكمة الاعتماد على خبروية الكبار بلا جذب لطاقات الشباب وروحهم المتدفقة في التنفيذ . لان كل واحد منهما بمعزل عن الآخر نقص إما في التنفيذ أو في التفكير والحل الأمثل هو الجمع بينهما وهنا تكمن أهمية لجان المشورة والإدارات الجماعية فإن الإدارة الجماعية تقدر أن تضم الكبار إلى الشباب في التخطيط والعمل كما يمكن أن تجعل الإشراف للكبار والتنفيذ للشباب مع مشورة ومراجعة كل مؤسسة حسب ظروفها وأوضاعها الخاصة، أما الركون إلى أحد الجناحين وترك الجناح الآخر فأنه يهدد المؤسسات بالفشل والانقسامات الداخلية ثم الضعف والانتهاء. الأمر الثالث : عقلنة الأهداف إن كل مؤسسة بحاجة إلى نوعين من الأهداف حتى تتماسك وتقوى على البقاء مع مستوى جيد من النهوض والتكامل هما : الأهداف الفلسفية أو ما يسمى بالاستراتيجيات والأهداف العملية أو ما يسمى بالتكتيكات وهذه مسألة تتعرض لها كل مؤسسة والفرق بينهما كبير .. مثلاً: إن الهدف من التعليم الجامعي قد يكون فلسفياً إذا قلنا أن الهدف هو: إعداد المواطن الصالح والمثقف القادر على خدمة بلاده وقد يكون تكتيكياً ميدانياً إذا قلنا أن الهدف من التعليم الجامعي هو إعداد فئة متخصصة في الحاسبات الإلكترونية واستخدامها في الدوائر والمؤسسات وفئة ثانية لإدارة الديبلوماسية وأخرى لملء الشواغر في قيادات الجيش وفئة رابعة لسد الفراغات في المستشفيات وهكذا... ومن الواضح أن التعريف الأول تعريف فلسفي لا يفيدنا اليوم من قريب إلا أنه على المدى البعيد أمر مهم وينبغي العمل عليه لأجل توفيره. بينما التعريف الثاني فانه تعريف عملي ينفعنا اليوم وهذا الهدف هو الذي ينظر إليه في الغالب لدى العاملين لأنه أمر واضح الحدود والمعالم كما أنه يمكن أن يخضع لمقياس معلوم للنجاح والفشل. بخلاف الأول فانه في الغالب فضفاض ولا يخضع لمقياس محدّد يوصلنا إلى النجاح والفشل فيه لكّن المشكلة انه لابد من وجوده بيننا لنحافظ على مستوى عال من التطلع والطموح كما نقضي على الترّهل والكسل، لأن الأهداف القريبة قد تتحقق وبعد التحقق قد تعود بنا إلى التراجع ما لم نجد هناك أهدافاً أخرى وأبعد تستحثنا للوصول إليها، خصوصاً وأن الغاية الأسمى في الحياة هي وصول الإنسان إلى أسمى مراقي الكمال والإنسانية.. وينبغي أن يكون السعي في أن تكون الأهداف الإستراتيجية مهمة وناضجة حتى تؤدي إلى المزيد من الفوائد والآثار ومشكلة عدم وجود المقياس في الأهداف الكبيرة لا ينبغي أن تكون عائقاً للسعي وراءها لأنها مهما كانت فيبقى مقياس النجاح والفشل لدى كل فرد هو نفسه والإنسان على نفسه بصيرة وقادر على أن يحكم على نفسه في أنه نجح في مشواره أو فشل وعلى أسوء الحالات فأن مستوى أداء الفرد وانعكاس تجاربه العملية هو المقياس الأخير الذي يعطي نتائج ملموسة لمستوى الأداء ومستوى الفرد.. الأمر الرابع : إزالة الموانع والمعرقلات طبعاً هناك موانع عديدة تهدد استمرار المؤسسات وقد تحدثنا سابقاً عن بعضها إلا أننا الآن نستعرض أهم مرض يصيب العاملين غالباً ويهدد العمل المؤسسي ألا وهو الإحباط لأنه يخذل الإنسان في أشد الأوقات حاجة إلى الصمود والصبر.. والدوافع والأسباب التي ينشأ منها الشعور بالإحباط كثيرة وقد رأينا العديد من الأفراد الذين وقعوا في هذه المشكلة فسبّبوا لأنفسهم وللآخرين المزيد من الخسائر ومن هنا نعلم أن حالة الإحباط من أهم العناصر عرقلة لمسيرة الأعمال والمؤسسات وينشأ الإحباط في الغالب من أحد عاملين: 1) الفشل في تحقيق الأهداف. 2) الانتصارات الناقصة. إن فشل الفرد في تحقيق أهدافه قد لا يكون لخطأ في إدراكه لتلك الأهداف أو للطرق والوسائل التي يجب اتباعها لتحقيقها إنما لوجود عائق أو عدة عوائق لا يمكنه السيطرة عليها فربما يثير العائق شعوراً داخلياً لديه مؤدّاه أنه مهما بذل من جهد لتحقيق هدف ما فأنه سيفشل حتماً في تحقيقه ويزداد هذا الشعور إذا قارن أداءه مع أداء الآخرين فأنه قد يستعظم أداءهم ويبالغ في إكبارهم فيتولد عنده شعور بالدونية تجاههم فينتابه إحساس بالهزيمة والنقص مما قد يسبب له عقدة نفسية يطلق عليها في الغالب اسم (الإحباط الداخلي). وأما إذا كانت هذه العوائق ناتجة عن وجود لوائح وقوانين أو نظام لا يمكن تغييره أو كانت موضوعة بمعرفة الآخرين وحكمتهم كالرؤساء والآباء ومراكز القرار فأن الإحباط الذي يصاب به هذه المرّة يطلق عليه (الإحباط الخارجي) فينتابه شعور بالقسوة وجفاء في العلاقات والعزلة الاجتماعية فيأخذ بالاعتزال شيئاً فشيئاً ويصبح دوره هامشياً بلا تفاؤل ولا فاعلية ولا تأثير. لذا ينبغي التنفيس عن الإحباط في أي وقت نجده مناسباً لذلك لتخفيف آثاره إلا أنه ينبغي أن نعرف أن التنفيس لا يمكن أن يكون هو الحل الناجح للتغلب على الإحباط وإنما الحل الصحيح هو تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف ولو النسبية... خصوصاً إذا انسجم النجاح مع توقعات الفرد نفسه.. فقد يتوقف الشعور بالإحباط على العوائق المتعددة إلا أن في بعض الأحيان ينتاب الفرد شعور بالإحباط بلا موانع خارجية وإنما يداهمه هذا الشعور حينما يجد أن الأهداف التي حققها لم تكن هي التي يتوقعها أو يطمح إليها وبالتالي فأن الإحباط لا ينشأ من الفشل فقط بل قد ينشأ من النجاح الناقص أو المخالف للتوقعات فإذا كانت توقعات الفرد أو ما يتوقع منه أن يحققه عالية فأن وجود العوائق التي تحول دون تحقيقه لأهدافه تصيبه بالإحباط دون شك أما إذا كانت هذه التوقعات معقولة أو متوسطة أو محسوبة حساباً جيداً فان هذه العوائق لن تقف حائلاً بينه وبين تحقيق أهدافه غالباً بل تصبح قوة دافعة على العمل وإثارة المزيد من الحيوية والحماس في نفوس الأفراد . وفي هذا الشأن يوصي بعض المتخصصين قائلاً: يجب على الرئيس أو المسؤول أن لا يضع توقعات - أي أهداف عملية - ليس بإمكان المرؤوس بلوغها كما إن الرئيس يجب أن يعد أفراده لتوقع مواجهة المصاعب في سبيل تحقيق أهدافهم حتى يمنع من تسرب الفشل أو الإحباط إليهم.. ويضرب البعض مثالاً لهذا بحرب أكتوبر حيث قال: نجد أن القيادة المصرية العسكرية كانت لها توقعاتها فيما يتعلق بالخسائر البشرية والتي قدّرت بحوالي ثلث الجيش المصري على أحسن الفروض في حين كانت توقعات القيادة الصهيونية لخسائرها البشرية في حالة اندلاع الحرب أقل من ذلك بكثير. وانتهت المعارك بخسائر بشرية تكاد تكون متعادلة لكلا الطرفين بالقياس إلى حساباتهما ففي حين نظرت القيادة المصرية إلى هذه الخسائر كدليل نجاح عظيم بالقياس إلى المكاسب والنجاحات التي تحققت من جراء عمليات العبور واقتحام خط بارليف والسيطرة على شرق القناة... نظرت القيادة الصهيونية إلى خسائرها البشرية على أنها دليل فشل ذريع وذلك لاختلاف توقعات كل قيادة لخسائرها. وهذه مسألة مطردة وعامة تجري في كل الكيانات والتجمعات والمؤسسات... إذن يجب أن تحسب الأهداف دائماً بشكل منطقي ومتوازن لكي لا نقع في مطبّات الإحباط والفشل فليس دائماً يصاب الأفراد بالإحباط نتيجة الفشل بل قد يصابون بالإحباط نتيجة المكاسب غير المتوقعة .. وهذا ما يدعونا دائماً إلى الواقعية والصراحة ووضع الحسابات لكل شيء وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة .. |
||
|
هناك مظاهر عديدة للإحباط تتجلى في سلوك الأفراد إذ ليس هناك رد فعل واحد أو نمطي لذلك بل تتدخل صفات الفرد ومستوى فهمه وعاطفيته وتعقله في رد الفعل المعكوس عن ذلك إلا أن أبرز مظاهر الإحباط تظهر في عدة مواقف منها ما يلي: (1) الانسحاب: وهو يتضمّن اعترافاً باطنياً من الفرد بإحجامه عن تحقيق أهدافه فينسحب عن الموقف كلياً. وتبدأ على مواقفه مظاهر الانسحاب. فيكف عن العمل الجاد كما تجده متشائماً أو منعدم الأمل والطموح لأنه يرى أن العمل الجاد لن يؤدي إلى النتيجة بأي حال من الأحوال لأنه اقل قدرة أو أن منافسيه أقوى أو اشد أو أن رئيسه لا يود بذل المزيد أو لانعدام الإمكانات والآليات إلى غير ذلك من التصورات التي قد تصح وقد لا تصح ونضرب لذلك مثالين هما: - طلاب المدارس في الاعداديات والجامعات في الدول المتخلفة والنامية غالباً ما يخامرهم شعور بالإحباط بعدم جدوى الدراسة أو التفوّق في مراحل الدراسة لشعورهم الباطني بعدم وجود الآليات الكافية لاستيعاب خبراتهم في المستقبل حسب ما يطمحون ويتوقعون وهذا أحد الأسباب التي يعود إليها سبب التأخر العلمي والتقني في هذه الدول.. وبالتالي التأخر الحضاري فيها. فإن قلّة فرص العمل - وفي بعضها تكاد تكون معدومة - أو انعدام التقدير الكافي للكفاءات أو قلة فرص الإبداع يمنع الطلبة من الجدّية الأكثر لتحقيق الأمل المنشود، ومن الواضح أن البلد يقوم على كفاءاته وخبراته فإذا كانت خبراته ناقصة أو عاجزة فإن ذلك ينعكس على مختلف مجالات الحياة فيه.. - ما يحدث لجيوش الدول المستعمرة حينما تفشل في صّد هجمات الثوار ويكون رّد الفعل لديها نتيجة للإحباط الذي يصيبها أن تنسحب من الأراضي المستعمرة .. (2) التراجع: ويعني النكوص إلى الوراء وسلوك طريق يتسم بعدم النضج .. (3) التناسي: بمعنى أن يتغاضى الفرد عن المشكلة التي يواجهها ويطويها في منطقة اللاشعور وهو يتضمن الهزيمة الساحقة إلا أنه يتغافل عن المسألة أو يوحي لنفسه بعدم وجود أي مشكلة أو يستصغرها بحيث لا يعدّها في الأنظار مهمة. (4) أحلام اليقظة: ونعني أن يقوم الفرد بتصور قصص معينة تظهر فيها بطولاته وقدرته على التغلب على المعوقات والمشاكل.. وتصنع هذه الحالة أفراداً لهم حالة من التبجح الكاذب والمبالغات الأسطورية وإيجاد الموقعية في أنظار الناس على أساس الخديعة.. لأنها تتضمن الهروب من الواقع إلى الخيال فمثلاً الشخص الضعيف البنية الذي لا يستطيع أن يتغلب على خصومه في واقع الحياة يتصورهم أقزاماً في خياله ويتصور نفسه عملاقاً عليهم. وهذه حالة خطرة تهدد العلاقات الاجتماعية للأفراد فضلاً عن العلاقات العملية في المؤسسات بالبساطة والاعتماد على الكذب والخداع. (5) العدوانية: ويرجع البعض معظم السلوك العدواني عند الأفراد إلى الإحباط مباشرة وبمعنى أدق أن الإحباط يؤدي إلى توليد الاستعداد لأن يسلك الفرد عدة طرق مختلفة حيث تكون العداونية أحدها وهنا ينبغي التفريق بين مسألتين: - الدافعية للعدوان. - والسلوك العدواني. حيث يمثل الأول رغبة دفينة للعدوان في حين يعبر الثاني عن السلوك العدواني الذي تنسبب له العوامل الخارجية وقوة هذا الدافع تتوقف على ثلاثة عوامل هي : أ) مستوى الشعور تجاه الاستجابة المحبطة. ب) مستوى الإعاقة المحبطة. ج) عدد الاستجابات المحبطة. والأول انعكاس لقوة الحاجة التي أحبطت فارتدت إحباطاً فمثلاً إذا كان الدافع أو الحاجة هو الجوع فأنه كلما ازداد الشعور بألم الجوع كلما ازداد احتمال العدوان خصوصاً إذا ما استمر الحرمان من الطعام بخلاف ما إذا أعد الطعام ولو أنه بصورة غير متقنة أو غير مرضية فأن احتمال السلوك العدواني يقل في هذه الصورة. وهكذا الأمر في قرارات المدراء وتصرفات الأفراد.. كما إن احتمال هذا السلوك يزداد كلما اقترب الإنسان من تحقيق الهدف لان الخسارة التي سيشعر بها في الحرمان أكثر وأشد فترتد عليه بالإحباط العنيف وأمّا الثاني فهو ملحوظ عند سلوك الكثير من الناس فأنه حينما تزداد درجة الإعاقة عند محاولتهم بلوغ الأهداف.. مثلاً حينما يقوم الرئيس بانتقاد أو إهانة أحد مرؤوسيه فقد يؤدي إلى إحباطه وحينئذ فأن استجابات المرؤوس العدوانية تبدأ في الزيادة كلما ازدادت حدّة النقد والإهانة. كما إنك كثيراً ما ترى أفراداً يثورون ثورة عارمة لحوادث طفيفة وبسيطة فتتصورهم بسطاء أو سذّج أو غير متوازنين إلا أن واقع الأمر هو أن هذه الحوادث البسيطة ما هي إلا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وذلك نتيجة لتراكم العديد من الحوادث الأخرى غير التافهة. إذن الإحباط حالة طبيعية قد نواجهها لدى كل فشل أو نجاح غير متوقع أو حسابات غير مدروسة وهو أمر يعرقل سير كل مؤسسة وعمل ولكن الكلام في كيفية معالجة ردود الأفعال السلبية الناتجة منه؟ |
||
|
هناك طرق عملية عديدة لمكافحة الإحباط.. بعضها يختص بالتفكير والعاطفة وقد تحدثنا عنها في المقالات السابقة وبعضها يختص بالعمل وهو يتطلب عمل عدة أشياء مثلاً: 1- إنشاء مخارج أو منافذ مؤقتة للغضب يستطيع الأفراد عن طريقها التعبير عن سلوكهم المحبط بدلاً من الارتماء في أحضان المنافذ غير الطبيعية (كالعدوان والتراجع والانسحاب) ونحوها وهذه المنافذ قد تكون في سفرات أو جلسات ترفيهية أو تحقيق انتصارات في مواضع أخرى لامتصاص الإحباط المتراكم وقد تكون في بعض النماذج التلقائية.. فعلى سبيل المثال: توجد في بعض المصانع اليابانية عدّة دمى مرسوم عليها أوجه قبيحة ومكتوب تحت كل وجه منها كلمة (المشرف) أو (المدير) أو (الطرف الحليف أو المنافس) أو غير ذلك من الأسماء التي تكون معرّضة للغضب والألم بحكم أعمالها.. حيث يمكن للعامل أن يثأر لنفسه من رئيسه بضرب الدمية، ولكن هذا غير مناسب لجميع الأعمال والمؤسسات، لذا ينبغي التفكير في بدائل أخرى مناسبة لتحقيق فوائده جمة. كما قد تأخذ هذه المنافذ أشكالاً إدارية مثل إيجاد نظم الاتصالات السليمة داخل العمل حيث يمكن لكل فرد الاتصال شفاهياً أو كتابة بالمستويات العليا بالتنظيم أو المؤسسة وعرض قضاياه.. ومنها الجلسات المفتوحة أو الجلسات اللامنتظمة (الاجتماعات التلقائية) والسفرات ونحوها.. إذ إن معالجة الكبت والغضب قبل أوانه خطوة مهمة للحوؤل دون انفجاره .. ويقال: إن بداية الانفجار في العراق عام (1991م) كانت بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت حيث رمى أحد الجنود صورة (صدام) السبب الحقيقي وراء كل أزمات العراق بالرصاص فهشمها وكان هذا بمثابة الكوة التي يقف وراءها السيل فزال حاجز الخوف وتفجّر الغضب وعم أوساط الشعب وهذا أمر قد يحدث في كل مؤسسة أو جماعة إذا لم توجد منافذ تمتص الغضب قبل أوان انفجاره. 2- إذا كان مصدر الإحباط هو القوانين واللوائح الجامدة فان الرئيس الفعّال يجب عليه أن يحاول تغييرها فإذا فشل فأنه يجب عليه تفسيرها وتطبيقها بمرونة كافية دون مخالفة جوهرها، وهذه نقطة مهمة قد لا يلتفت إليها العديد من المدراء، أو يضيعها العديد من المدراء الروتينيين أو الجامدين في قراراتهم وأساليبهم. المرونة والمطّاطية واللطافة من أفضل الأساليب الإدارية وصمام الأمان من الأزمات فإذا لم يستطع المدير عمل ذلك فما عليه إلا أن يرشّدها بأن يقنع الأفراد بأنها وجدت لتبقى وان الأفضل هو التجاوب معها بقدر الإمكان دون التحدي أو الصد وهذا أضعف الإيمان خصوصاً في القضايا الهامة التي لا تقبل الإهمال أو التراجع. 3- أمّا إذا كان مصدر الإحباط هو الرئيس ذاته و أسلوبه في الإدارة فهناك خطوتان مهمتان في معالجة هذا الأمر إحداها جذرية تتعلق بإعداد الرئيس إعداداً كافياً يمكنه من تفهم طبيعة العلاقات بينه وبين الأفراد وطريقة تفسير وتطبيق اللوائح والقوانين وماهية الأساليب القيادية الفعالة ومكوناتها.. وهذا أمر يدعو المؤسسة دائماً إلى التفكير في بناء الكادر ورفع مستوى جاهزية العناصر والأفراد حتى تحافظ على مستوى عالٍ من العمل والنمو والبقاء. وأما الثانية: فهي في إلزام المدراء بالأعمال الجماعية وتشكيل اللجان الإدارية و التخلي عن الفردية وحصر العمل بالأفراد.. وفي الغالب فإن المؤسسات التي لا تحظى باشراك الاخرين ولا يتخذ المدراء فيها معاونين ولا مفوضين تبتلى بهذا النمط من المشاكل لعدم التربية في المناصب القيادية فتضطر لاعتماد أساليب الطفرة في توّليها وهذا يسبب لها المزيد من المشاكل في العمل وفي الأداء. إذن الحل الجذري يكمن في اختيار الرؤساء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا وهناك عوامل أخرى من شأنها أن تحفظ بقاء المؤسسات وديمومتها بعضها يعود إلى القانونية الداخلية وبعضها يعود إلى تعيين المؤسسة ضمن القانونية العامة للبلد الذي تعمل فيه وبعضها يعود إلى أساليب الإدارة والتخطيط ولكن بما أننا قد تعرضنا لها في المحاولات السابقة فنكتفي بهذه الإشارة.. |
||
|
الهوامش: |
||
|
1 - يوسف: 22. |
||
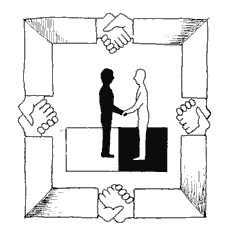 وأهم
شيء في المؤسسات أن يهتم القائمون في
الحفاظ عليها وترسيخ جذورها لكي تبقى
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ....
وأهم
شيء في المؤسسات أن يهتم القائمون في
الحفاظ عليها وترسيخ جذورها لكي تبقى
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ....