|
د. سعــد الأمــارة |
|
|
تمـهــــيد: |
|
|
تركز معظم الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية والدينية، وكل من يدرس الإنسان في حياته الاجتماعية على التفاعل بينه وبين الآخر (الإنسان والإنسان) وبين الإنسان والجماعة، وبين الجماعات، وتعد التفاعلية فتحاً علمياً أساسه اجتماعي في معظمه، لذا عدّ التفاعل الاجتماعي في مجتمعاتنا المعاصرة (الحديثة) وحتى القديمة، من أسس قيامها واستمرارها وامتداد بقائها ليومنا هذا، حيث قال الإمام الشيرازي: (إن الإنسان خلق اجتماعياً بالطبع، لا لحاجته الجسدية فقط، بل لحاجاته النفسية، حيث الإنسان يستأنس بالإنسان، ويستوحش لفقده، كأن الإنسان يؤثر في الإنسان الآخر، سواء أكانا فردين، أو مجتمعين، أو بالاختلاف والتأثير)(2: 38)، ولولا ذلك لفنيت بفعل السلوك الغريزي (الحيواني) وغلبة الأنانية الافتراسية على سلوك المجتمعات؛ فالتفاعل الاجتماعي مفهوم مهم يشكل أساس الشخصية والعلاقات المتفاعلة، فالإنسان يعدّ - أساساً - كائناً حياً ليس بتكوينه البيولوجي بقدر ما هو حقيقة لا مفر منها،وهو كائن اجتماعي بحقيقة مشاركته في الجماعة الاجتماعية، ويهذب هذا المفهوم ويضفي عليه الطابع الإنساني تنظيم العلاقات من خلال أكبر مؤثر في السلوك وهو الدين، والدين الحقيقي حصراً، وليس القشور السطحية للدين؛ من قبيل استخدامه إطاراً رسمياً للمناسبات، وإنما الدين بتعاليمه ومنهجه، فالدين الحقيقي هو القاسم المشترك والجامع الأكيد لتفسير كل النزعات الإنسانية، بتكوينها، ونشأتها، وتفاعلها، وحتى الأدوار الاجتماعية لم يبخسها حقها. فالدين وضع المجتمع الإنساني على المحك عندما دعا إلى السلام والمساواة وحب الآخر وقبوله، والابتعاد عن الضغينة والمنابذة؛ إذ قال تبارك وتعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (الأنفال: 46). فالدين إذاً إطار شامل يضم البشرية أجمع، وهو المنهج المتكامل لكل زمان ومكان ولكل الأقوام والشعوب، وهو يدعو الناس إلى تكوين أسرة متفاعلة مع نفسها ومع الآخرين؛ فقد قال الإمام علي بن أبي طالب(ع): ( عليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع)(2: 48)، وهو التفاعل والتواصل القائم على تأسيس القيم الداعية إلى الفضيلة والتمسك بالتقاليد والأعراف الصحيحة، كما يدعو الدين الناس إلى نبذ العنف وعدم دعمه كسلوك إنساني في التعامل وإحلال التفاعل السلمي بين الأفراد والمجتمعات والشعوب حتى يصل إلى الأمم، وهي دعوة حقة قوامها الحفاظ على الجنس البشري من الفناء.. إذن؛ فالتفاعل الاجتماعي هو سلوك يتعلمه الإنسان من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، كما يتم تعلمه من الأسرة، وهو أيضاً سلوك يباركه الدين، باعتباره أحد سمات المجتمع المتماسك؛ لذا يعد التفاعل الاجتماعي أحد الأساليب المهمة التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يعدل سلوكه عندما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، والتفاعل الاجتماعي عمل متبادل حيث يشترك كل فرد في هذا العمل ويكيف نفسه ليعمل مع الآخرين (1 : 232). ومن الجوانب الأساسية التي يدعو لها الدين هي محبة الآخرين والاندماج معهم، والتفاعل والتعاون معهم، فكانت النظرة التفاعلية للفرد مع الآخرين قائمة على أساس الاتصال.. المشاركة.. معرفة الدور.. التفاعلات الإنسانية بكل أشكالها؛ ولقد جاء في الذكر الحكيم: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) (فصلت: 34). |
|
|
الدين والأسرة والتنشئة الاجتماعية: |
|
|
يشكل الدين أحد أهم الركائز (الأسس) لدى الإنسان المعاصر نظراً للتغيرات السريعة المستجدة في حياة المجتمعات وبنائها السريع، مقارنةً مع ما كانت عليه في السنوات السابقة التي تميزت ببساطة الحياة ورتابتها؛ فالتغيرات السريعة في سياق مناحي الحياة المتنوعة التي أحدثت انقلابات شبه جذرية في تلك المجتمعات والتي طالت خلالها القواعد والقوانين والقيم الاجتماعية وكل ما يتصل بتنظيمها؛ مما يستدعي بشكل ملحّ العودة إلى الدين لتنظيم حياة الناس وإضفاء حالة الطمأنينة والهدوء عليها بعد أن فقدوها. فالتجمعات السكانية التي أصبحت من كثافتها لا تطاق مع الابتعاد عن القيم والمعايير الاجتماعية، فكانت العودة إلى الدين أمراً محتوماً، بغية تنظيم الحياة من جديد، والعودة إلى قيم الأصالة المتمثلة فيه، إذ في ذلك النجاة مما أحاق بالإنسان من مصائب وكوارث طبيعية، أو بفعل الإنسان نفسه، فكانت العودة إلى الدين بمثابة عودة الإنسان إلى الوعي من جديد، فلا يمكن لأي مجتمع إنساني أن يعيش بأمان أو تتنظم حياته دون أن يكون الفيصل في ذلك الدين الإسلامي ومنهجه المتسامح، فهو منهج للحياة، ودين تنظيم التعاملات الفردية والجمعية.. الدين الذي يمنح الإنسان الراحة عند اللجوء إليه في ظل الظروف السائدة الملبدة بغيوم التغييرات السريعة بنظم العولمة والتحولات التكنولوجية المتلاطمة التي تدعو إلى إلغاء الخصوصية الفردية وانتهاكها، وما تتركه من أمراض واضطرابات تبدو بمجملها ناتجة عن السياسة العالمية التي تمد بظلالها الكثيفة على المجتمعات والشعوب، وجعلت منها حقولاً للتجارب من خلال تعريضها للحروب والأزمات والكوارث والأمراض، فضلاً عن انعكاسات تلك التجارب على السلوك الإنساني ومجمل حياة الإنسان، فسببت الكدر والضيق والضغط النفسي.. وعندما نستعرض كل تلك الأزمات والأوبئة والكوارث، نجد أن الإنسان قد ابتعد عن القيم، والتعامل الاجتماعي القويم، فدبت المصلحة الشخصية الفردية الأنانية والابتعاد عن روح الجماعة، وانتشرت آلية التعاملات التجارية المادية إزاء انحسار القيم الاجتماعية والسلوك السوي الواعي الذي يتفق مع التوجهات القيمية للدين في بناء المجتمعات الإنسانية. فالدين إذاً القاسم المشترك لاستعادة جوهر الوعي والإدراك النفسي والاجتماعي للفرد؛ نظراً لمنهجه الذي يصلح لكل زمان ومكان، ولكل الشعوب والمجتمعات الإنسانية. فالابتعاد عن الدين يثير معاناة شخصية (فردية) واجتماعية، وإذا ما تحللت القيم بالتدريج لدى أفراد المجتمع الحديث فإن المشكلات تزداد، ومن أهم تلك المشكلات التي تسبب المعاناة والآلام: ازدياد حالات الطلاق، والفشل في إيجاد سبل وحلول ناجحة في تربية الأبناء تربية صحيحة قويمة، واضطراب الثقة بين الأبوين، وازدياد حالات اضطراب الهوية (الهوية الذاتية الشخصية، والأسرية ثم الوطنية) فضلاً عن الإحساس بالتبلّد الانفعالي إزاء مواقف الحياة المختلفة، السهلة منها والصعبة،وانخفاض الروح المعنوية الفردية، حتى تكاد روح الكآبة تسري في مفاصل المجتمع وحلقاته. فالدين إذاً هو الحل الأمثل لكل تلك المشكلات من خلال إعادة النظر في الأسس التي تبنى عليها الأسرة، ويتطلب هذا عملاً جماعياً يخطط له، بالإضافة إلى التعرف الكامل على واقع التنشئة الاجتماعية والطرق المعتمدة ضمن إطارها الاجتماعي بغية تحقيق المساعدة، فالإمام الشيرازي يرى بأن للدين أهمية كبرى في التأثير في الفرد ثم التأثير في المجتمع، ولا يخفى الفرق بين الدين المرتبط بالحياة كالإسلام، حيث له مناهج في كل الشؤون، وبين الدين غير المرتبط بالحياة (2: 78). أما الأسرة - التي تعد محور قضية وجود الإنسان - فهي التي كونت النواة الأولى لذلك الإنسان في حياته الهادئة أو المضطربة، راحته أو شقائه؛ فالتربية التي تربي بها الأسرة أبناءها هي الكفيلة بأن يُتعلم من خلالها السلوك المعوجّ (المنحرف) أو الصحيح (القويم)؛ وبما أن الخلل والتدهور شمل الأسرة، فحتماً ستكون النتائج المتوقعة مضطربة ومشوّهة وهي حقيقة علمية لا غبار عليها، فإصلاح الأسرة يعد اللبنة الأولى في إصلاح المجتمع وأفراده، فالأسرة في مجتمعاتنا نعتبرها أسرة شرعية التكوين، أسرة زواجية، وهي تعد نسقاً يتكون من زوجين وأطفالهما. ولأن التأكيد الاجتماعي في مثل هذه الأنساق ينصب بصفة أساسية على العلاقة الزوجية (3: 167)، وهي المعمول بها في مجتمعاتنا، والتي تتناقض في تكوينها مع النسق الغربي الذي يعتمد على إقامة علاقات تعطى صبغة الزواج وإنجاب الأطفال، ولكن بدون سياقات شرعية، أو ضوابط قيمية، ونعني بذلك الأسرة أو العائلة التي أقيمت على ضوابط شرعية أولاً وقبل تأسيسها، فالعائلة أوّل ما تكونت من زوج وزوجة (4: 30)، ويقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وجعل منها زوجها ليسكن إليها)(الأعراف: 189). أما التنشئة الاجتماعية، فهي العملية التي من خلالها نتعلم كيف نصبح أعضاءً في المجتمع، من خلال استدماج معايير وقيم المجتمع من ناحية أو تعلم كيفية أداء أدوارنا الاجتماعية (دور العامل، دور الأب، دور الصديق، دور المواطن.. الخ)،والتنشئة تعد أساسية في تحقيق التكامل في المجتمع، ولم يعد يُنظر إلى التنشئة الاجتماعية باعتبارها الحافظ لمرحلة الطفولة، وتتم من خلال الأسرة والمدرسة، ولكن أصبحت من الأمور المسلّم بها، إلا أن التنشئة عملية مستمرّة مدى الحياة، كما اتضح أيضاً أنها ليست مجرّد عملية ذات خط واحد، يتعلم من خلالها الأفراد كيف يتكيفون مع المجتمع (3: 482). |
|
|
الدين والروابط الأسرية: |
|
|
معظم الناس على دراية ومعرفة تامة بما للدين من تأثير فعّال على سلوك أفراد مجتمعاتنا وتكوين أفكارهم وأسلوبهم في الحياة، وتعاملاتهم في دقائق الأمور العملية اليومية، فمعظم ما يصدر عنا من تصرفات، إنما هو نتاج يتدخل في معظمه عامل التشبع بالدين، فهو شريعة تملأ الحياة في عباداته ومعاملاته وأحواله الشخصية (4: 60)، وعليه فهو نظم سلوك الزوجين داخل الأسرة الواحدة على مستوى التربية والتعامل واكتساب القيم، وإقامة العلاقات والروابط داخل الأسرة، والعلاقات بين الأهل والمقربين. إذن فالعائلة عشّ لا للجهات الجسدية للأولاد، بل للجهات النفسية أيضاً، فإنهم يتعلمون من الأبوين ويتربون بأخلاقهما وسلوكهما، ولذا كان عليهما تحسين السلوك حتى لا يخرج الأولاد منحرفين (4: 39)، فالدين على ضوء ذلك هو القاسم المشترك للسلوك إزاء مواقف الحياة المختلفة في التربية وإقامة الروابط والعلاقات داخل الفرد نفسه، وبينه وبين شريك حياته، وبينه وبين أولاده، حتى تمتد العلاقات والروابط نحو الجار والآخرين من الناس في المجتمع؛ لذا فإن أسس تكوين الروابط اللاشعورية المعتمدة على الدين والمستمدة منه مقومات بقائها تبدأ من داخل الأسرة الصغيرة (الأب والأم) فأي اختلال في تنظيم العلاقات والروابط داخل الجهاز الأسري يسهم في إحداث الاضطرابات والمشكلات النفسية والاجتماعية لاحقاً؛ فالأسر تمتلك فعلاً قوياً، وأسلوباً خاصاً بها، يحدد طبيعة اتصال أفرادها وكيفية التعامل مع بعضهم البعض، أو مع الآخرين خارج نطاق الأسرة؛ لذلك فإن تحديد الأدوار (الذكورة والأنوثة - الأب والأم) يتم على وفق النظام القيمي السائد في المجتمع، وهو يعد الأصلح والأنجح (حديثنا عن المجتمع الإسلامي). أما إذا تم عكس ذلك فإن العلاقات والروابط ترتبك في الأسرة؛ فالدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي انفرد عن باقي الأديان، وذلك من خلال وضعه أسس هذه التعاملات والعلاقات والأدوار، وبناءً على ما يعطيه من دور للرجل أو المرأة، أو الابن الأكبر أو الأصغر، أو البنت، حتى تم تنظيم هذه الأدوار بشكل لا شائبة عليه، وتحقق ذلك واقعياً من خلال سلوك أفراد المجتمع، فإن كبيرهم يعطف على صغيرهم وصغيرهم يحترم كبيرهم، ثم وضع الضوابط الاجتماعية القيمية داخل الأسرة، وامتدت إلى المجتمع الأوسع فكان أن ظلّ النسيج الاجتماعي محافظاً على تكوينه رغم التغيرات العاصفة وموجات التمرد والتنافر الأخلاقي في معظم المجتمعات، كما أن الترتيب القيمي المعتمد على أسس الدين، ظل محافظاً على هيكليته في الأسرة والمجتمع، وإن كان الالتزام بها نسبياً ومتفاوتاً بشدته من مجتمع لآخر، إلا أنها ظلت متماسكة مما جعل الهوية الذاتية للفرد متماسكة كامتداد لقيم الأسرة. |
|
|
الأسرة واكتساب القيم والعادات: |
|
|
فعلاقة الوالدين أحدهما بالآخر لها الأهمية الكبرى في نسق اكتساب القيم من خلال التربية، وتوافقهما يحقق للأبناء تربية نفسية سليمة خالية من العقد والمشكلات التي لا تبدو واضحة للعيان آنياً، وإنما تظهر نتائجها بشكل واضح مستقبلاً، فإشباع حاجات الأبناء من قبل الأبوين يخفف إلى حد ما من درجات التناقض في التربية، فضلاً عن تحقيق التماسك الأسري واستقراره؛ حيث بالإمكان أن يسود جو العلاقات الخالي من التشاحن والخلافات، خاصة بين الأبوين، فزيادة التناحر والصراع بينهما ينعكس تماماً على الأطفال مباشرةً ويترك آثاراً نفسية مؤلمة، ويصيب الأطفال باختلال في التوازن الانفعالي والنفسي، ويهدد أمن الطفل وسلامة حاجاته للانتماء عندما يشهد هذا الصراع، ويسمع ألفاظاً قاسية لا يستطيع أن يهرب من آثارها النفسية، فقد تؤدي هذه العلاقات بين الوالدين إلى أنماط من السلوك المضطرب لدى الأطفال كالغيرة والأنانية والخوف وعدم الاتزان الانفعالي (9: 102). أما القيم التي تعلمها الأسرة لأبنائها فهي عبارة عن مفاهيم تختص باتجاهات وغايات تسعى إليها، كاتجاهات وغايات جديرة بالرغبة، وتعد القيم بمثابة المعيار المثالي لسلوك الفرد، ذلك المعيار الذي يوجه تصرفات الفرد وأحكامه وميوله ورغباته واهتماماته المختلفة، والذي على ضوءه يرجح أحد بدائل السلوك، وأن الفعل أو السلوك الذي يصدر عنه وسيلة يحقق بها توجهاته القيمية في الحياة، لذا تعد الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية في اكتساب الأبناء لقيمهم، فهي التي تحدد لأبنائها ما ينبغي أن يكون في ظل المعايير السائدة (9: 214)، ومن القيم التي تكسبها الأسر المسلمة لأبنائها السلوكيات الاجتماعية المتعلقة بالأخلاق والدين والتعامل مع الآخرين وآداب المجالسة والوفاء والإخلاص، فقد قال الإمام علي(ع) : (لأخيك عليك مثل الذي لك عليه) وقال أيضا: (من لانت كلمته وجبت محبته) (8: 66)، فالدين إذاً نسق قيمي، ذو نسب متفاوتة ومتباينة نسبياً، فالأشخاص الذين تتميز تربيتهم بالقيم الدينية وتتسم سلوكياتهم بسمات مثل الطاعة، الأمانة، التسامح، التعاون، الوفاء.. الخ، وعلى العكس تماماً فيما يتعلق بالأشخاص الأقل تديناً أو تتم تربيتهم بسمات أخرى ليست دينية بحتة، فإن القيم السائدة لديهم تكون عادة القيم الوسيلية الخاصة، فهي تختلف عن الأولى بفروق نسبية، من حيث الدرجة. إن التربية في المجتمع الإسلامي بنوعيها؛ التربية القائمة على القيم الدينية، والتربية القائمة على القيم الدينية المتسامحة، فإنها تكاد تتشابه في معظمها، حتى كادت المسحة أو السمة العامة للسلوك الشخصي لأفراده المتشددين أو الأقل تشدداً على القيم تختلف في الدرجة، ولكن في النتائج تتغلب القيم الدينية الإسلامية في قوة التماسك والترابط الأسري والاجتماعي، فهي الأكثر ثباتاً. |
|
|
أثر الأسرة في التنشئة الاجتماعية: |
|
|
إن آفاق التربية الأسرية تمتد عند بلوغ الطفل سن السادسة من العمر، حيث يلتحق معظم الأطفال بالمدارس أو مراكز التعليم المختلفة، فتكون قيم الأسرة التي زرعتها في أطفالها قد أثمرت لتجد نفسها أمام محك التطبيق العملي الميداني، فالأسرة عندما اتبعت في تربيتها لأبنائها أنماطاً معينة تكون قد ابتعدت أو اقتربت من حالة السواء الجمعي في السلوك، فسلوك التبعية والامتثال والخضوع المفرط، يجد صداه في التعامل مع الأقران في هذه المرحلة، حيث يكون الاحتكاك مع الأقران في المدرسة والشارع معظم الوقت، أما إذا نمى الطفل على أساليب التربية الأسرية القائمة على الثقة بالنفس والتعامل بروح المبادرة وسلوك الاعتداد بالذات، فإنه سيحقق ذلك حتماً في الميدان الحقيقي... هو في كلتا الحالتين يجد نفسه أمام المواجهة.. وعند التساؤل عن العوامل الأساسية المسؤولة عن تكوين هذه السمات وسيطرتها على شخصية الفرد في التعاملات اليومية، نجدها تتحدد في ثلاث فئات أساسية وهي: الفئة الأولى: المحددات البيولوجية وتشمل الملامح أو الصفات الجسمية كالطول والوزن. الفئة الثانية: المحددات السيكولوجية (النفسية) وتتضمن العديد من الجوانب كسمات الشخصية ودورها في تحديد التوجهات القيمية للأفراد. الفئة الثالثة: المحددات البيئية، حيث يمكن تفسير أوجه التشابه والاختلاف بين الأفراد في ضوء اختلافات المؤثرات البيئية والاجتماعية (9: 257). فالتنشئة الاجتماعية هي امتداد لتربية الأسرة في البيت، حتى سميت بالتنشئة الأسرية، وهي أولى مهام التنشئة الاجتماعية، وقد تبين أن هناك علاقة بين أسلوب التنشئة الاجتماعية وما تبناه الأبناء من قيم، فالأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد في فراغ، وإنما يحكمها إطار الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها، كما يتمثل في المستوى الاقتصادي - الاجتماعي، والديانة وغير ذلك من المتغيرات. إذن فالأسرة تلعب دوراً أساسياً في إكساب الفرد قيم معينة، ثم تقوم الجماعات الثانوية المختلفة التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته الاجتماعية بدور مكمل، بحيث تتحدد للفرد قيم معينة يسير في إطارها، فالفرد يتنازل عن بعض القيم التي اكتسبها في محيط الأسرة ليأخذ بغيرها مما تأثر به في إطار مختلف (9: 257)، وإن كان يماثل في معظمه التنشئة الأسرية أو البيئة الاجتماعية، فهو امتداد لهما؛ حيث قال الإمام الشيرازي: إن المحيط الاجتماعي يؤثر في الإنسان تأثيراً كبيراً، وكلما كان المجتمع أكبر، كان تأثيره في الإنسان أكثر (2:84). |
|
|
الإنسان بين الدين وعوامل التنشئة الاجتماعية: |
|
|
من المتفق عليه أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يتأثر ويؤثر اجتماعياً، يتأثر بأهله، بمجتمعه، بتاريخه، بكل ما يحيط به ليؤثر تالياً في بناء شخصية أبنائه، ومن ثم في حياتهم، فيرسم لهم الأطر التي ضمنها يتحركون؛ لذلك يعيش المرء حاضره انعكاساً لبعض ماضيه، فينظر إلى مستقبله انطلاقاً من حياة معاشة مليئة بما يفرح وبما يحزن، بما ينشط وبما يخمل، فحيال هذا يمتثل ويتوحد، يقلد ويحاكي، يثور ويعاكس، يجد الحلول لمعاناته (1: 72). على وفق نمط شخصيته التي خلقها الله وتكونت، فضلاً عن التربية التي تلقاها من أسرته ومدى تأثيرها عليه، فهل شكل الدين الأساس المتين فيها، أم أنها تربية عامة، أو أنها شمولية تأثرت بالدين وأساليب أخرى. وبعد ذلك يأتي دور المجتمع في صقل تلك المكونات؛ فقد ثبت علمياً بأن الأسر التي يطغى على تربيتها عوامل التشتت والتفكك تؤدي بالأبناء بمرور الزمن إلى اللامبالاة أو عدم الاهتمام أو النقيض التام من ذلك السلوك الذي تعلموه في طفولتهم، وهو التقيد والتمسك بالتقاليد ودقة المواعيد وإكمال الواجبات الحياتية بأدق الصور، وهناك بعض السمات التي تبدو واضحة على شخصية الأبناء الذين تلقوا التربية في ظل ظروف غير اعتيادية مثل الأسرة التي يتعاطى فيها أحد الأبوين الكحول، حيث من المحتمل أن تعصف المشكلات الخطيرة بكيان الأسرة، وتهز أركان تماسكها، فهو مرض اجتماعي خطير يؤثر بشكل سلبي على نسيج العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع. وتتميز أيضاً بأن أعضاء الأسرة التي يتعاطى أفرادها الكحول أو المخدرات بأنها لا تولي اهتماماً تجاه بعضهم البعض، وخصوصاً معاملة الأبوين لأطفالهما، في الوقت الذي تتسم حياتهما بالتقلب والطيش، إضافة إلى أن العلاقات بين أعضاء الأسرة استبدادية وتسلطية، وكذلك تحاول الأسرة تحريم أشكال التعبير الحر عن حاجاتهم ومشاعرهم، وعلاقاتهم المتبادلة التي تتسم بالصلابة والقسوة (11: 62). ولكن تبقى المكونات الفردية التي ينشأ عليها الأطفال أثناء تلقيهم التربية بأنواعها، ومدى تقبلهم أو رفضهم لتلك العوامل المؤثرة مباشرة، فهي التي تحدد سلوكهم، فضلاً عن التنشئة الاجتماعية خارج الأسرة التي تصقل الخبرات الأولى التي تعلمها من الأسرة، وكذلك تأثير الأقران في ذلك الصقل، وعند تحليل المكونات الفردية والعوامل الخارجية المؤثرة نجد أن الأولى تسمى المكونات الذاتية والثانية (العوامل) الخارجية (الموضوعية)؛ فالشخصية في تصرفها تسلك على وفق هذين المؤثرين الذاتي والموضوعي، ولكن يبقى العامل الآخر الأهم، والذي يعد المؤثر الأكبر في التكوين في مجتمعاتنا، هو توكيد النزعة الأخلاقية التي يلعب الدين فيها دوراً مهماً، ومنهج القرآن الدور الأكبر، والقرآن دقيق الوصف لنفوس الأفراد والجماعات، ووصفه ينطبق على نفوس الناس في كل زمان ومكان، لأنه يتماشى مع وصف خصائص النفس وصفاتها الموروثة والمكتسبة، فالقرآن يحض على تهذيب النفس(2: 190). ويقول الله سبحانه وتعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد: 11)، وقال الإمام علي بن أبي طالب (ع):(الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)(13: 159)، كما قال الإمام السيد الشيرازي: (الدين يُصلح شأن الإنسان في دنياه وفي آخرته)(13: 97). |
|
|
الهـــوامـــش: |
|
|
(1) علم النفس الاجتماعي/ج1، محمود السيد أبو النيل، دار النهضة العربية، بيروت 1985م. (2) الاجتماع/ج1، السيد محمد الحسيني الشيرازي، دار العلوم، بيروت 1992م. (3) موسوعة علم الاجتماع، جوردن مارشال، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، المركز المصري العربي - القاهرة 2000م. (4) الاجتماع/ج2، السيد محمد الحسيني الشيرازي، دار العلوم - بيروت 1992م. (5) التربية الشبابية وأنماط التنشئة، محمد خالد، مجلة النبأ، العدد55 آذار 2001م. (6) تشكيل نظام القيم، جليل شكور، مجلة الثقافة النفسية العدد 8 تشرين الأول 1991م. (7) علم النفس الاجتماعي/ج2، محمود السيد أبو النيل، دار النهضة العربية - بيروت 1985م. (8) تحف العقول، أبو محمد الحسن الحراني، مطبعة شريعت - إيران 1421هـ. (9) علم النفس الاجتماعي، عبد الفتاح دويدار، دار النهضة العربية - بيروت 1994م. (10) الأهل وأثرهم في تحديد مستوى الطموح، جليل شكور، مجلة الثقافة النفسية العدد6 نيسان 1991م. (11) الطفل في ظل الأسرة الكحولية، محمد قاسم عبد الله ووليد أحمد المصري، مجلة الثقافة النفسية العدد37 كانون الثاني 1999م. (12) القرآن وعلم النفس، عبد العلي الجسماني، الدار العربية للعلوم - بيروت 1997م. (13) السبيل إلى إنهاض المسلمين، السيد محمد الحسيني الشيرازي، مؤسسة الفكر الإسلامي - بيروت (ب.ت). |
|
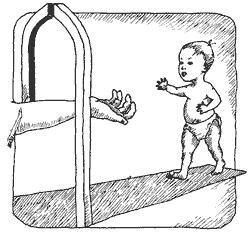 تعد الأسرة السليمة المؤسسة
المكملة لنسيج البناء التحتي لأي مجتمع من
المجتمعات (5: 89)، لذا فإن التعرف على الأبعاد
الأساسية السائدة داخل الأسرة يعطينا مؤشرات
واضحة نحو أساليب اكتساب القيم والعادات
والمحافظة على المعتقد الديني وانتقاله من
الآباء إلى الأبناء، لينساب بشكل طبيعي
بعيداً عن القسرية، وأنماط الضغط في التربية
لاكتساب هذا المكون الأساسي، فالأسرة
المتمثلة في الأبوين هي المسؤولة عن بث روح
المسؤولية واحترام القيم، وتعويد الأبناء
على احترام الأنظمة الاجتماعية ومعايير
السلوك فضلاً عن المحافظة على حقوق الآخرين
واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات الخاطئة
لدى أبنائها مثل التعصب الذي يعده البعض
اتجاهاً نفسياً جامداً ومشحوناً وانفعالياً،
وكذلك ظواهر أخرى تعد محرمة دينياً، أو
التقرب منها يعد عدواناً على حقوق الغير، فمن
أجل ذلك ينبغي التعامل مع أسس القيم المرغوبة
على أنها سلوكيات صحيحة، والتعامل معها بثبات
لتترسّخ قواعد هذا النظام، وهذا يتطلب من
الكبار الذين يتعاملون مع الطفل أن يكونوا
القدوة والمثال في هذا الشأن (6: 53).
تعد الأسرة السليمة المؤسسة
المكملة لنسيج البناء التحتي لأي مجتمع من
المجتمعات (5: 89)، لذا فإن التعرف على الأبعاد
الأساسية السائدة داخل الأسرة يعطينا مؤشرات
واضحة نحو أساليب اكتساب القيم والعادات
والمحافظة على المعتقد الديني وانتقاله من
الآباء إلى الأبناء، لينساب بشكل طبيعي
بعيداً عن القسرية، وأنماط الضغط في التربية
لاكتساب هذا المكون الأساسي، فالأسرة
المتمثلة في الأبوين هي المسؤولة عن بث روح
المسؤولية واحترام القيم، وتعويد الأبناء
على احترام الأنظمة الاجتماعية ومعايير
السلوك فضلاً عن المحافظة على حقوق الآخرين
واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات الخاطئة
لدى أبنائها مثل التعصب الذي يعده البعض
اتجاهاً نفسياً جامداً ومشحوناً وانفعالياً،
وكذلك ظواهر أخرى تعد محرمة دينياً، أو
التقرب منها يعد عدواناً على حقوق الغير، فمن
أجل ذلك ينبغي التعامل مع أسس القيم المرغوبة
على أنها سلوكيات صحيحة، والتعامل معها بثبات
لتترسّخ قواعد هذا النظام، وهذا يتطلب من
الكبار الذين يتعاملون مع الطفل أن يكونوا
القدوة والمثال في هذا الشأن (6: 53).