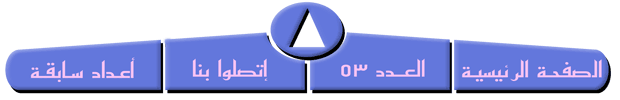|
|
|
| السيــد مصطفى الســادة | |
|
( أما علماء العرب المسلمون فساعدوا في تطوير أسلوب البحث العلمي، وأعلن (بيكون) هذا الأسلوب في أوروبا - بعد مضي خمسمائة سنة على وفاة العالم المسلم (جابر بن حيان) - الذي كان مديناً بعلمه ذلك إلى العرب في إسبانيا الذين اقتبسوا المعرفة من المسلمين ) هذا ما يعتقده العالم والمؤرخ ويل ديورانت مؤلف كتابي (قصة الحضارة) و(قصة الفلسفة). ويقول الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في كتابه (أمريكا والفرص التاريخية): (إن العديد من الأمريكيين لا يعرفون أن العالم الإسلامي له تراث غني، إنهم يتذكرون فقط أن المسلمين نشروا بسيوفهم الدين الإسلامي في آسيا وإفريقيا وحتى أوربا.. وينظرون بفوقية إلى الحروب الدينية في المنطقة.. ). ويعترف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أيضاً حيث يقول: (إذا كان الغرب يسيء فهم طبيعة الإسلام فما زال هناك جهل حول ما تدين به حضارتنا أو ثقافتنا للعالم الإسلامي إنه نقص نعانيه من دروس التاريخ الغربي الضيق الأفق الذي ورثناه.. ) (1). هذه النصوص الثلاثة وغيرها مما لم يذكر هنا تحمل في طياتها - على ما تحويه من مداليل فكرية وسياسية وقد تكون عقيدية أيضاً - النظرة الغربية المختلفة للمشروع الثقافي الإسلامي، وقد تبلورت هذه النظرة بشكل واضح مع بروز مفهوم ونظرية العولمة التي ينادي بها المشروع الثقافي الغربي ويحاول أن يصيّرها كأمر واقع مفروض على الدول النامية الضعيفة بحيث تصبح مفروضاً لا غنى عنه وليستطيع من خلالها الولوج إلى فكر هذه الدول والسيطرة عليه ومن ثم تغذيته بفكر العولمة الهادف إلى إبقاء السيطرة الغربية تمسك بزمام الأمور وسيفاً مسلّطاً على رقاب شعوب تلك الدول. |
|
|
هذا المفهوم كمفردة لها دلالاتها استأثر باهتمام فائق من قبل حشد كبير من المثقفين والمفكرين المتخصصين والمشتغلين بحقول علمية ومعرفية –على اختلاف مدارسهم الفكرية- خصوصاً العولمة الثقافية والفكرية التي أصبحت محوراً في الأطروحات والبحوث والدراسات العلمية والأكاديمية، وبدأت تشكل بصورة واضحة مع مطلع عقد التسعينات ولا تزال الكثير من الدراسات تكتب لغرض إشباع هذه المفردة بحثاً حول أهميتها أو خطورتها في بعض الأحيان على الصعيد الاقتصادي حيث المنشأ، أو الثقافي والفكري حيث الغرض والغاية، وبالتالي تترك أثرها على الصعيد الاجتماعي في آخر المطاف. وقد ترافق هذا الاهتمام المختلف - أدبيات وندوات ومؤتمرات حول العولمة - مع جملة من التحولات الكبيرة والمهمّة على الصعيد العالمي يمكن الإشارة إلى بعضها: (1) انهيار ما كان يعرف بالدب الروسي (الاتحاد السوفييتي سابقاً) وما لحقه من انهيارات كبيرة في دول الكتلة الشرقية، لعدم قدرة الفكر الشيوعي - وبعد مرور سبعين عاماً- على الصمود أو تغذية الدول المتحالفة والدائرة في فلكه أو تحت سيطرته. هذا فضلاً عن تكشف عورات الشيوعية في عدم قدرتها على فرض هيمنتها على الجمهوريات الإسلامية التي تعرضت لسنوات طوال من المحن والآلام وغسيل العقول الفكري المستمر الذي مورس بحق شعوب تلك الجمهوريات المسلمة. (2) بروز محور نظام القطب الواحد بعد أن كان العالم يعيش نظام تعدد الأقطاب والثنائية القطبية حيث كان العالم ينقسم إلى دول تعيش التبعية للشرق الشيوعي وأخرى تعيش التبعية للغرب الرأسمالي، وبات نظام القطب الواحد هو التوأم المفقود للعولمة والذي تحاول الأنظمة الغربية تسويقه إلى العالم. (3) قدوم عصر الثورات المختلفة في عالم التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات وأخيراً ثورة الهندسة الوراثية الهادفة إلى تنميط وعولمة العالم اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً ومؤسساتياً وثقافياً أيضاً عبر ابتلاع الوسائط الإعلامية المرئية والمعلوماتية(2). هذه الثورات والمعلوماتية منها خصوصاً عملت على جعل أحداث العالم حاضرة عند الإنسان في لحظتها وخلقت التقارب بين أجزاء العالم إلى حد عبّر عنه بعض الشعراء قائلاً:(إن العالم أصبح قريتنا الكبرى). ويردف البعض حيث يقول: (أصبح العالم قريتنا الصغرى)، لشدة التقارب ليس فقط بين أحداث وأشخاص واتصالات هذا العالم، إنما أيضاً وهو المهم لشدة التقارب بين الثقافات العالمية إلى الدرجة التي بات من الممكن القول أن كل ثقافة يمكن أن تؤثر أو تمازج الثقافة الأخرى وذلك عن طريق شبكة المعلوماتية. وهذا الأمر أدى إلى نشوء حالة من الصراع بين الثقافات المختلفة سلاحها وموقعها شبكات المعلوماتية، وكل طرف يدير دفة الصراع عن طريق إمكاناته وقدراته الإعلامية والثقافية، وسلاح الحسم هو القدرة على التأثير في قرار الآخر. وقد أدى هذا النوع من الصراع المستحدث إلى نشوء ثقافة جديدة هي ثقافة القوميات والجنسيات والأتنيات المختلفة، أكسبت العولمة نوعاً من التعدد الثقافي، وهنا نشأ ما يمكن أن يصطلح عليه اليوم بالغزو الثقافي. فالحرب إذن هي حرب ثقافية وجيوشها الإعلام والمعلومات، ولم يعد لنا كمسلمين خيار الانسحاب من هذه المعركة التي فرضها علينا الغرب بعد تخطيط دقيق دام طويلاً، وبعد دراسات ميدانية في اختبار أفضل السبل لغزو العالم الإسلامي من خلال هذا البعد الحضاري ولم يبق أمامنا إلا أحد خيارات ثلاثة: إغلاق الأبواب وممانعة الاختراق الثقافي، ولا يمكن لنا ذلك لأن الحرب وصلت إلى أقرب الدوائر إلينا ولم نعد نحن مستعدين لذلك، وهل يستطيع المسلم اليوم أن يلقي نفسه خارج الكرة الأرضية؟!. الذوبان في تيارات العولمة الثقافية والتخلي عن إسلاميتنا وقيمنا ومبادئنا الدينية وسلوكياتنا الاجتماعية.. وبالتالي الخضوع للسيطرة الغربية ولمزيد من التبعية الفكرية والثقافية بعد الخضوع الاقتصادي والسياسي. الدخول المدروس إلى عالم الفضائيات والإعلام والاتصالات والإنترنت وامتلاك زمام المبادرة في توجيه الصراع واختراق المشروع الغربي عن طريق الدعوة الحكيمة إلى المشروع الإسلامي، وهذا الأمر يحتاج أن يكون متثاقفاً مع لسان العصر كما يعبر القرآن الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ..)(3) حيث تقرر الآية حقيقة التبليغ المختلف من زمان إلى آخر ومن قوم إلى قوم وعقلية إلى أخرى، فالتبليغ للعوام بلسان العوام وللمثقفين والعرب والغرب كلٍّ بلسانه، بل إن التعمق في المفهوم من الآية يمكن أن يرشدنا إلى غير ذلك أيضاً فالمبلّغ في القرن الواحد والعشرين ينبغي أن ينطق بلسان أهله وعقلهم وفكرهم ووسائلهم أيضاً فلكل مدخل ووسيلة يمكن الدخول إليه من خلالها. وبهذا تتحقق الاستفادة من العولمة لخدمة المشروع الديني وتوظيف كل وسائلها وأساليبها في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. وبالعودة إلى التخطيط الغربي والتفكير الدائم والصبور لغزو العالم الإسلامي من هذه الناحية وانتظار هذه اللحظة الحاسمة يمكن أن نقرأ نصوصاً عديدة كان يفكر أصحابها ومن ورائهم جيوش من الخبراء النفسيين يخططون ويدرسون كل السبل لتحقيق أهدافهم ومن أهم تلك النصوص: - ما قاله غلادستون وزير المستعمرات البريطاني عام 1895م حين أمسك بالقرآن الكريم وقال: (لن يبقى لنا قرار في العالم الإسلامي ما دام هذا الكتاب موجوداً بين أيدي المسلمين). - وفي نص آخر يقول نيكسون في مذكراته: (إن بقاء قوات حلف الأطلسي هو من أجل مواجهة القوة المخيفة وهي الإسلام). هذه نصوص تحدث بها كبار الساسة والخبراء الغربيين لحث الدول الغربية جميعاً على توظيف جيوشها المختلفة في خدمة أغراضهم وأحقادهم ولإبقاء السيطرة والغلبة على الأمة ومقدراتها وخيراتها. |
|
|
وينبغي أن نعرف أن أساليب الغزو تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر أيضاً. وأعقد الأساليب وأخطرها هي تلك الموجهة ضد الثقافة الإسلامية. ومن هذه الأساليب: أولاً - الناحية المعرفية: حيث يتميّز الدين الإسلامي بالجانب المعرفي والرؤية الكونية للأشياء، وهذا يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المشروع الثقافي الإسلامي كما هو لسان القرآن والروايات أيضاً. كما في قوله تعالى: (.. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ)(4)، وقوله تعالى: (... يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) (5). وقد ورد عن الرسول الأكرم(ص): (إذا أتى عليّ يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم) (6). وذلك لأن الإسلام يعتبر العلم طريقاً لطاعة الله تعالى كما يقرر القرآن: (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(7)، وقوله تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)(8). وقد ورد عن الرسول(ص): (طلب العلم فريضة على كل مسلم.. به يطاع الرب ويعبد وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام.. ) (9). لهذا يرتكز الإسلام على عدّة دعائم أحدها المعرفة التي توقظ الإنسان من سباته فإن من علم وعرف عمل، وقد التفت الاستعمار إلى أهمية هذا الجانب فحاول إفساد التربية والتعليم في العالم الإسلامي وبث الثقافة المسمومة بالأفكار الغربية، وهذه المحاولات جميعاً كانت تحصل عن طريق مجموعة من الكتّاب أو المفكرين العلمانيين الذين جعلوا الدين مسوحاً لهم وتلبسوا بعباءته وهم يحاولون القضاء على الثقافة الدينية، وقد نجح المستعمر في خلق جيل من هؤلاء وزرعهم في المنتديات العلمية والفكرية التي تشرف على تعليم أبناء المسلمين مما أدى إلى بروز جيل يحمل الفكر المزدوج المخلوط من ثقافتين أو أكثر لا توجد خطوط تقاطع بينهما، وما يوقظ الشعور بالخوف ويزيد الأزمة تأزّماً قيام البعض من هؤلاء بالتأليف في الحقل المعرفي الإسلامي، ونشر هذه التأليفات على مختلف المواقع والتعامل معها كمصادر مؤرخة أو مبيّنة لفترة من فترات التاريخ الإسلامي، ومصممة لبعض الأفكار الإسلامية التي فهمها اتباع الدين الإسلامي بفهم ضبابي غير واضح، وهي وسيلة إذا ما دققنا النظر فيها تبلغ من الخطورة بمكان إلى حد ينبغي إيقاظ شعور القائمين على مصادر التوجيه في العالم الإسلامي إلى خطورة سريان مثل هذه الثقافات التي تحاول زعزعة إيمان المسلم بثقافته الأصلية أو ثوابته الدينية، مما سمح للواقع الإسلامي بظهور تيار التشكيك في الثوابت والأصول تماشياً مع العولمة الثقافية ولذلك هم يحاولون تذويب الدين في العولمة. ثانياً - تذويب القيم والثوابت عن طريق الإعلام الموجه: وجديداً عن طريق الفضائيات والشبكات العالمية وشبكة الاتصالات الهادفة إلى استعمار الوجدان والعواطف والسلوك لدى شعوب الدول الضعيفة - ومنها الإسلامية- فهم يهيمنون على موارد التلقي الإعلامية ومراكز الاتصالات والتدفق الإعلامي، وكل ذلك لغرض الهيمنة الغربية على العقل المسلم وسلخه عن دينه وقيمه وهويته الإسلامية الحضارية، وإبعاده عن تراثه الحقيقي وأصالته ليقع فريسة التبعية الفكرية وتحدياتها وتياراتها المادية البرّاقة وبالتالي تطويقها بثقافات الدول المتقدمة تقنياً (10). |
|
|
يقول العالم هايندكر: (إن التكنولوجيا مهما كانت فهي ليست مجرّدة عن الأغراض أو هي ليست مجرد غاية يريد صنّاعها إيصالها إلى الناس وخدمة أهدافهم، إنما هي وسيلة توضح المعيار لأجل تحديد الواقعي من غير الواقعي). ولعلّ الكثير من المفكرين والمثقفين في الشأن الإسلامي يتفقون معه في هذه النسبة أو الرؤية العميقة. وكما يعبّر أحد فلاسفة اليونان عن هذه الرؤية بتساؤل يحمل بين طياته الكثير من الدلالات: ماذا سيكون عليه حال العالم لو اخترعت اليابان أجهزة التكنولوجيا؟!، وقد سبق هذا الفيلسوف اليوناني العالم بعقود حين أشار إلى هذه الرؤية الفلسفية للفكر التكنولوجي. ومما ينبغي أن يعلم، هو حمل هذه الأجهزة المتطورة لرؤية كونية وفلسفية فهي تعكس فكر الجهة المنتجة سواءً كانت الجهة المنتجة لها غربية أو إسلامية - ولو بالفرض - فهي ليست مجرد وسيلة لا هدفية عندها، مضافاً إلى ذلك أنه عندما تنتقل هذه التقنية من بلد إلى آخر ومن شعب إلى شعب آخر فإنها تنقل معها الفلسفة المادية لأصحابها. وتزداد المشكلة عمقاً عندما ننظر إلى الثقافة المصدَّرة عن طريق هذا التقدم العلمي والتطور التكنولوجي؛ فإن عملية ترحيل المصطلح من لغة إلى أخرى أو ثقافة إلى غيرها فإن الذي يحدث عند الجهة المستوردة هي مشكلة عدم القدرة على تفريغ هذا المصطلح من سياقه الاجتماعي الذي ورد منه ونقله إلى سياق آخر لا علاقة له به، وحتى نخرج الكلام من سياقه التجريدي والمثالي فلابدّ من معرفة حقيقة مهمّة وهي إن السيادة في عالمنا المعاصر ليست للعقل والفكر إنما هي للصورة وما توحيه للمشاهد، وتعرف المشاهد المسلم الدائم للصورة الوافدة عن طريق الشاشات الفضائية وغيرها من المرئيات، والاعتماد عليها في إثبات الحقائق يؤدي إلى الإيمان بمفردة المادية وجعلها المحور الحقيقي والمرجع الأصيل والوحيد لإثبات الحقيقة. وهذا ما تذهب إليه الفلسفة السوفسطائية البروتاجوراسية المعتمدة على الحس كأساس وحيد لإثبات الحقائق، وهذه ثقافة لا يمكن إيجاد خط مشترك بينها وبين الثقافة الإسلامية التي لا تعتقد بمرجعية المادة وأصالتها في إثبات الحقائق. فالصورة - كما هو الهدف العولمي- والإدمان عليها يوصل إلى هذه النتيجة فالصورة هي وسيلة لمثاقفة الفكر ولكنها قد تكون أداة يسلب بها فكر الإنسان بدلاً من أن تتواصل معه، وتعمل على شل التفكير كما هو حال الشعوب المسلمة المستهلكة التي تهتم بهذه التكنولوجيا ولا تعرف خطورتها. ثالثا- المؤتمرات وأهدافها: يعقد العالم سنوياً من المؤتمرات والندوات والجلسات الفكرية ما قد يصعب على الراصد حصرها في مجلد واحد، وهذه الجيوش من المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعقدها الهيئات والدول والمنظمات الدولية التي (تهتم) بشؤون الإنسان وتنظيم حياته وجعلها أكثر رفاهية وأماناً كما يدّعي أصحابها، لو دقّق الإنسان في قراءات هذه الندوات لوجدها جميعاً تصبّ في خدمة الفكر الغربي ونشر القيم المادية، فلا يكاد يمر عام دون عقد الكثير من الندوات تحت مختلف المسميات ومن أبرز هذه المؤتمرات: * مؤتمر أزمة الإسكان في العالم الذي عقد في القاهرة عام 1994م واختيار هذا البلد المسلم له دلالاته الفكرية والقيمية والسياسية أيضاً، وقد كانت لهذا المؤتمر أهداف معلنة وأهداف أخرى غير معلنة وهي ما كان يريد المؤتمرون الغربيون تحقيقها ومن تلك الأهداف: - إباحة الجنس وكفالة حقّه للجميع ونشر ثقافتهم الجنسية. - إباحة الإجهاض ونشره في العالم الإسلامي بحجة إيقاف أزمة الإسكان في العالم وعدم القدرة على التربية. - القضاء على النظام الأسري والاجتماعي. - إباحة المثلية للجنسين خصوصاً بعد أن حصلت هذه الجمعيات على مباركة بعض رجال الكنيسة المسيحية في بريطانيا وفرنسا. * مؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م، وقد أطلق عليه اسم (مؤتمر المرأة) بهدف تحقيق تقدم ملموس على صعيد النقاط التي لم تلق قبولاً في مؤتمر القاهرة حين تعالت الأصوات المعارضة من قبل الدول الإسلامية وبعض رجال الدين المسيحي. * مؤتمر نيويورك الذي عقد عام 2000م تحت اسم مؤتمر المرأة أيضاً. هذه هي العولمة والتكنولوجيا التي يريد الغرب تقديمها للعالم الإسلامي عولمة الإجهاض والجنس والمثلية والقتل والاستهلاك، وعدم احترام القوانين الأسرية والاجتماعية، والتمرد على نظام الأبوّة والأمومة الشرعية. وأخيراً عولمة التطبيع مع العدو وهي أخطر العولمات الثقافية فهم يهدفون إلى عولمة كل شيء حتى الدين والثوابت. فهم يحاولون تنصير العالم - ولو بالفكر- كما هي أمنية المبشرين الذين يسخّرون التكنولوجيا والتطور العلمي في خدمة أهداف التبشير المسيحي. فقد عقد مؤتمر بالقاهرة عام 1906م تحت اسم مؤتمر (زيوجر المبشر المسيحي) الهادف إلى نشر الفكر المسيحي في الدول الإسلامية، وكذلك مؤتمر المبشرين الذي عقد عام 1977م تحت اسم (مؤتمر تنصير العالم)، وكذلك مؤتمر المبشرين الأمريكان البروتستانت الذي عقد في كولورادو عام 1987م تحت اسم (تنصير المسلمين في العالم) حيث قدمت (40) دراسة حول علاقة الإسلام بالمسيحية وكيف يمكن للمبشر المسيحي زعزعة الإسلام في نفوس المسلمين العرب وكيف يمكن إخراج المسلمين من غير العرب من الإسلام إلى النصرانية.. كل هذا يدل على أن التكنولوجيا ليست في موقف الخادم والوسيلة الشريفة وكذلك العولمة، إنما هي منظومة فكرية فلسفية قيمية لأنها صنعت لمجتمع معين وحين تنتقل إلى غيره من المجتمعات الضعيفة فلابدّ من الالتفات إلى الثقافة التي تنتقل معها، وهنا لابد من دق ناقوس الخطر الثقافي الذي ينتقل معها لأنه يريد تخدير شعوب العالم الإسلامي في أقل تأثيراته، ومسخ الهوية الإسلامية في تأثيراته البعيدة. وخطر العولمة الثقافية هذا يستدعي من المفكرين المسلمين بذل المجهود المعرفي في سبيل إيقاظ الشعوب الإسلامية والوصول إلى التغيير الثقافي المطلوب. |
|
|
في عام 1974م صدر عن الأمم المتحدة قرار مشهور جاء فيه: (إن النظامين السائدين –الرأسمالية والشيوعية- عاجزان عن تحقيق الأمن والعدل والسلام بين الناس ولابدّ من نظام عالمي جديد يحقق للناس آمالهم وينهي آلامهم ويحقق لهم الأمن والعدل والسلام). وقد صدر بعد هذا القرار عام 1975م قرار آخر من هيئة الأمم المتحدة طلب إلى اليونسكو المؤسسة الثقافية العالمية أن تضع تصوراً لنظام عالمي يحل محلّ هذين النظامين السائدين، وقد قدم أعضاء اليونسكو عام 1977م تقريراً مفصّلاً يقوم على أسس ثلاثة للنظام العالمي المتصور وهي: - وجوب الاعتراف بوحدة الأسرة البشرية وحقها في التعايش بأمن وسلام. - العمل على تطوير مشترك للتنمية بما يحقق انتعاشاً اقتصادياً للجميع. - إحقاق عدالة التوزيع في الأرض، وهذه الأمور الثلاثة تلتقي مع جوهر وحقيقة الدين الإسلامي الذي يمتاز بالنزعة العالمية لما يتمتع به من نقاط عديدة تجعله محوراً عالمياً يدور عليه الجميع، وذلك من خلال: أولاً: قوة الفكر وأسلوب الإقناع العقلي بالحجة والبرهان، وسلوكه طريق الحكمة والموعظة الحسنة وحب الإسلام للسلام والأمن والاطمئنان النفسي كما تشير إلى ذلك العديد من الآيات القرآنية، فقد ورد قوله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً..) (11)، وقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً..) (12)، وقوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) (13). هذه الآيات تؤكد على إن الإسلام مشروع للبشرية جميعاً على اختلاف ألوانها ومستوياتها وأطيافها، وأيضاً هو دعوة لهداية البشرية لأن هذه الرسالة هي رسالة السماء الخالدة والقادرة على هداية الجميع (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ..)(14)، فالإسلام لا يعرف العنصريات عنصرية اللون والدم والثقافة والطبقية أبداً (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ..) (15). بخلاف بعض الأديان والمذاهب العنصرية كاليهودية المعاصرة التي تعيش الانغلاق على ذاتها أو النازية البغيضة التي تقوم على أساس تفضيل العرق الآري على بقية الأعراق، أو النزعة الغربية التي تفضل العرق الأزرق. ثانياً: انسجام الدين الإسلامي مع الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى الناس جميعاً عليها، وهي إن الله تعالى خلق كل إنسان على الفطرة السليمة التي يقول عنها القرآن: (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (16). ولكن توجد عوامل اجتماعية وبيئية تعمل على حرف مسيرة هذا الإنسان كما ورد في حديث الرسول(ص): (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه.. ). ثالثاً: التوافق مع العقل السليم والعلم، فكل أحكام الإسلام وقوانينه وعباداته لا تتعارض مع العقل السليم والفكر الصحيح. رابعاً: قيام الإسلام على مبادئ الحرية والعدل والمساواة والشورى، كما تؤكد ذلك الآيات القرآنية ففي قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ..) (17)، وقوله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) (18)، وقوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ..) (19)، وغيرها من الآيات.. خامساً: تلاقيه مع أصول الأديان السابقة في دعوتها إلى توحيد الله تعالى والإيمان به وإقرار الحق والعدل وأصول الاعتقاد والإيمان والأخلاق الفاضلة التي تلاقت عليها جميع الرسالات السماوية (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ..) (20). سادساً: وسطية الإسلام بالجمع بين مطالب الدنيا والدين والروح والآخرة، وأيضاً بين الثوابت الجذرية أو الأساسية والمرونة في الاجتهاد والتطبيق والسماحة واليسر (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً..) (21)، وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ..)(22). كل هذه الأمور سهّلت انتشار الإسلام وإقبال الناس على اعتناقه في العالم ومما ساعد على ذلك أيضاً أن الثقافة المسيطرة على العقل والحياة المعاصرة هي ثقافة مادية في كل جوانبها تعنى بتقديم كل ما هو مادي وماجن في أكثر الأحيان ولا تعنى بتقديم خدمة للجانب الروحي في حياة الإنسان، فهي تتعامل مع الإنسان كما تتعامل مع التكنولوجيا ولا تهتم بجانبه القيمي وهذا ما تمتاز به الثقافة المادية التي تقابل الإسلام الذي يهتم بجانب الروح كما يهتم بجانب المادة ويلتزم الوسطية الداعية إلى الاعتناء بأمور الدنيا وجعلها طريقاً للآخرة. بقي أمر مهم وهو كيف يمكن أن ندعو لإسلام بهذه القوة والقدرة على استيعاب البشرية جميعاً تحت رايته؟ |
|
|
الهوامش: |
|
|
(1 ) مجلة النبأ: العدد29 ص45. (2 ) مجلة المستقبل العربي: العدد252 ص182 2/2000. (3 ) إبراهيم: 4. (4 ) الزمر: 9. (5 ) المجادلة: 11. (6 ) كنز العمال. (7 ) الحج: 54. (8 ) سبأ: 6. (9 ) أمالي الطوسي: 488/1069. (10 ) مواجهة الغزو الثقافي الصهيوني: د. وهبي الزحيلي. (11 ) الأعراف: 158. (12 ) سبأ: 28. (13 ) الفرقان: 1. (14 ) الإسراء: 9. (15 ) الحجرات: 13. (16 ) الروم: 30. (17 ) البقرة: 256. (18 ) آل عمران: 159. (19 ) النحل: 90. (20 ) الشورى: 13. (21 ) البقرة: 143. (22 ) البقرة: 185. |
|

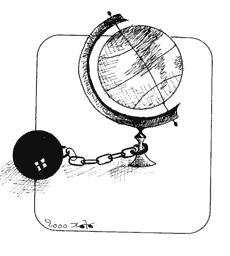 هذا
المحور تناولته العديد من الدراسات
والبحوث والندوات وإن كانت في الغالب
تتمحور حول عرض هذه المشكلة وكشف
الأساليب، وأيضاً يمكن إدراجها في إطار
الممانعة الثقافية غير الكافية في إيقاف
هذا الغزو المنظم والموجه، ومن هنا يتوجب
أن يعكف مفكرونا ومثقفونا على دراسة هذا
الأمر وإيجاد السبل القويمة والأفضل
لمواجهة هذه الهجمة الثقافية على القيم
والمبادئ الدينية. حتى لا تكون أمتنا
كالقصعة التي تتكالب عليها الثقافات
الدخيلة الأمر الذي يؤدي إلى فرض ثقافتهم
وقيمهم التي تهدف إلى إبقاء الشعوب
الضعيفة في الدول المستعمرة خاضعة
لثقافتهم وقيمهم المادية.
هذا
المحور تناولته العديد من الدراسات
والبحوث والندوات وإن كانت في الغالب
تتمحور حول عرض هذه المشكلة وكشف
الأساليب، وأيضاً يمكن إدراجها في إطار
الممانعة الثقافية غير الكافية في إيقاف
هذا الغزو المنظم والموجه، ومن هنا يتوجب
أن يعكف مفكرونا ومثقفونا على دراسة هذا
الأمر وإيجاد السبل القويمة والأفضل
لمواجهة هذه الهجمة الثقافية على القيم
والمبادئ الدينية. حتى لا تكون أمتنا
كالقصعة التي تتكالب عليها الثقافات
الدخيلة الأمر الذي يؤدي إلى فرض ثقافتهم
وقيمهم التي تهدف إلى إبقاء الشعوب
الضعيفة في الدول المستعمرة خاضعة
لثقافتهم وقيمهم المادية.